البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد
الشيخ حسين الخشن
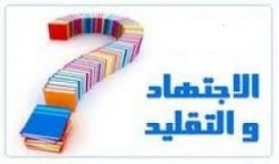
هل بالإمكان أن نبني رؤانا الاعتقادية على أساس التقليد وإتباع قول الغير كما هو الحال في المجال التشريعي؟ أم لا بدّ من ابتنائها وبنائها على أساس اجتهادي ولماذا؟ وهل الأمر ينسحب على كل المنظومة العقيدية أم هو خاص بالأصول الرئيسية التي يدور الإسلام مدارها؟
العقائد: مسؤولية شخصية
خلافاً لما عليه الحال في فروع الدين، حيث سمح الإسلام فيها للإنسان بالتقليد وإتباع قول الغير، فإنه قد حَظَرَ عليه أن يقلد في الأصول ومنعه من ذلك، الأمر الذي يعني أنّ البناء الاعتقادي هو مسؤولية شخصية ترتكز على الاجتهاد والتأمل والتحري الذاتي بعيداً عن سطوة العقل الجمعي أو نزعة محاكاة السلف، وبالتأمل يظهر أن إلزام الإنسان بالاجتهاد في الأصول يتماشى مع حوافز فطرية تلح عليه بطرحِ جملةٍ من الأسئلة المتعلقة بالمبدأ والمعاد، وإن تجاهل أسئلة المصير هذه أو التعامل معها بنحوٍ من اللامبالاة لا يمثل تجاوزاً لهذا الإحساس الفطري الباحث عن الاطمئنان والركون إلى عقيدة مُرْضية وحسب، وإنما يعكس تعامياً عن نداء العقل بضرورة دفع الضرر المحتمل في حال الإعراض عن البحث والنظر، وبما أن أسئلة المصير تفرض نفسها على كل إنسان، فيكون المطلوب من كل إنسان أن يُعدَّ جواباً عليها، وبذلك يكون الاجتهاد في الأصول هو المنسجم مع طبيعة البنية الاعتقادية ومنطلقاتها الفطرية، أما التقليد في هذا المجال فلا دليل على مشروعيته، بل حاول علماء المسلمين تأكيد عدم مشروعيته من خلال عدة وجوه:
الوجه الأول: إنه لا معنى للتقليد في أصول العقائد، لأن التقليد معناه الاستناد إلى فتوى الفقيه في مقام العمل، ومن الواضح أنه لا عمل في المسائل الاعتقادية حتى يستند فيها إلى قول الغير، وإنما المطلوب فيها عقد القلب والإذعان(راجع الاجتهاد والتقليد من تقريرات السيد الخوئي 411).
ولكن هذا الوجه هو أقرب إلى الإشكال اللفظي والاصطلاحي، ويمكن التغلب عليه بافتراض تفسير للتقليد في العقائد لا يختزن معنى العمل مباشرة، وإنما يتلاءم والاعتقاد، من قبيل تعريفه ـ أي الاجتهاد ـ بجعل المرء معتقده تبعاً لمعتقد الغير، ليصبح للتقليد معنيان، فالتقليد في الفروع له معنى يناسب كونها من أعمال الجوارح، والتقليد في الأصول له معنى يناسب كونها من أعمال القلوب والجوانح.
الثاني: إن القضايا الاعتقادية كما هو معلوم تتطلب حصول اليقين والإذعان وهذا ما لا يتيحه إتباع قول الغير وتقليده.(المصدر نفسه411، والفتاوى الواضحة8).
ولكن لنا أن نتساءل لماذا لا يتاح عقد القلب على أمرٍ ما من خلال التقليد؟ لا يبدو أن ثمة سبباً معقولاً لذلك إلا القول: بأن التقليد لا ينتج سوى الظن، بينما الاعتقاد يتطلب اليقين، إلاّ أن ما يلاحظ على ذلك أنه ليس مطّرداً، فإن الكثير من الناس الذين يتبعون الآباء أو يقلدون العلماء في معتقداتهم يحصل لهم اليقين ويعقدون القلب على ما يُلقى إليهم ولو لم يدركوا معناه أو يفهموا أبعاده.
الثالث: إنّ القرآن الكريم سجّل إدانة واضحة في العديد من آياته على ظاهرة أو حالة تقليد الآباء والأجداد أو الكبراء، ومن المؤكد أن القدر المتيقن لهذه الإدانة هو التقليد في الأصول قال سبحانه:{ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون * وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون* قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون}(الزخرف: 22-24).
وهذا الدليل أو الوجه صحيح، وهو ـ منضماً إلى ما تقدم من حكم العقل ونداء الفطرة القاضيان بلزوم البحث والتحري ـ كافٍ في إثبات المطلوب أعني عدم مشروعية التقليد في أصول الدين وضرورة أن يبني كل فرد ـ اعتماداً على اجتهاده الشخصي ـ عقيدته وإيمانه بربه ومعاده ودينه وإمامه..
الاجتهاد بين الفروع والأصول:
في ضوء ذلك يتضح أن الاجتهاد في الأصول هو مسؤولية عامة، بينما الاجتهاد في الفروع مسؤولية خاصة يتولاها فريق من أهل الاختصاص، لتعذر قيام العامة بذلك بحسب العادة، كما أن الأمر كذلك في التفاصيل الاعتقادية حيث يتعذر على عامة الناس الاجتهاد فيها، مما يفرض إعداد جماعة للقيام بهذه المهمة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}(التوبة:122)، وفي مطلق الأحوال فإن فتح باب الاجتهاد في الأصول وتحريم التقليد فيها كان من المفترض أن يخلق حراكاً في المجال الاعتقادي، وأن يفتح أمام علم الكلام الكثير من الأبواب الموصدة ويجعله علماً مؤثراً وفاعلاً وحيوياً، لكن المفارقة العجيبة أن منطق التقليد هو الذي ساد في أوساط المسلمين وسيطر على العقول، ما أسهم في خلق حالة من الركود والشلل الفكري.
الاجتهاد الشخصي وإرباك الحياة الاجتماعية:
إن إلزام عامة الناس بالاجتهاد في الأصول لا يوقعنا في محذور الاخلال بالنظام العام وإرباك الحياة الاجتماعية، وذلك لأن دائرة الأصول التي يجب فيها الاجتهاد محدودة ومحصورة بخصوص العقائد الأساسية، وأداة التعرف على هذه العقائد هي أداة سهلة وميسورة أعني بذلك العقل الذي يشترك فيه عامة الناس، يقول الشهيد الصدر: "ومن الواضح أن العقائد الأساسية في الدين لمّا كانت محدودة عدداً من ناحية، ومنسجمة مع فطرة الناس عموماً من ناحية أخرى، على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورة فيها غالباً وذات أهمية قصوى في حياة الناس من ناحية ثالثة، كان تكليف الشريعة لكل إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً ولا يواجه غالباً صعوبة كبيرة ولا يؤثر على المجرى العملي لحياة الإنسان"(الفتاوى الواضحة8).
وأما خارج نطاق الدائرة المذكورة ـ دائرة العقائد الأساسية ـ فإن المعرفة فيها ليست واجبة ـ من أساسها ـ على عامة المكلفين كما ذكرنا سابقاً، أجل لو قيل بوجوبها وأنّها لا تختص بالأصول كما ذهب إليه بعض العلماء لواجَهَنا ليس محذور الإخلال بالنظام العام فقط، بل محذور التكليف بغير المقدور أيضاً، بسبب عجز غالب الناس عن خوض غمار البحوث العقيدية التفصيلية، لكثرتها عدداً وعمق معانيها وتشعب الاتجاهات والآراء فيها، وإنه لمن غير المنطقي والحال هذه أن يناط الإسلام بأمثال هذه المسائل الاعتقادية، وإلا لزم الحكم بكفر معظم المسلمين، وهو ما نجزم ببطلانه ومنافاته لقواعد الشريعة السمحاء ونصوصها المستفيضة التي تكتفي في الحكم بإسلام الشخص بمجرد الإقرار بالشهادتين حتى لو لم يقترن ذلك بمعرفة المسائل الاعتقادية التفصيلية، بل حتى لو كان لديه تصورات اعتقادية مغلوطة وخاطئة.وللبحث صلة.