الشباب والغريزة الجنسية
الشيخ حسين الخشن
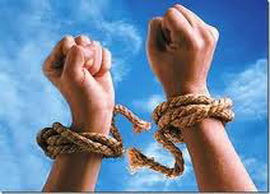
وبالنظر إلى الشباب فإنّ قضيّة الغريزة الجنسيّة تكتسب أهميّة بارزة، لأنّها ذات تأثير كبير على استقرار حياة الشاب وانتظامها، ومن هنا كان من الضروريّ إيلاؤها عناية خاصّة بالبحث.
1- صمود الشباب في معركة الغريزة
وقد لا أكون مبالِغاً ولا مجانباً للصواب إذا قلت: إنّ من أحبّ خلق الله إلى الله تعالى شاباً في مقتبل العمر، أقبل على الله تعالى بقلب سليم وهمّة عالية، وبالرغم من كونها محاطاً بالمغريات من كلّ جانب والتي تثير غرائزه وتشدّه نحو الرذيلة، ناهيك عن الوساوس والمثيرات التي تُزيّن له الحرام، فإنّه
يصمد في معركة جهاد النفس الأمّارة بالسوء، ولا ينهزم، ويظلّ حبّ الله تعالى أقوى من كلّ شيء لديه، ولا يُؤْثِرُ هواه أو هوى غيره على رضا الله تعالى، ولا يبيع آخرته بدنياه ولا بدنيا غيره.
وإنّي أعتقد أنّ صمود الشاب في معركة الغريزة ليس أمراً صعباً ولا عسيراً، خلافاً لما قد يتخيّله البعض من أنّ رضوخ الشاب لنداء الغريزة أكثر من رضوخه لصوت العقل والدين، فهذا الكلام ليس دقيقاً على إطلاقه؛ لأنّ ضغط الغريزة وجموحها عند الشاب - ولا سيّما في هذا الزمن المليء بالمثيرات
– وإن كان أمراً صحيحاً ولا ينكر، بيد أنّ صحوة الضمير والوجدان الدينيّ وسلامة الفطرة لديه كفيلة في إيجاد حالة من التوازن في شخصيّته، بما يساعد على ضبط الغريزة ويَحُول دون انفلاتها من عقالها.
وهنا يأتي دور الخطاب الديني والتربوي في أن يعمل ويتحرّك بتوازن دقيق، بما يساهم في إبقاء الشباب في حالة صحوة وجدانية ويقظة روحيّة، بعيداً عن أساليب الرهبنة المبتدَعة أو التصوّف المزيّف، ممّا تقدّم الحديث عنه في المحور الثالث.
إنّ من المفترض بالخطاب الدينيّ أن يبتعد عن أسلوب جلد الشاب وتخوينه، أو جعله في قفص الاتهام، أو إشعاره بأنّ غريزته الجنسيّة هي دنس أو عيب، وأنّ عليه أن لا يتحدّث بشأنها ولا يفكّر في أمرها، فضلاً عن الإيحاء له بأنّها مشكلة، وعليه أن يتخلّص منها ويقمعها أو يكبتها، فهذا - فضلاً عن
أنّه غير صحيح من الناحية الدينية - غير صحيح من الناحية التربوية أيضاً، وقد يخلق لدى الشاب ردّة فعل سلبية ربما تدفعه للتفلّت من الدين وتعاليمه، أو تُوقعه في حالة من الكبت الجنسيّ، وقد يخلق لديه بعض العقد النفسيّة.
وما أحرانا نحن المتكلمين باسم الدين أن نتعلّم من رسول الله (ص) كيفية مخاطبة الشباب، حيث نراه في بعض كلماته المروية عنه يرشد الشباب بكلّ لطف إلى أهمية السيطرة على الغريزة، مبيناً لهم - بكلام يفيض حبّاً وحناناً - محبّة الله تعالى لهم، يقول (ص): "إنّ الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي! ترك شهوته من أجلي"[1].
2- الحلول الواقعيّة لمشكلة غليان الغريزة
ولكن ثمّة معضلة حقيقيّة تواجه معظم الشباب اليوم، وهي عجزهم عن الإقدام على الزواج وتكوين الأسرة في فترة النضوج الجنسيّ، ولا يقتصر الأمر على مضيّ أربع أو خمس سنوات مثلاً على سنّ البلوغ، بل يصل التأخير في معظم الأحيان إلى عقد (عشر سنين) أو عقدَين، مع أنّ الغريزة تكون في
أوان التهابها وفورانها، والسؤال: ما هو الحلّ الأمثل لمعالجة هذه المشكلة؟
من المنطقيّ أنّ الحلّ ليس في أن يكبت الشاب - رجلاً كان أو امرأة - غريزته باستعمال وسائل تعطيل طاقته الجنسيّة أو تجميدها، لأنّ هذا فضلاً عن أنّه قد لا يكون سبيلاً مشروعاً، فإنّه ليس حلاًّ عمليّاً ولا مُجدياً في معالجة المشكلة، بل إنّ الكبت الجنسيّ يعدّ موئلاً خصباً للعديد من الأمراض الجسدية والنفسية.
ومن الطبيعيّ أيضاً أنّ إطلاق العنان للغريزة والسعي إلى إروائها وإشباعها بشتّى الطرق والوسائل ولو كانت محرّمة، ليس حلاًّ مقبولاً ولا هو صحيّ، بل إنّ هذا الطريق قد يفاقم المشكلة ويزيدها تعقيداً.
والإسلام بحكم واقعيته ووسطيته، لا يمكنه أن يتقدّم باقتراحات حلول غير واقعية ولا عمليّة لمعالجة المشاكل النفسية أو الجسدية أو الاجتماعيّة، ومنها مشكلة غليان الغريزة، ولهذا السبب فإنّي لا أعتقد أنّه - أي الإسلام - يكتفي في هذا المجال بدعوة الشباب إلى إطفاء نار الغريزة باللّجوء إلى الصوم،
استناداً إلى ما جاء في الحديث النبويّ الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء"[2]؛ لأنّ الصوم لا يُعدّ علاجاً كافياً للمشكلة، والحديث الشريف إنّما يرمي إلى توجيه الأفراد نحو الصوم باعتباره وسيلة ظرفيّة، وعاملاً مساعداً
ومؤقّتاً على التخفيف من غلواء الغريزة وضغطها على الأعصاب، لكنّه لا يقدم ذلك باعتباره حلّاً دائمياً أو علاجاً جذرياً للمشكلة؛ ولهذا لا بدّ من اقتراح حلول عمليّة وشرعيّة في الوقت عينه.
وأعتقد أنّ الحلول الأقرب إلى الواقع والأكثر انسجاماً مع التشريع الإسلاميّ ومقاصده متوفّرة وليست بحاجة إلا إلى السعي في تطبيقها، ويمكن تصنيف هذه الحلول إلى نوعين:
النوع الأول: الحلول الجذريّة
والحلول الجذرية لا تبدأ إلا بعد القيام بدراسة علميّة وميدانية للمشكلة (مشكلة تأخّر سنّ الزواج) للتعرّف على أسبابها وظروفها، ليصار بعد ذلك إلى معالجتها من خلال توزيع المسؤوليات وتحديدها، فنتعرّف على دور الفرد في المشكلة وفي العلاج، وعلى دور المجتمع ومؤسساته المدنية على هذا
الصعيد، ونحدّد ما هي مسؤوليات الدولة وأجهزتها في هذا المجال؟
وبعد القيام بهذه الدراسة، يكون من الضروريّ - في الحالة الصحيّة - أن يُصار وعلى ضوء تلك الدراسة إلى وضع خطة شاملة تعمل:
أولاً: على رفع الموانع والعوائق أمام عمليّة الزواج ومرونتها وسهولتها. ومن أهمّ هذه الموانع هو نمط حياتنا الجديد في طريقة الصرف والاستهلاك، وهو نمط غزانا من الخارج. فقد فرض علينا نمط الحياة الغربية الذي اتبعناه وقلّدناه، الانخراط في حياة مرفّهة، وفرض علينا - أيضاً - حاجات غير
واقعية، هي في الغالب مجرّد كماليات لا ضرورة لها.
هذا ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تُدفع لقاء بعض مراسم الزواج، إن فيما يتّصل بمصروف العرس أو فيما يتّصل بغلاء المهور أو موائد الطعام المبالغ فيها، أو حفلات "الغناء" أو "الموالد الشرعية" والتي تحتاج إلى بذل مصاريف كبيرة ينوء الكثير من الشباب بتحمّل أعبائها.
ومن العوائق التي يمكن ذكرها في المقام: محاولة الكثير من الشباب الهرب من الدخول المبكر إلى القفص الزوجيّ لما يرتّبه ذلك عليهم من مسؤوليات، وأمّا غريزتهم فيسعون إلى إروائها من خلال العقد المنقطع أو من طريق آخر، وهذا كلّه من تأثيرات الثقافة المادية المشار إليها والتي تجعل الإنسان
أسير الشهوة واللّذة العابرة، إنّنا نقول لهؤلاء الشباب: إنّ دخولكم إلى القفص الزوجيّ لا يشكّل دخولاً إلى السجن، بل هو دخول إلى السكن الآمن الذي أنتم - كغيركم من بني الإنسان - أحوج ما تكونون إليه، قوله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: ٢١]. واستمعوا - أيّها الشباب - وتدبّروا ملياً في قول النبيّ الأكرم (ص) وهو يخاطبكم بكل محبّة ولطف قائلاً: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (الزواج) فليتزوج"، وهو (ص) لا يتكلّم جزافاً، بل إنّه كلام صادر عن معدن العلم ومصدر الوحي.
ثانياً: تأمين فرص العمل للشباب، وهذا من أفضل السبل لتحصين الشاب وبناء الأسرة، فبدل أن نتصدّق على الشاب ليشتريَ بيتاً ويعدّه للزواج، فإنّ الأجدى والأنفع هو أن نؤمِّن له فرصة عمل كريم، ومن خلالها سوف يتسنّى له تأمين حاجاته ومتطلباته.
ثالثاً: ترشيد عمليات التبرّع والإنفاق وتوجيهها إلى هذا الحقل، فإنّ المساعدة على تزويج العزاب وإعفافهم هي من أفضل وجوه الخير وأعمال البرّ، ولا يقتصر البذل على بناء المساجد والحسينيات الفخمة والتي قد لا تكون مورد حاجة ملحّة، إنّنا على يقين أنّ المال الذي يُصرف لبناء أسرة عفيفة هو
أفضل عند الله تعالى من صرفه لبناء مسجد لا حاجة ماسة إليه.
رابعاً: تعميم ثقافة العفّة ونشر قيمة الحياء وغيرها من القيم الأخلاقية، فإنّ ذلك كفيل بمساعدة الإنسان على ضبط غرائزه وكبح جماحها، يقول الإمام عليّ (ع): "من كَرُمَتْ عليه نفسُه هانت عليه شهوتُه"[3]، ويقول (ع) – بحسب ما روي عنه -: "ما زنى غيور قط"[4]، فما أروع هذه
الكلمات التي تستنفر في الإنسان القيم الفطرية وتحثّه من خلال ذلك على ترك الرذائل، لمنافاتها للخُلق الأبيّ والطبع السويّ.
بيد أنّ هذه الثقافة لن تؤديَ غرضها إلا مع العمل - بالموازاة - على سدّ أبواب الفتنة والإثارة الغرائزية الفاضحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فإنّ وسائل الفساد والإفساد التي تعمل على إثارة غرائز الشباب كثيرة، فيكون من واجب كلّ عاقل وحريص على نظافة المجتمع من الناحية الأخلاقية أن يعمل على
سدّ وإقفال هذه النوافذ المدمرة للفرد والمجتمع، والمخرِّبة للأسرة، والمسيئة لإنسانية الإنسان.
النوع الثاني: الحلول المؤقّتة
وقد يصاب بعض الشباب بالاكتئاب واليأس إذا حدّثته عن ضرورة وضع خطّة شاملة لمعالجة المشكلة، لأنّه يريد حلاً مستعجلاً لمشكلته الشخصيّة، حيث تضغط عليه الغريزة، ولا يمكنه الانتظار إلى الانتهاء من وضع الخطط موضع التنفيذ، هذا إن وُجدَ من يهتمّ بهذا الأمر ويسعى إلى تنفيذه، ولهذا
يكون من الضروريّ التفكير في وضع حلول جزئيّة ومستعجلة تساعد على حلّ المشكلة، وما يمكننا اقتراحه على هذا الصعيد:
أولاً: توفير قروض ميسّرة لتغطية نفقات الزواج، ويمكن أن تكون هذه القروض من المال العام.
ثانياً: إعطاء إجازات شرعيّة تسمح بالإنفاق في هذا السبيل من الأموال والوجوه الشرعية، ولعلّ أحد أبرز موارد الصرف المُثلى للحق الشرعي (الخمس والزكاة)، هو الصّرف على إعفاف الشباب المسلم.
ثالثاً: وقد يشكّل أخذ الشباب في هذه المرحلة بأسباب العقد المؤقّت، عاملاً مساعداً في التخفيف من غلواء الغريزة. وإننا نعتقد أن المشرّع الإسلاميّ الحكيم عندما أباح الزواج المؤقّت فإنّه قصد تحقيق جملة من الأهداف والنتائج الطيبة، ومن أهمّها توفير سبيل وطريق محلّل لإرواء الغريزة، وذلك كحلّ
مؤقّت إلى أن تتوفّر للشخص سبل الزواج الدائم، وربّما كان الزواج المؤقّت هو مرحلة تمهيدية للزواج الدائم.
نُشر على الموقع في 29-4-2017
من كتاب "مع الشباب في همومهم وتطلعاتهم". رابط الكتاب على الموقع الإلكتروني: http://www.al-khechin.com/article/440
[1] انظر: كنز العمال ج16 ص776.
[2] صحيح البخاري ج 6 ص 117، ونحوه ما جاء في الكافي ج 4 ص 180.