الشك في العقائد : أنحاؤه ومعالجاته(1/2)
الشيخ حسين الخشن
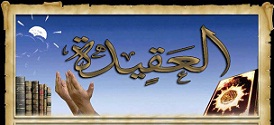
عالج أصول الفقه حالات الشك في التكليف الشرعي وحدد الموقف الذي يتعيّن اتخاذه من كل واحد منها، لكن ماذا عن الشك في التكليف العقدي؟ هل هو محكوم لنفس الأصول الجارية في التكليف الشرعي أم أن ثمة أصولاً أخرى تجري في الحقل الاعتقادي وتعالج موارد الشك فيه؟
ذكر علماء الأصول أن الأصول العامة التي تعالج حالة الشك في الحكم الشرعي هي بحسب الاستقراء أربعة: البراءة، الاحتياط، التخيير، الاستصحاب، وهناك عدة اتجاهات في منهجية البحث وتحديد مجاري الأصول المذكورة، ولا يعنينا الخوض في ذلك، ولا نريد مقاربة البحث في أصول الاستنباط العقائدي وفق المنهجية الأصولية، لأن طبيعة البحث في المقام تتخذ مساراً مختلفاً، ولهذا فإننا نعرض لأهم الأصول المنتجة في المجال الاعتقادي مع صرف النظر عن المنهجية الأصولية، وإن كنا قد نعقد مقارنة عابرة بين أصول الفقه وأصول العقيدة على سبيل التوضيح والتقريب.
وفيما نرى فإن الشكوك التي لا بدّ أن يعالجها الباحث في أصول الاستنباط العقدي هي التالية:
1 ـ الشك في الحجية وعدمها. 2 ـ الشك في وجوب الاعتقاد وعدمه، 3 ـ الشك في صحة العقيدة أو فسادها.
أصالة عدم الحجية:
أمّا النحو الأول من أنحاء الشك المذكورة وهو الشك في الحجية، فيراد به: أنه ثمة أدلة قد ثبتت حجيتها في مجال الاستنباط العقدي من قبيل: العقل القطعي أو النص القطعي السند والدلالة.. وهذه لا كلام لنا فيها، ولا كلام لنا أيضاً فيما ثبت عدم حجيته من "الأدلة" كالاقيسة الظنية أو أخبار الآحاد... إلا أنّ ثمة صنفاً ثالثاً من الأدلة لم تثبت لنا حجيته ولا عدمها، وإنما يشك في الحجية، فما هو الأصل في ذلك؟ على سبيل المثال: لو فرض حصول الشك في حجية الإجماع في العقائد، فما هو الموقف إزاء القضايا التي ادعي فيها الإجماع؟
والجواب: إن الأصل ـ في هذه الصورة ـ هو عدم الحجية، والمراد بهذا الأصل: أنه ما دام لم يقم دليل على حجية الإجماع ـ مثلاً ـ فلا يمكن الاستناد إليه واعتباره مرجعاً إثباتياً، وكيف لنا أن نستند إلى دليل مشكوك الحجية؟! وهذه النتيجة لا تختلف بشيء عما يذكره علماء الأصول بشأن الدليل الفقهي المشكوك الحجية، فقد أفادوا أن الأصل فيما يشك في حجيته هو عدم الحجية.
أصالتا الاحتياط والبراءة:
والنحو الثاني من أنحاء الشك في العقائد: هو الشك في وجوب الاعتقاد وعدمه، كما لو شك المكلف في أنه هل يجب عليه الاعتقاد بالصراط أو بالميزان أو بحساب القبر أو بغيرها من القضايا والمفاهيم العقائدية أو لا يجب الاعتقاد بذلك؟
ومرد الشك في وجوب الاعتقاد إما إلى عدم تمامية الدليل ـ سنداً أو دلالة ـ على هذه المفاهيم، وإمّا لأنه لا يُعلم كون القضية العقائدية حتى لو تم دليلها من سِنخ(أو صنف) المفاهيم الدينية التي يجب الاعتقاد بهما أو يتقوم به الإيمان.
وخلاصة القول: تارة يقوم الدليل على وجوب الاعتقاد بأمر ما، وأخرى يقوم الدليل على عدم وجوب الاعتقاد به، والأمر في هاتين الصورتين واضح، وإنما الكلام فيما لو وقع الشك في وجوب الاعتقاد وعدمه، فما هو الموقف أو الأصل في هذه الحالة؟ وهذا نظير الشك في الوجوب وعدمه، أو الحرمة وعدمها في المجال الفقهي، كما لو شك المكلف في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو شك في حرمة حلق اللحية... والمعروف لدى علماء الأصول أن أصالة البراءة تجري ـ بعد الفحص وعدم العثور على الدليل ـ في الشبهات الشرعية ـ حكمية كانت أو موضوعية ـ وهي تقضي بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وعدم حرمة حلق اللحية وهكذا.. وأمّا في المقام فيمكن القول ـ ولنستخدم المصطلحات الأصولية ـ :
إنه لا مجال للبراءة العقلية قبل الفحص والنظر، يقول السيد الكلبيكاني رحمه الله: "لا تجري أصالة البراءة أو الاستصحاب في الأمور الاعتقادية.(نتائج الأفكار في نجاسة الكفار:238)، وعليه تكون أصالة الاحتياط أو الاشتغال هي المحكمة في المقام، لا بمعنى وجوب الاعتقاد بما شك في وجوبه، بل بمعنى وجوب الفحص والتفتيش، لأن الاحتمال منجز في القضايا المهمة، فلو شك الإنسان في وجود الله أو وحدانيته أو عدله، أو شك في نبوة هذا النبي أو ذاك، أو في يوم القيامة وإمكانيته، فإن عليه في هذه الحالات ـ بمقتضى حكم العقل القاضي بلزوم دفع الضرر المحتمل ـ أن لا يستسلم لشكه وإنما يلزمه بذل الجهد في النظر والتأمل ليصل إلى تكوين قناعة مرضية، فإن تيسَّر له ذلك ووصل إلى نتيجة قطعية بنى عليها اعتقاده، وإلاّ فإن كان ثمة قدر إجمالي معلوم عقد القلب عليه على إجماله، وإلاّ إذا لم يصل بالفحص والتفتيش إلى نتيجة ولم يكن ثمة قدر معلوم بالإجمال فلا يلزمه عقد القلب على شيء، بل لا يمكنه عقده على شيء، إذ كيف يتسنى له عقد القلب على أمر مشكوك؟! ويمكن أن نقول: إنّ الموقف ينتهي في هذه الحالة إلى البراءة إن لم يكن بمعنى رفع التكليف الاعتقادي رفعاً ظاهرياً، فلا أقل بمعنى رفع أو نفي المؤاخذة والعقوبة، استناداً إلى قاعدة "قبح العقاب بلا بيان" وهي قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص، فكما تجري ـ القاعدة ـ لتأمين المكلف عن التكليف العملي (الشرعي) المشكوك، فإنها تجري لتأمينه عن التكليف العلمي(العقدي) المشكوك، وهكذا يمكن التمسك بأدلة البراءة الشرعية للغاية نفسها، أعني نفي المؤاخذة على ما لم يقمْ عليه دليل قاطع، فإن لمعظم تلك الأدلة إطلاقاً يشمل المقام، كما يشمل التكاليف الشرعية المشكوكة، من قبيل قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}(الإسراء:15)، وما ورد عن الإمام الصادق(ع): "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه"(وسائل الشيعة:27/163)، وكذلك ما روي عن رسول الله (ص): "الناس في سعة ما لم يعلموا" (مستدرك الوسائل:18/20)، إن هذه النصوص وسواها تؤكد وترشد إلى ما يحكم به العقل من قبح مؤاخذه الإنسان على عدم التزامه ـ قلباً أو عملاً ـ بما لم يقمْ عليه البيان والبرهان.
ويتفرع على ذلك: أن المجتهد في العقائد يعتبر معذوراً عند الله حتى لو توصل إلى نتيجة مغايرة للسائد ومخالفة للواقع، شريطة أن يخلص النية في البحث والتحري، وهذه النتيجة هي مثار اعتراض بل ورفض من قبل المشهور من علماء الكلام والفقهاء، وقد سجلنا اعتراضاتهم وملاحظاتهم، وأجبنا عليها في مناسبة سابقة(راجع الإسلام والعنف ص53 وما بعدها).
أصالة الصحة في العقيدة:
والنحو الثالث من الشك هو الشك في صحة العقيدة، ولهذا النحو من الشك صورتان رئيسيتان: الأولى: الشك الدائر بين الإسلام والكفر، والثانية: الشك الدائر بين مراتب الإسلام، فإن بعض المراتب قد تبتعد عن الخط السوي والمستقيم، وتلتقي مع الضلال أو الابتداع والانحراف.
فهل هناك أصل يعالج حالات الشك هذه سلباً أو إيجاباً، ويقضي بصحة العقيدة أو فسادها، أو يحدد الإسلام أو الكفر، أو الإيمان أو الانحراف؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نحاول الإجابة عليها بالتفصيل في المقال اللاحق بعون الله تعالى وتسديده.