دور العقائد في حياة الإنسان
الشيخ حسين الخشن
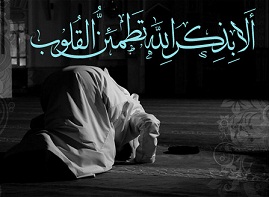
يثير بعض الباحثين إشكالية في وجه علم الكلام الإسلامي ومفادها: أنّ مبحث الإنسان قد ضاع في أنساق الفكر الكلامي، لأن هذا الفكر تمحور حول مبحث "الله"، أي أن الاهتمام انصب على المكلِّف دون المكلَّف..
علم الكلام وقضايا الإنسان:
لكن هذه الإشكالية ـ باعتقادنا ـ ليست تامة كما أنها تفتقر إلى الدقة، أما عدم تماميتها فبلحاظ أنه مع افتراض أن موضوع علم الكلام هو أفعال الله، بخلاف علم الفقه فإن موضوعه أفعال الإنسان، فلا معنى لهذه الإشكالية من أساسها، إلا إذا أريد بها أن تشكِّل مدخلاً للاعتراض على تحديد موضوع علم الكلام نفسه، لكن هذا يحتاج إلى اقتراح موضوع بديل وتعريف جديد لوظيفة علم الكلام حتى ينظر فيه ويُدرس بهدوء وموضوعية، وأمّا افتقار الإشكالية المذكورة إلى الدقة فباعتبار أن أدنى رصد أو مسح للمباحث الكلامية تُظهر بما لا لبس فيه اشتمال العلم المذكور على مباحث ذات علاقة وطيدة بهموم الإنسان ودوره ومشاكله وآلامه... من قبيل مبحث: الإمامة والرئاسة أو مبحث التكليف والمكلّف أو مبحث الأسعار والأرزاق والآلام والأعواض ونحوها، أوَلَيس علم الكلام هو الذي أثار الحديث في قضية حرية الإنسان واختياره وإن اختلفت المدارس الكلامية في أبعاد هذه الحرية وحدودها بين القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار. صحيح أنه قد تم تناول هذه المباحث ـ كلامياً ـ من زاوية علاقتها بالله وفعله، لكنها تطلّ على هموم الإنسان ومشاغله، واللافت أن هذه المباحث التي كان من الممكن أن تشكل مدخلاً هاماً لمبحث الإنسان في علم الكلام ويمكن التأسيس عليها، قد غابت وغادرت هذا العلم في نتاجات المتأخرين ودراساتهم، وهذا أمر يثير الاستغراب.
الغيبية والتجريدية:
وما يثير الاستغراب أيضاً وبشكل مضاعف هو افتقاد هذا العلم إلى حيويته وتأثيره المباشر على حياة المسلمين، بحيث أنه يلاحظ خفوت كبير في تفاعل المسلمين مع المسائل الكلامية، والسر في ذلك يعود إلى اتسام المباحث المذكورة بقدر لا بأس به من الجفاف والتعقيد بفعل الذهنية الفلسفية التي دخلت العلم المذكور وأثقلته بالاصطلاحات وحولته إلى هموم ومشاغل فكرية فلسفية بعيدة كل البعد عن هموم الإنسان ومشاكله المعاصرة وأسئلته الملحة، إن المطلوب من علم العقائد أن يبقى على تماس مباشر وفاعل في حياة الإنسان ليُدخِلَ الإيمان قلبه ووجدانه كما أضاء بالبرهان عقله وفكره، وهذه المهمة لم يفلح علم الكلام التقليدي بتحقيقها بشكل مُرضي.
وثمة سبب آخر ساهم في ابتعاد علم الكلام عن حياة الفرد المسلم وهمومه وهو أن هذا العلم بوضعيته التاريخية نحى باتجاه إنتاج غيبية مفرطة تحلق بالإنسان في آفاق التجريد بعيداً عن عالم الشهود والواقع، صحيح أن الغيب هو الركن الأساسي في العقيدة الإسلامية بل في كل العقائد ذات الطابع السماوي وهو ـ أعني الغيب ـ يمثل الفارق الجوهري بين الاعتقاد الديني وغيره من المعتقدات والمناهج الفكرية،ولذا كانت أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}(البقرة:2 ـ3)، بيد أن غيبية الإسلام التي طرحها القرآن ليست غيبية تجريدية تنأى عن الحياة ومشاغلها، وإنما هي غيبية مقترنة بالشهود لأن الله سبحانه "عالم الغيب والشهادة" كما أنها غيبية متوازنة لا تغيب فيها الدنيا على حساب الآخرة ولا تطغى فيها متطلبات الروح على متطلبات الجسد وهذا ما جمعته الكلمة النبوية المباركة "جئتكم بخير الدنيا والآخرة"(راجع مسيرة الإمام الصدر11/36).
إنّ المنحى الغيبي المسيطر على عقل المسلم بلغ حد الإفراط بحيث أسهم في إنتاج نسقٍ من التفكير يفسر الأمور تفسيراً غيبياً ولا يأخذ بعين الاعتبار قانون العلية أو منطق الأسباب والمسببات وانعكس ذلك بوضوح على التفسير القرآني فتمّ تفسير الآيات التي تتحدث عن عواقب الأعمال الحسنة أو القبيحة تفسيراً أخروياً، فقوله تعالى ـ مثلاً ـ {وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون}(البقرة:272)، حُمِلَ على الوفاء والعطاء الأخروي مع أن من القريب جداً تفسيره بما يشمل العطاء والوفاء الدنيوي أيضاً.
وهذا المنحى المفرط في الغيبية استولد في المقابل منحى تفريطياً معاكساً تنكر للغيب والغيبيات ونحى في تفسير المعجزات المذكورة في القرآن منحىً مادياً كما يلاحظ ذلك في "تفسير المنار" حيث يفسر "الحجارة من سجيل" التي تحملها "الطير الأبابيل" مما جاء في سورة الفيل ـ مثلاً ـ بأنها عبارة عن الجراثيم الفتاكة التي تنشر المرض القاتل في جيش أبرهة..
العقائد والحياة:
في ضوء ذلك يكون من الملح جداً للخروج من نفق التجريدية المذكورة ومن حالة الجمود والجفاف المشار إليها والتي أثرت سلباً على فاعلية العقائد وحيويتها إعادة النظر في نسق التفكير الكلامي الذي أنتج هذه السلبيات، والانهماك في إعادة توظيف المقولات الكلامية في سياقها الطبيعي الذي يعيد جسر التواصل بين العقيدة والإيمان الفاعل، وعلى سبيل الإيجاز: فإن مبحث معرفة الله ـ مثلاً ـ وهي العقيدة الأم لا يجوز أن نقحمه في متاهات فلسفية جدلية تفقدنا طعم الإيمان وحلاوته أو تنسينا أنفسنا وحاجتها إلى الاطمئنان والأمن الذي يمنحه الإيمان بالله {ألا بذكر الله تطمئن القلوب}، نعم إن الإيمان بالله لا بدّ أن ينتج أمناً واطمئناناً وسلاماً للإنسان سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي أو السياسي أو الشخصي وإلا كان مجرد ترفٍ فكري. قال تعالى:{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}(الأنعام:82)، وهكذا فإن معرفة الله لا تبتعد عن الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخر ولا تنفك عن العمل الصالح، ولذا تمّ القرن بينهما في كتاب الله أكثر من مرة، وهكذا فإن التعرف على الله سبحانه من خلال النظر أو السير التأملي في الآفاق والأنفس يشكل حافزاً للتعرف على أسرار الكون والتعمق في العلوم، ما يعني أن الإيمان يقود إلى العلم ويحفز على المعرفة كما أن العلم أيضاً يقود إلى الإيمان.
ولو جئنا إلى مبحث العدل وهو أصل آخر من الأصول العقدية فلا بدّ من توظيفه بطريقة تطلّ على واقع الإنسان في كل مناحي حياته، لأن الإيمان بعدل الله يسهم في تحرير إرادة الإنسان وتأكيد حريته ورفع الآصار عنه وعدم تكليفه بما لا يطاق أو أما اضطر إليه أو ما أكره عليه... كما أن الاعتقاد بأن الإله العادل جعل الإنسان خليفة له على الأرض يستدعي تحرك هذا الخليفة في خط إقامة العدل ورفع الظلم والحيف عن عباد الله سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي أو القضائي.. ولذا كان من الطبيعي تعميم وصف العدل للإنسان ليغدو وصفاً مشتركاً بين الله وخليفته لا سيما إذا كان يحتل مسؤولية عامة كالمفتى أو القاضي أو الحاكم أو حتى إمام الجماعة.
ولو أخذنا بالحسبان أيضاً الاعتقاد بالنبوة وهو اعتقاد جوهري وأصل من أصول الدين لقلنا: إن النبوة ما هي إلاّ مشروع تغييري يهدف إلى تغيير الواقع الفاسد في معتقداته وسلوكياته، إنها مشروع حياة للأمة روحياً ومادياً { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم}. وأمّا تحويل العلاقة بالأنبياء إلى مجرد علاقة عصبوية أو فكرية هي أقرب إلى الترف أو الفضول الفكري منها إلى العلاقة الفاعلة، أو إلى مجرد علاقة عاطفية أو تقديسية تبلغ حد الغلو بعيداً عن استلهام رسالة النبي(ص) واستهداء سنته ومسيرته، إن ذلك لا يشكل انحرافاً عن هدي النبوات بل تشويهاً وتحريفاً لأهدافها ومقاصدها.
وهكذا الحال في الاعتقاد باليوم الآخر، فو ليس مجرد اعتقاد غيبي لا صلة له بالحياة وهمومها، بل إن الاعتقاد بالمعاد إن لم ينعكس على المعاش انتظاماً ورقابة ذاتية وشعوراً بالمسؤولية فهو اعتقاد غير ذي جدوى ولا قيمة له.
وخلاصة القول: إن العقيدة الحيّة والفاعلة لا يمكن أن تنفصل أو تبتعد عن تربية الإنسان وسلوكه والتزامه جادة الشريعة في كل مناحي الحياة.