نظرات نقدية في التعددية الاعتقادية(1/2)
الشيخ حسين الخشن
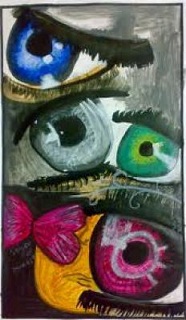
لقد شكّل اليقين حجر الزاوية في بناء المعرفة البشرية بشتّى فروعها، وهكذا الحال في المعرفة الدينية، فإنها ترتكز بشكلٍ وثيق على عنصر اليقين، ولا يمكن أن تستغني كل عمليات الاستنباط الفقهي أو الكلامي عن حجيّة اليقين، هذا بعض ما ذكرناه في مقال سابق تحت عنوان "موقعية اليقين في بناء المعرفة الدينية".
اليقين والمعذورية:
والحجية ـ كما يقول علماء الأصول ـ تعني المنجزية والمعذرية، فمنجزية اليقين معناها إدخال ما وقع مورداً لليقين في عهدة المكلف، وتسجيل الإدانة عليه في حال المخالفة، وأما المعذرية، فمفادها واضح، وهو أن المكلّف معذورٌ في متابعة يقينه، سواء أكان هذا اليقين مصيباً للواقع أو مخطئاً، أما لو كان مصيباً فالمكلف لا يعتبر معذوراً في اتّباع اليقين فحسب، بل هو مأجور في ذلك، وهذا الأمر واضح لا لبس ولا خلاف فيه، إلا أن الكلام فيما لو كان القطع غير مصيب فهل يمكن اعتبار القاطع معذوراً؟
لا خلاف بين علماء المسلمين في معذورية القاطع ـ ولو كان مخطئاً في قطعه ـ في المجال الفقهي، وقد اشتهر على الألسن أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد كما ورد في بعض المأثورات، وأما في المجال العقدي فإن الموقف ينعكس، حيث تختار غالبية علماء المسلمين عدم معذورية القاطع إذا كان مخطئاً في قطعه.
في المقابل ثمّة رأي مخالف تبنّاه عدد قليل من أعلام الفريقين (السنّة والشيعة) يذهب إلى معذورية القاطع، وهو رأي سديد (راجع كتاب الإسلام والعنف، قراءة في ظاهرة التكفير، ص:48-59).
اليقين وعلاقته بالتصويب:
إن الحديث الآنف بشأن منجزية اليقين أو معذريته إنما يصح بناءً على ما هو المعروف من صحة انقسام اليقين إلى يقين مصيب وآخر مخطئ، لكن ربما يقال: بأن الحديث عن الانقسام المذكور هو حديث غير دقيق، فاليقين في المجالات الدينية، سواء العقدية منها أو الشرعية مصيب دائماً، والمجتهد لا يخطى، لأن الحقيقة ليست سوى ما يتوصل إليه المجتهد من آراء ولا واقع لها وراء ذلك، فهل تمكن الموافقة على هذا الكلام؟
وهذا هو البحث المعروف والذي يصطلح عليه علماء الكلام والأصول بمبحث "التخطئة والتصويب"، والمعروف أن في المسألة اتجاهين رئيسيين:
الاتجاه الأول: القول بالتخطئة وهو الذي تبنّاه "الشيعة وجمهور من المسلمين من غيرهم، وربما كان هو الرأي السائد اليوم" على حدّ تعبير السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله (الأصول العامة للفقه المقارن:617)، وفحواه: أنّ ثمة أحكاماً واقعية مجعولة من قبل الشارع لجميع المكلفين، وربما يصل إليها المجتهد من خلال اعتماده على أدوات الاستنباط المعروفة، وهي الأمارات والأصول، وفي هذه الحالة تتنجز عليه ويطالب بها، وربما يخطئ تلك الأحكام ولا يوصله اجتهاده إليها، وفي هذه الحالة يكون معذوراً، وعلى التقديرين، فإن إصابته أو خطأه لا يغيّران من الواقع شيئاً، بل إن واقع التكاليف المحفوظة في علم الله باقٍ على حاله سواءً أصابه المجتهد أو أخطأه.
الاتجاه الثاني: القول بالتصويب، وهو على نحوين أيضاً، الأول: وهو ما اصطلح على تسميته بالتصويب الأشعري، ومفاده كما يقول الغزالي: "أنه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يُطلب بالظنّ، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد (هو) ما غلب على ظنّه، وهو المختار" (المستصفى في علم الأصول 1/359)، فهذا النحو من التصويب يفترض خلو الواقع من أي حكم إلهي، ولكن إذا أفتى المجتهد فإن فتواه هذه تتسلل إلى الواقع لتغدو هي حكم الله.
الثاني: وهو ما اصطلح على تسميته بالتصويب المعتزلي ومفاده: أنه وإن كان لله سبحانه أحكاماً واقعية ثابتة في حق المكلف لكن هذه الأحكام تتغير وتتبدل في حال انتهى المجتهد إلى رأي مغاير لها ليحل رأيه محلها، فكأن الأحكام الواقعية ـ كما يقول الشهيد الصدر ـ مقيدة بعدم الحجة ـ لدى المجتهد ـ على خلافها، فإن قامت الحجة على الخلاف تبدلت واستقرّ ما قامت عليه الحجة (راجع الحلقة الثانية، ص:16).
إلاّ أنّ القول بالتصويب مرفوض وقد تمّ تفنيده بكلا معنييه في علم الأصول، أما المعنى الأول فلوضوح شناعته وبطلانه، لأن ما يقوم لدى المجتهد من أدلة وحجج "إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا اتجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟!"، وأما الثاني "فلأنه مخالف لظواهر الأدلة وما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية" (الحلقة الثانية، ص:17). والحقيقة أنّ القول بالتصويب يعكس اتهاماً للشريعة بالنقص وعدم الشمول، الأمر الذي يفتح الباب على تصويب كل الآراء رغم اختلافها وتضاربها (المعالم الجديدة للأصول، 39).
لا تصويب في قضايا الاعتقاد:
هذا، ولكن الخلاف المذكور وانقسام علماء الكلام إلى مخطِّئة ومصوّبة إنما هو في مجال الفروع والأحكام الفقهية، أما في القضايا العقدية فثمة إجماع إسلامي لم يشذّ عنه أحد على رفض التصويب، يقول الحاجبي في المختصر: "الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد، وأنّ النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أو لم يجتهد"، ويقول في شرح المختصر: "الإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في المسائل العقلية واحد، إذ المطابق لما في نفس الأمر لا يكون إلا واحداً..".
ويقول العلامة الحلي: "أجمع العلماء على أن المصيب في العقليات واحد إلا الجاحظ والعنبري، فإنهما قالا: كل مجتهد مصيب، لا على معنى المطابقة، بل بمعنى زوال الإثم"، (راجع هذه الكلمات في "تعليقة على معالم الأصول" للسيد علي القزويني، 7/285-286).
ولا يخفى أن مخالفة الجاحظ والعنبري إنما ترجع إلى معذورية المجتهد المخطئ في العقائد، وقد أشرنا إلى صحة ما ذهبا إليه، ولا ترجع إلى تبني التصويب بمعنى مطابقة آراء المجتهدين ـ على تعددها ـ للواقع.
وخلاصة الدليل على بطلان التصويب أن ثمة واقعاً محدداً سواء على المستوى العقدي أو التشريعي كما تدل على ذلك النصوص الدينية وهذا الواقع ثابت لا يتغير، وأما اليقين فإن دوره هو الكشف عن الواقع وليس إنتاجه وإيجاده أو تغيير هويته وحقيقته، وكذا الحال في الظن، فعلمي أو ظني بعدم وجود الصين ـ مثلاً ـ لا ينفي وجودها، تماماً كما أن علمي أو ظني بوجودها ليس هو المحقق لوجودها. وعليه يكون القول بالتصويب في العقليات والعقديات محال عقلاً، لأدائه إلى اجتماع النقيضين أو الضدين (راجع المصدر السابق، ج7/287)، بل يمكن القول بأن التصويب في المجال العقدي أشد شناعةً من التصويب في المجال التشريعي، لأن المفاهيم العقدية ـ كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر.. ـ تعبّر عن وجودات حقيقية ثابتة في عالم الواقع والخارج، وليست كالأحكام مجرد اعتبارات مجعولة من قبل الشارع تبعاً للمصالح والمفاسد، ما يسمح من الناحية النظرية بإناطتها برأي المجتهد.
التصويب بثوب جديد:
على الرغم من الإجماع المشار إليه حول بطلان التصويب في المجال العقدي، إلا أن ثمة طرحاً مستجداً يتحرك تحت ستار التعددية وينطلق من قاعدة فكرية تختزن الإقرار بمبدأ التصويب وتلتقي معه في الروح، مع فارق أساسي بينه وبين التصويب التقليدي، وهو أن الأخير يقتصر على دائرة الأحكام، ولا يشمل المعتقدات كما سلف، بينما يمتد التصويب في ثوبه الجديد إلى دائرة المعتقدات الدينية، مبتنياً ومفترضاً في واحد من أشد اتجاهاته تطرفاً أن المعتقدات لا تمتلك أية واقعية، فمفاهيم دينية من قبيل "الله" "اليوم الآخر" "الجنة والنار"، هي مجرد مفاهيم خيالية أسطورية صاغها عقل المصلحين الدينيين لهدف نبيل وهو حثّ الناس على التواصل والتلاقي والتناصر إلى غير ذلك من أعمال الخير، وإبعادهم عن التناحر والظلم وغير ذلك من الأعمال السيئة، فعندما يخاطب رجال الدين الإنسان بعبارات مثل "لا تقتل ولا تسرق ولا تزنِ... وإلا كان مصيرك هو النار" فليس المقصود بهذا الكلام أن ثمة ناراً حقيقية أو جنةً واقعية، وإنما الغاية من هذا الوعظ الديني هو محاولة تأديب الإنسان وسوقه نحو الكمال.
وثمة اتجاه آخر للتعددية التصويبية أخف وطأة من سابقه يذهب إلى تصويب كل الاجتهادات الدينية، وأنه لا يصح لأحد احتكار المشروعية الدينية لنفسه وحصر الحق في معتقده الديني والحكم ببطلان سائر الأديان، فكل الأديان صحيحة وتمتلك الحقانية واتباعها مبرئ للذمة. ان هذين الاتجاهين المستجدين في التعددية مرفوضان بشكل حاسم وهذا ما نعرض له في مقال لاحق.