الغدير والوحدة
الشيخ حسين الخشن
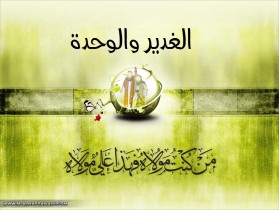
إنّ عنوان "الغدير والوحدة" هو - بكل تأكيد- عنوان جدلي ومثير، فهل الغدير - بما يرمز إليه من تعيين الإمام علي(ع) لموقع الخلافة من قبل رسول الله(ص) في منطقة تعرف بغدير خم- يلتقي مع الوحدة الإسلامية؟
أليس الغدير- قد يتساءل البعض- عنوان الإنقسام في الأمة؟ كما أنّ الإصرار على استعادة الغدير هو إدانة صريحة لتلك الرموز التي لم تلتزم الغدير وانقلبت عليه؟
لا أظنّ أنّ الغدير والوحدة نقيضان أو ضدان لا يلتقيان، بل إنّ الغدير لا يشكّل عائقاً أمام وحدة الأمة إذا ما فهمنا دلالته جيداً، وحدّدنا مفهومنا للوحدة بشكل جيد، وذلك باعتبارها خياراً لا يلغي التنوّع ولا يعني انصهار المذاهب في مذهب واحد أو إنتاج إسلام بلا مذاهب. بل إنّ الغدير كنص على الإمامة ربما كان أقرب النصوص انسجاماً مع مبدأ الوحدة، وإليك البيان:
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفكرة المطروحة في هذا البحث منقولة عن بعض علمائنا وعلى رأسهم الفقيه السيد البروجردي.
الإمامة في بعديها الفكري والزمني:
صحيح أنّ إمامة الأئمة من أهل البيت(ع) هي حقيقة إسلامية لا ريب فيها ولا مجال للاجتهاد - من وجهة نظر شيعية- فيها أو إعادة النظر بشأنها، لكن السؤال ما هي حقيقة الإمامة؟ وما هو جوهرها وكنهها؟
عرّف المتكلمون وغيرهم الإمامة بأنّها "رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين" (أنظر: الشافعي في الإمامة للسيد المرتضى ج1 ص5) وما يشي به هذا التعريف أنّ للإمامة بعدين: بعد زمني دنيوي، وبعد معرفي ديني، وإذا كان البعد الزمني والدنيوي مفهوماً أي أنّ الإمام المتعين لاستلام زمام القيادة السياسية في الأمة وهو صاحب السلطة الشرعية، لكن ما المراد بالبعد الديني للرئاسة (مع صرف النظر عن النظر عن التحفظ على مصطلح الرئاسة الدينية)؟
إنّ الرئاسة الدينية أو قل المرجعية الدينية لا يراد بها ما يمثله مصطلح المرجع في زماننا باعتباره فقيهاً أميناً على استنباط أحكام الشريعة من مصادرها، وإذا أصاب في اجتهاده فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. وإنّما مرجعية الإمام المعصوم الدينية هي مرجعية أعمق وأشمل من ذلك بكثير، بل قل إنّها مغايرة لذلك، لأنّ مرجعية المعصوم – وفقاً لمدرسة أهل البيت(ع)- ليست مسألة اجتهاد أو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي، وإنّما تعني أنّه الأمين على بيان حكم الله الواقعي من غير اجتهاد، كما أنّه الحفظ لدين الله عقيدة وشريعة، وهو هنا ينهل من عين صافية لا مجال معها للاجتهاد والخطأ، "حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين(ع) وحديث أمير المؤمنين(ع) حديث رسول الله(ص) وحديث رسول الله(ص) قول الله عزّ وجلّ" (الكافي ج1 ص53).
ماهو الأصل؟
مع اتضاح أنّ للإمامة هذين البعدين يأتي السؤال عن موقع كل من هذين البعدين من الإمامة كأصل عقدي؟
نستطيع القول: إنّ البعد الديني والروحي والمعرفي هو الأساس في الإمامة وهو جوهرها وعمادها وهو الاصل فيها، أعني أنّه هو الذي أوجب إدراج الإمامة في أصول الدين عند الإمامية، وأوجب أيضاً أن يكون الإمام معصوماً، فالعصمة شرط في الإمام باعتباره الحافظ لدين الله والمبين لشرعه، والسبب المتصل بين السماء والأرض، أمّا البعد الزمني في الإمامة فليس من مقوماتها ويمكن أن ينفك عن الإمامة دون أن يسقط جوهرها أو يخدش في مفهومها، إنّ السلطة الزمنية هي مسألة فرعيّة فقهيّة وليست مسألة عقدية، نعم لا شك أنّ الإمامة السياسية الزمنية هي من مهام المعصوم في حال وجوده وظهوره، لأنّ الأكفأ من الناحية الدينية والروحية والسلوكية هو أكفأ في إدارة الدولة وسياسة العباد، إلاّ أنّ السلطة الزمنية لا تنحصر بمن له السلطة الدينية بمعناها المتقدّم، أعني المعصوم، ولذا لم تكن العصمة شرطاً في الحاكم والوليّ كما هو شرط في الإمام(ع)، إنّ التزامنا بشرعية السلطة السياسية لغير المعصوم وبصرف النظر عن نظرية الحكم المتبناة لنا، (ولاية الفقيه أو الشورى) هو اعتراف بعدم استشراط العصمة في القائد.
باختصار إنّ الإمامة ببعديها الزمني والديني هي حق للإمام المعصوم، لكن السلطة الزمنية حق قابل للإسقاط من قبل صاحبه ولا يضرّ تنازله عنه أو انتزاعه منه قهراً في إمامته، أما المرجعية الدينية فهي حقّ غير قابل للإسقاط حتى من قبل الإمام نفسه فضلاً عن أن ينتزعها منه أحد، وتوليه للسلطة السياسية أو عدم توليه لها لا يقدّم و يؤخر في إمامته الدينية، وفي ضوء ذلك نفهم قوله(ص): "الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا"، فإنّ إمامتهما في حال قعودهما – بمعنى توليهما للسلطة- هي الإمامة الدينية والروحية.
وإنّ المتأمل في نصوص الإمامة مما ورد عن رسول الله(ص) بشأن الإمام علي(ع) والأئمة من ولده سيكتشف أنّ معظم هذه النصوص تتجه إلى تأكيد المرجعية الدينية للأئمة(ع)، لأنّ هذه المرجعية هي التي تحفظ الدين وتعصم الأمة، فحديث "الثقلين" وحديث "السفينة" وحديث "أنا مدينة العلم" وغيرها من الأحاديث النبوية إنّما تركز بشكل رئيس على المرجعية الفكرية لأهل البيت(ع).
إنّ هذه النصوص تشهد لكون البعد الزمني هو الأصل في الإمامة.
ومما يشهد أيضاً لما ذكرناه من أن البعد الديني في هو الأصل، بينما البعد الزمني هو الفرع الذي لا تدور الإمامة مداره:
أولاً: إنّ الأدلة العقلية والنقلية التي ساقها علماؤنا على ضرورة الإمامة وحاجة الأمة إليها، وهي أدلة تناظر الأدلة التي سيقت لإثبات ضرورة النبوة، إنّ هذه الأدلة هي شاهد بيّن لا لبس فيه على أنّ الإمامة إنّما عدت أصلاً اعتقادياً بلحاظ المهمة الدينية المنوطة بالإمام، كما أنّ دليل العصمة هو شاهد آخر على ذلك.
ثانياً: إنّ المرجعية السياسية لأهل البيت(ع) لو كانت هي الأصل في الإمامة للزم الحكم بتضليل من لم يعتقد بها حتى لو كان معذوراً في عدم اعتقاده لجهلٍ أو غفلة أو نحو ذلك، ولذا لو أنّ شخصاً آمن بالأئمة من أهل البيت(ع) كمرجعية دينية، يأخذ منهم معالم دينه، ويتّخذهم حجة بينه وبين الله ولكنه لم يوطن نفسه على الإيمان بمرجعيتهم السياسية لعدم التفاته إلى ذلك أو عدم وضوح ذلك لديه، فإنّ ذلك لا يخدش في إيمانه بالمعنى الأخص شيئاً، كما أنّ الشخص الذي لم يلتزم بالإمامة السياسية لأهل البيت(ع) وآمن بإمامة غيرهم لا يُعدّ كافراً أو خارجاً عن الدين، لأنّه لم يتنكر لأصلٍ من الأصول، نعم إنّ ذلك قد يشكّل عصياناً وفسقاً ولكنّه ليس كفراً، ومن هنا فلم يحكم علماء الشيعة بكفر منكر حق الإمام في السلطة أو منكر نص الغدير وحتى الذين أقصوا الإمام علي(ع) عن حقه لم يحكم أحد بكفرهم. صحيح أنّ هذا الإقصاء ترتب عليه الكثير من المفاسد، ومنع أو حال دون الإفادة الكاملة من فكر على المعصوم، بمعنى أنّ الإقصاء عن المرجعية السياسية أثّر سلباً على استفادة الأمة من المرجعية الدينية لأهل البيت(ع) لكن هذا ليس قدراً لازماً، بل إنّ وظيفتنا اليوم أن نعمل على فكّ الحصار عن فكر علي(ع) بهدف إيصاله إلى العالم، إنّها مسؤوليتنا نحن الذين ننتمي إلى علي(ع).
تصويب المسار
وفي ضوء هذا التفكيك المشروع بين البعدين المذكورين يجدر بنا أن نصوّب مسارنا في التعاطي مع قضية الإمامة، لأنّ مشكلتنا أننا نثير المعارك والصراعات الكلامية المذهبية على الفرع ونترك الأصل، فنبذل معظم الجهود البحثية ونصرف وقتاً كبيراً لتأكيد المرجعية السياسية لأهل البيت(ع) وأحقيتهم في تولي السلطة بعد وفاة رسول الله(ص)، مع أنّ هذه المرجعية – وهي حق- ليست هي الأساس في إمامتهم كما عرفنا، وإنماهي قضية تاريخية وأصبحت جزءاً من تاريخنا وليست قضية اعتقادية يدور الإيمان مدارها.
إنّ وظيفتنا اليوم أن نبذل الجهد الأكبرفي تأكيد المرجعية الدينية – لا السياسية- لأهل البيت(ع)، كما يرى السيد البروجردي(رحمه الله) والذي أولى أهميّة خاصة لحديث الثقلين وكتب عنه بإسهاب في مقدمة كتابه "جامع أحاديث الشيعة" وأمر بعض العلماء بتأليف رسالة مستقلة حول طرقه ومتنه، وكان يعتقد أنّه لو اكتفى الشيعة في هذا العصر الذي انتهت فيه مشكلة الخلافة في إثبات صحة مذهبهم بحديث الثقلين الدال على المرجعية العلمية لأهل البيت(ع)فسينجحون في إثبات شرعية مذهبهم وإقناع الآخرين بأنّ التمسك بأقوال وفتاوى العترة النبوية قادر على توحيد المسلمين والحيلولة دون اختلافهم". (نداء الوحدة والتقريب للشيخ واعظ زادة الخراساني ص 235-236).
في ضوء ما تقدّم نقول: إنّ الغدير إذا كان رمزاً للخلافة في وجهها الزمني فلا يتحمّل أن نجعله عنواناً للقطيعة والانقسام المستمرّ ولا عنواناً للتكفير والإخراج عن الدين، أمّا إذا كان رمزاً للمرجعية الدينية لأهل البيت(ع) فهو يستحق الاحتفاء به أكثر مما نحتفي به وبشكل مختلف عما نفعله، إنّه في هذه الحالة يستحق منا أن نحوّله إلى يوم ثقافي عالمي للتعريف بفكر أهل البيت ومخزونهم الروحي والديني.
إنّ هذا المسار في التعاطي مع قضية الغدير خصوصاً ومع إمامة أهل البيت(ع) عموماً سيؤسس لوحدة الأمّة على أسس متينة وبطريقة أقل كلفة وأعظم فائدة للأمة، أما أنّه أقل كلفة وأخف وطأة فلأنّه مسار لا يصر على ضرورة أو أولوية إدانة التاريخ أو رموزه، وإنْ كان لا ينفي مشروعية قراءته ومحاكمة تلك المرحلة، لكنّه لا يرى أنّ هذه الأولوية، فالأولوية اليوم هي لتصحيح حاضرنا لا للتصارع باسم التاريخ ورجالاته { } أما أنّ أعظم بركة وفائدة فلأنّه يفتح الباب واسعاً ليس أمام وحدة الأمة وتلاقيها وحسب، بل أمام الإفادة للفكر المعصوم والمشرق لأئمة أهل البيت(ع) عندما يخرجهم من دائرة الإنقسام الحاد ويجعلم فوق العصبيات الضيقة.