قضايا الاعتقاد بين الأصول والضروريات والنظريات
الشيخ حسين الخشن
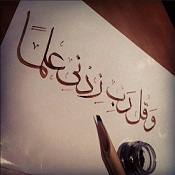
لا يخفى أن القضايا الاعتقادية ليست من صنفٍ واحد ولا في رتبة واحدة ولا تتساوى في الأهمية والمكانة، ولا يجوز الخلط بين أنواعها وأصنافها المختلفة لما لذلك من نتائج سلبية خطيرة تتصل بقضايا الإيمان والكفر.
والحقيقة أن بالإمكان تصنيف القضايا الاعتقادية وفق عدة معايير واعتبارات، وفيما يلي نشير إلى واحد من هذه التصنيفات، وهو التصنيف الذي يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاعتقادية، وما يترتب على ذلك من لوازم.
وبهذا الاعتبار يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ الأصول، 2 ـ الضرورات، 3 ـ النظريات.
الأصول:
الأصول هي تلك المفاهيم الأساسية التي تشكل ركائز الإيمان وأسسه على أن يكون للاعتقاد بها كامل الموضوعية في صدق الانتماء والانتساب إلى الدين، بحيث يكون عدم الإيمان بها ـ سواء أكان ذلك لعنادٍ وتقصير أو غفلةٍ وقصور ـ موجباً لخروج الشخص عن الدين، وعلى سبيل المثال: فإن الشخص الذي لا يؤمن بالله لا يُعدّ مسلماً مهما كان سبب كفره، وكذلك من لا يؤمن برسول الله(ص) فهو ليس مسلماً ولو كان معذوراً في عدم إيمانه، كما لو لم يصله صوت الدعوة إطلاقاً، هذا هو المعروف في تقرير معنى الأصل وتعريفه.(راجع على سبيل المثال: التنقيح في شرح العروة الوثقى:2/58-59).
إلاّ أن في هذا التعريف تأملاً ينطلق من احتمال أن الكفر مساوقٌ للجحود، كما يستفاد من بعض النصوص، من قبيل صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(ع): "لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا"(الكافي2/388)، وهذا ما تبنّاه بعض الإعلام كالشهيد مطهري رحمه الله، ما يعني أنّ من لا يؤمن بالله أو رسوله لا يُعدَّ كافراً إلاّ في حال جحوده (راجع للتوسع حول هذا الموضوع كتاب الإسلام والعنف، قراءة في ظاهرة التكفير39-47). إنه وبناء على هذا القول يسقط الضابط المتقدم في تعريف الأصل، إذ لا يبقى لإنكار الأصل أية خصوصية للحكم بالكفر، وإنما الخصوصية كل الخصوصية هي للجحود، فمن جحد أصلاً يُحكم بكفره، وكذلك من جحد فرعاً مع علمه والتفاته إلى أنّ إنكاره وجحوده مستلزمٌ لتكذيب الرسول(ص).
تعداد أصول الدين:
لكن مع صرف النظر عن التأمل المشار إليه وأخذ الضابط المذكور في تعريف الأصل بعين الاعتبار، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي المفاهيم الاعتقادية التي تدخل في التعريف المذكور؟
إن من المؤكد الذي لا خلاف فيه بين المسلمين دخول الإيمان بالله ووحدانيته والإيمان بالنبوة الخاصة أعني نبوة سيدنا رسول الله محمد(ص) في تعريف الأصل، فمن لا يؤمن بالتوحيد أو النبوة فهو خارج عن الإسلام مهما كان سبب عدم إيمانه، أكان معذوراً في ذلك أو غير معذور.
لكن ماذا عن المعاد؟
المعروف والمشهور أنه أصل من الأصول، بمعنى أن من لا يؤمن به فهو خارج عن الإسلام ولو كان معذوراً في عدم إيمانه، وبذلك تغدو أصول الدين ثلاثة وهي التوحيد، النبوة، المعاد، في المقابل ثمة رأي آخر يقرّ بركنية المعاد لكنه لا يعتبره أصلاً بالمعنى المتقدم للأصل، أي أنه لا يحكم بكفر من لا يؤمن به فيما لو كان معذوراً، كما لو فرضنا أن إنساناً تولد من أبوين مسلمين ولكنه عاش في أجواء غير دينية بحيث لم يسمع بفكرة المعاد رأساً فلا يحكم بكفره، وعلى هذا القول تغدو أصول الدين اثنين فقط، وهما التوحيد والنبوة، ومما يشهد لثنائية أصول الدين جملة من النصوص التي تؤكد على دور الشهادتين في الانتساب إلى الإسلام، كما في الحديث المروي عن الإمام الصادق(ع): "الإسلام: شهادة أن لا إله إلاّ الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس"(الكافي2/26) (ولمزيد من التوسع راجع أيضاً: الإسلام والعنف ص:18-22).
أصول الدين والمذهب:
لكن أين يندرج العدل وكذا الإمامة وفق الضابط المتقدم؟ هل يندرجان في عداد أصول الدين؟ أو أنهما من أصول المذهب كما شاع في بعض الكلمات؟
والجواب: أنه قد اتضح مما تقدم أن الإمامة والعدل ليسا من أصول الدين، لأن عدم الإيمان بهما لا يضرّ في صدق الانتساب إلى الإسلام بالاتفاق. وإنما هما من أصول المذهب، وأصول المذهب هي تلك المفاهيم التي يكون للاعتقاد بها مدخلية في صدق الانتماء إلى المذهب، ومن لا يؤمن بها ولو لعذرٍ لا يكون منتسباً إلى المذهب، على سبيل المثال: فإن من لا يؤمن بالإمامة لا يُعدّ مؤمناً اثنا عشرياً حتى لو كان معذوراً في عدم اعتقاده بها، والكلام عينه يجري في العدل وغيره من المفاهيم التي تعدها المذاهب أصولاً اعتقادية لها، بحيث يتوقف الانتماء إلى المذهب على الإيمان بها.
الضروريات:
الصنف الثاني من المفاهيم الاعتقادية: هو تلك المفاهيم التي لا ترقى إلى مستوى الأصول لجهة توقف صحة الانتماء إلى الدين على الإيمان بها، غاية ما هناك أنها مفاهيم أساسية تتسم بالوضوح والبداهة بما لا تحتاج معه إلى تجشم عناء الاستدلال عليها ومن هنا جاءت تسميتها بالضرورات الدينية، وهي من قبيل عصمة النبي(ص) في التبليغ، أو خاتمية نبوته، وهكذا المعاد على القول الثاني المتقدم، إلى غيرها من المفاهيم.
والفارق بين الضروريات والأصول يتلخص: في أن عدم الإيمان بالأصل ولو لعذرٍ موجب للخروج عن الدين كما عرفت، بعيداً عن التحفظ الذين سجلناه، أما الضرورة فلا يضرّ عدم الإيمان بها في صدق الانتماء إلى الدين ما لم يجرّ الأمر إلى الإنكار، على أنّ ثمة خلافاً هنا حاصلة: إن الإنكار بعنوانه هل هو من موجبات الكفر؟ أو أنه لا يوجبه إلا في حال استلزامه إنكار أصلٍ من الأصول؟ ثمة خلاف في ذلك، والصحيح هو الرأي الثاني الذي تبناه جمع من الأعلام (راجع: القضاء والشهادات للشيخ الأعظم329، مستمسك العروة للحكيم1/380 التنقيح في شرح العروة3/60).
ضرورات الدين والمذهب:
ثم إن الضرورات ـ كما الأصول ـ تنقسم إلى ضرورات دينية وهي واضحات الدين لدى كل المنتسبين إليه وقد تقدم التمثيل لها، وضرورات مذهبية، وهي الواضحات والمسلّمات لدى مذهب معين من قبيل: الإيمان بعصمة الأئمة من أهل البيت(ع) لدى الامامية، ولا يترتب على إنكار ضرورات المذهب الخروج عن الدين بالإجماع، وإنما يشكل إنكارها خروجاً عن دائرة الانتماء المذهبي.
أجل، ثمة سؤال يفرض نفسه في المقام وهو: ما الفرق بين الأصل المذهبي والضرورة المذهبية؟
والجواب: الفرق بينهما يكمن في أنّ الإيمان بالأصل والاعتقاد به شرطٌ لانخراط الإنسان في دائرة المذهب ولو بشكل رسمي، أما الضرورة فلا يتوقف صدق الانتماء المذهبي على الإيمان بها، وإنما يتوقف على عدم إنكارها.
النظريات:
والصنف الثالث: هو المفاهيم النظرية التي لا يتوقف الانتماء المذهبي ـ فضلاً عن الديني ـ على الإيمان بها، كما أنها ليست من ضروريات الدين ولا المذهب، ويمكن تسميتها بالفروع النظرية الاجتهادية، لحاجتها إلى إقامة البرهان عليها، وإمكانية الاجتهاد فيها، ولا يترتب على إنكارها أو عدم الاعتقاد بها تكفيرٌ ولا تفسيق، ما لم يجرّ إنكارها إلى إنكار الأصول. والفروع النظرية العقدية كثيرة جداً، بل إنها تمثل النسبة الأكبر من قضايا الاعتقاد، فكل ما عدا الأصول والضرورات هو في عداد النظريات، من قبيل: أُميّة النبي(ص)، إيمان آبائه، وهكذا الحال في الكثير من تفاصيل المعاد أو غيره من الأصول.
وكما هو الحال في الأصول والضرورات فإن النظريات أيضاً تنقسم إلى: فروع نظرية دينية، كالأمثلة المتقدمة، وفروع عقدية مذهبية، كما في الولاية التكوينية، فإنها على فرض ثبوتها ليست سوى مجرد فرع نظري مذهبي وليست من ضرورات المذهب(راجع فلسفة الولاية للشيخ مغنية ص:28).
ضروريات المذهب نظريات الدين:
في ضوء ذلك فإنّ علينا التنبّه جيداً إلى أن الكثير من الضرورات المذهبية هي نظريات دينية، أي أن مسألة عقدية واحدة قد تكون ضرورية ونظرية في الآن عينه، فهي في موازين المذهب الخاصة قضية ضرورية أما وفق موازين الدين لا تعدو كونها فرعاً نظرياً، وهذا من قبيل ولاية أهل البيت(ع)، فإن الولاية بمعنى المودة والمحبة هي من ضروريات الدين، إذ لا ينكرها أحد من المسلمين، وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي "ليست من ضروريات الدين بوجهٍ وإنما هي مسألة نظرية" كما يقول السيد الخوئي رحمه الله(التنقيح في شرح العروة المدرج ضمن موسوعة السيد الخوئي3/79 ـ80) أي أنها من نظريّ الدين، وضروريّ المذهب.