مراتب الإسلام والكفر
الشيخ حسين الخشن
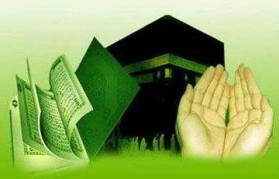
قد يخيّل للكثير من الناس الذين يجمدون على ظواهر النصوص أنّ الإسلام أو الإيمان مرتبة واحدة، من أصابها فهو ذو حظٍّ عظيم، ومن أخطأها عُدَّ في زمرة الكافرين، ولو آمن بالله ورسوله(ص) واليوم الآخر، أو صلّى وصام وحج بيت الله الحرام، بيد أنّ الحقيقة ليست ذلك، فللإسلام مراتب متعددة ومدارج متفاوتة، والناس في بلوغ هذه المراتب مختلفون ومتفاوتون، فمنهم من يوفق فينال من الإسلام حظاً عظيماً ويبلغ رتبة رفيعة، ومنهم من لا يحمل من الإسلام إلا إسمه، وهذا التفاوت أو الاختلاف يرجع إلى أسباب عديدة، من أهمها: همة الإنسان وإرادته واستعداده وبيئته الثقافية والتربوية.
وإذا كان للإسلام مراتب عديدة، فإنّ من الطبيعي أن يكون للكفر - في المقابل - مراتب عديدة بعدد مراتب الإسلام، فكل مرتبة من مراتب الإسلام يقابلها مرتبة من الكفر، والمهم في المقام هو أن ندرك جيداً ونتنبه إلى أنّ بعض مراتب الكفر لا تلتقي مع الإسلام بشكل تام، وبعضها الآخر يلتقي مع الاسلام في بعض مراتبه، وإنّ الخلط بين هذه المراتب وعدم القدرة على التمييز بينها كان سبباً في ارتكاب الكثير من الأخطاء والجنايات وفي استفحال ظاهرة التكفير، ولهذا كان تسليط الضوء على هذه القضية أمراً في غاية الأهمية.
الإسلام والإيمان
وفي البدء، فإننا نسلط الضوء على مراتب الإسلام، فنقول: إنّ الذي يستفاد من القرآن الكريم والسنة الشريفة أنّ هناك دائرتين أساسيتين يندرج المسلمون في نطاقهما، وهما : دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، ولا يخفى على المطلع على النصوص والأثار الإسلامية أنّ ثمة فارقاً جوهرياً وشاسعاً بين الإسلام والإيمان، فالإيمان يعبر عن تجذر العقيدة في القلب وتجسيد أحكام الشريعة من خلال السلوك والعمل، أمّا الإسلام، فيكتفى فيه – بلحاظ أدنى مراتبه - بالإنتماء الظاهري إلى الدين ولو لم يتجذر في القلب ولم يصدقه العمل، وعليه يكون الإيمان أخص من الإسلام، فليس كلّ مسلم مؤمناً وإن كان كل مؤمن مسلماً، قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ...} (سورة الحجرات آية 14). وتوضّح الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) هذا الفارق وتؤكد عليه، وقد سجل الفيض الكاشاني في كتابه "الوافي" العشرات من هذه الروايات تحت عنوان "الإيمان أخص من الإسلام"، ونكتفي – هنا - بنقل رواية واحدة، وهي ما رواه سماعة ( أحد أصحاب الإمام الصادق ) قال: "قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: "إنّ الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله (ص)، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان: الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاه،ر والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة" 1.
وكما أنّ للإسلام مراتبه المختلفة، فللإيمان أيضاً مراتبه التي يتفاوت العباد في القدرة على بلوغها والوصول إليها، ولا يصحّ لصاحب المرتبة العليا أن يشكك في إيمان من هو أدنى منه، ففي الخبر عن مولانا الصادق (ع): "إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السّلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، فلا يقولنّ صاحب الإثنين لصاحب الواحدة لست على شيء حتّى ينتهي إلى العاشرة، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك درجة، فارفعه إليك برفقٍ ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره، فإنّ من كسر مؤمناً فعليه جبره" 2.
مراتب الكفر
وإذا كان للإسلام مراتبه المتعددة، فإنّ للكفر - في المقابل - مراتبه ومدارجه المختلفة، وكذلك الحال في الشرك، والأمر الذي لا يفقهه الكثيرون هو أنّ بعض مراتب الكفر لا تنافي الإسلام، بل إنّها تلتقي معه في بعض مراتبه، بمعنى أنّ الشخص يكون محكوماً بالإسلام ولكنه مع ذلك يتصف بنوع من أنواع الكفر أو الشرك، ولكنّ بعض مراتب الكفر لا تلتقي مع الإسلام بوجه من الوجوه، بل إنّها تنافيه منافاة مطلقة، وتوضيحاً وتفصيلاً لهذا الأمر نقول:
إنّ الكفر ينقسم إلى كفر عقائدي، وآخر عملي، والأخير ينقسم إلى كفر نعمة، وكفر معصية.
أما الكفر العقدي: فهو الكفر بالله أو برسوله أو باليوم الآخر، وهذا النوع من الكفر لا يلتقي مع الإسلام في شيء، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً*أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً} (سورة النساء، آية: 150 – 115).
وأما الكفر العملي: فهو عبارة عن التمرّد السلوكي والعملي على التشريع، نتيجة السقوط تحت تأثير الغرائز والشهوات أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا النوع من الكفر سواء كان كفر نعمة، كما في قوله تعالى: {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} ( سورة ابراهيم آية: 7)، أم كفر معصية، كما في قوله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (سورة آل عمران آية 97) ، لا يوجب الخروج عن الدين، نعم هو مستلزم للفسق والخروج عن الإيمان، يقول الإمام الصادق (ع) – على ما روي عنه – "الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: فمنها: كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله تعالى، وكفر البراءة، وكفر النعمة.." ثم إنّه فصّل (ع) هذه الوجوه الخمسة، فقال ما ملخصه:
1- فأما الوجه الأول من كفر الجحود، فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول: لا ربّ ولا جنة ولا نار..
2- والوجه الآخر من كفر الجحود هو أن يجحد الجاحد ما يعلم أنّه حق، قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ} (سورة النمل آية: 14).
3- كفر النعمة، واستشهد (ع) له بعدة آيات منها قوله تعالى: {هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} (سورة النمل آية: 4).
4- الكفر بترك ما أمر الله به، واستشهد (ع) له بقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ*... وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ...} (سورة البقرة، آية: 84- 58)، فكفرهم بترك ما أمر الله..
5- كفر البراءة، قال تعالى حكاية عن إبراهيم: {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً..} (سورة الممتحنة، آية: 4) 3
أنحاء الشرك
وما ذكرناه في الكفر يأتي نظيره في الشرك، فهو على أنحاء عديدة، فهناك شرك في الألوهية، وآخر في الربوبية، وثالث في الخالقية، ورابع في العبودية، وخامس في الطاعة، وسادس في النيّة، ومن الخطأ الفادح وضع جميع هذه الأقسام الستة في كفة واحدة، لأنّ الأصناف الأربعة الأولى منها، وهي الشرك في الألوهية والربوبية والخالقية والعبودية لا تلتقي مع الإسلام بوجه من الوجوه، فإنّ المشرك في هذه الأقسام يفترض مع الله إلهاً أو رباً أو خالقاً أو معبوداً آخر، وهذا هو الكفر الصريح، وبطلان ذلك من بديهيات الإسلام وضرورياته، ولكنّ الصنف الخامس من هذه الأقسام، وهو شرك الطاعة – ويراد به إطاعة غير الله فيما لم يأذن به، كما في إطاعة الهوى أو الشيطان أو السلطان – فإنّه قد يقع من المسلم، ولا يخرج بذلك عن الإسلام إلى الكفر الكلي، كما يشهد بذلك قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (سورة يوسف، آية: 106)، وفي الخبر عن الإمام الصادق (ع) تفسير الشرك في هذه الآية بأنّه "شرك طاعة وليس شرك عبادة" 4على اعتبار أنّ المعاصي التي يطاع فيها الشيطان تعني اتخاذ مطاع غير الله" ، مع أن من مقتضيات العبودية لله تعالى عدم إطاعة أحد سواه، وحدّثنا القرآن الكريم عن بعض أهل الكتاب أنّهم {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ} (سورة التوبة، آية 31)، مع أنّهم كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق (ع): "ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون" 5.
وأمّا الصنف السادس من الشرك وهو شرك النية ( أي الرياء) فالأمر فيه أكثر وضوحاً، أي أنّه شرك يلتقي مع إسلام الظاهر ولا يضاده، أو قل : إنه ينسجم مع الإسلام بمعناه الرسمي، وقد جاء في العديد من النصوص الحكم على بعض المسلمين بأنهم مشركون، أو أنّ بعض أعمالهم تمثل الشرك، فعن أمير المؤمنين (ع) "إعلموا أن يسير الرياء شرك" 6، وعن الباقر (ع) "من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك... ومن عمل عملاً مما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك" 7، إلى غير ذلك من الروايات، والتي لا يراد من الشرك فيها الشرك الذي يخرج به الإنسان عن دين الله، أو عن دائرة الإجتماع الإسلامي وما تفرضه من حقوق وواجبات، وإلا لم يسلم أحد من المسلمين من ذلك.
مخاطر الخلط بين الكفر العقدي والعملي
وعلى ضوء ما تقدّم يتضح الخلط الكبير الذي وقع فيه بعض الناس الذين يجمدون على ظواهر النصوص سواء كانوا من السنّة أو الشيعة، حيث إنّهم لم يميّزوا بين الكفر العقدي والكفر العملي، أو بين شرك الربوبية وشرك الطاعة، فرتّبوا آثار الأول على الثاني في الموردين، ولذا فإنهم إذا ما قرأوا آية أو رواية تتضمن كلمة الكفر، فإنك تراهم يسارعون إلى تكفير من ذكرته الآية دون أن يتدبّروا في معنى الكفر الوارد فيها ويحددوا المراد به.
وعلى سبيل المثال: عندما واجه بعض الإسلاميين قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (سورة المائدة، آية: 44)، فإنّهم بادروا إلى تكفير الأنظمة التي تعتمد القوانين الوضعية في بعض مجالات الحكم ولا تطبّق شرع الله، وحكموا بإخراج الحكام وكل من انخرط في جهاز هذه الأنظمة عن الدين واستحلوا دماءهم وقتالهم، ولم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن المراد بالكفر في الآية، أو سبب عدم عمل هؤلاء الحكام بشرع الله، مع أنّ هذا وذاك ضروري جداً ومهم للغاية، إذ معرفة ذلك تقودنا إلى إصدار حكم بالكفر أو عدم إصداره، أو إلى تحديد نوع الكفر الذي وقع فيه هؤلاء الحكام، فإذا كان السبب في عدم عمل هؤلاء الحكام بشرع الله ناشئاً عن عدم إيمانهم بالله أو برسوله أو برسالته فهنا يكون للقول بكفرهم مجال واسع، وأمّا إذا كان عدم عملهم بشرع الله ناشئاً عن وجود بعض الظروف الضاغطة عليهم والتي قد تمنعهم من تطبيق شرع الله، أو بسبب وجود بعض الاجتهادات أو القراءات - ولو كانت خاطئة – التي قد تبرر لهم الأخذ بالقوانين الوضعيّة، فهنا لا يمكننا الحكم بالكفر المخرج عن الدين والذي تستحل به الدماء، لأنّ هذا لا يعدو أن يكون كفر طاعة، وهو لا يستلزم الخروج عن الدين، كما أسلفنا.
مثال آخر: عندما واجه بعض الناس الأحاديث التي تتحدّث عن كفر منكر إمامة أهل البيت (ع) كما في قول الصادق (ع): "إنّ الله تعالى نصب عليّاً علماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً... ومن أنكره كان كافراً" 8، فإنهم لم يتردّدوا في الحكم بكفر عشرات الملايين من المسلمين أونجاستهم، لأنّهم لا يؤمنون بإمامة أمير المؤمنين (ع)، مع أنّ هذه الرواية وأمثالها محمولة على بعض مراتب الكفر، ولا يراد بها الكفر الاعتقادي، لأنّ الإسلام متقوّم بالشهادتين، وهو ما عليه عامة المسلمين، كما دلّت على ذلك السنّة القولية والفعلية لرسول الله، كما أسلفنا.
ثمّ لو أردنا الحكم بكفر كل من أطلقت عليه النصوص كلمة الكفر أو الشرك وخروجه عن الإسلام لتحتم علينا أن نحكم بكفر تارك الصلاة، لأنّ بعض الروايات وصفته بالكافر 9، وأن نحكم بشرك من ابتدع رأياً معيناً، لأنّه قد ورد في الخبر أنّ "أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبّ أو يبغض" 10، بل لتحتم علينا أن نفتي بشرك الغالبية العظمى من المسلمين، لأنّهم لا ينفكون عن الوقوع في الرياء في بعض عباداتهم، أو لأنهم قد يطيعون غير الله في بعض الأحيان، وقد مرّ في الحديث أنّ الرياء شرك، وأن إطاعة غير الله هي من مصاديق الشرك، وهذا ما لا يمكن الالتزام به أو التفوّه به، لأنّ بطلان ذلك من البديهيات، ولنعمَ ما قاله الإمام الخميني، تعليقاً على هذه الروايات "والإنصافَ أن سنخ هذه الروايات الواردة في المعارف غير سنخ الروايات الواردة في الفقه... ولذا فإنّ صاحب الوسائل لم يوردها في أبواب النجاسات في جامعه (وسائل الشيعة)، لأنّها أجنبية عن إفادة الحكم الفقهي" 11.
1-الوافي:ج 4ص/77.
2-المصدر نفسه : 4/132.
3-الكافي ج2 ص 390.
4-راجع الكافي ج2 ص 397.
5-الكافي ج2 ص 398.
6-نهج البلاغة: ص 116.
7-وسائل الشيعة: ج1 ص 68.
8-الكافي ج 2 ص 388.
9-الكافي: ج 2 ص 386.
10-الفقيه: ج 3 ص 539.
11-الطهارة: ج 3 ص 321.