في التفسير بالمأثور
الشيخ حسين الخشن
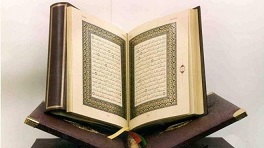
سأل بعض الأخوة الأعزاء تقديم رؤية إجمالية حول التفسير بالمأثور، وهو التفسير الذي يتخذ الخبر مستنداً أساسياً في عملية التفسير، وإجابة على سؤاله فإننا نقول:
إنّ عملية التفسير هي مهمة جليلة وخطيرة في الوقت عينه، أما جلالتها وعظمتها لأنّها تطل بالإنسان على رحاب آيات الله تدبراً وتبصراً، وأمّا خطورتها، فلإنّها في معرض أن يدخلها الهوى وتتحكم فيها المسبقات والإسقاطات المذهبية، الأمر الذي يجعلنا نتورط ولو بدون قصد فيما يعرف بتفسير القرآن بالرأي، وهو ما نهت عنه الروايات، ففي الحديث عن رسول الله (ص): "من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد هلك" .
تفسير القرآن بالقرآن
ولهذا يكون أفضل أنواع التفسيرهو تفسير القرآن بالقرآن، لأنّ المتكلم الواحد هو خير من يفسّر مراده ويوضح كلامه ومرامه، ومن هنا ورد "أنّ القرآن يفسر بعضه بعضاً"، وإليك نموذجاً لتفسير القرآن بالقرآن، وهو تحديد الليلة التي أنزل فيها القرآن، وذلك لأنّه عندما يواجهنا قوله تعالى: {إنّا أنزلناه في ليلة مباركة}،(الدخان )، فإن ما نفهمه عن هذه الليلة أنها ليلة مباركة، ولكننا لا نستطيع تشخيص هذه الليلة وتعيينها في أي شهر، ولكن عندما نقرأ قوله تعالى: {إنّا أنزلناه في ليلة القدر}، فإنّ ذلك سوف يزيد صورة هذه الليلة وضوحاً، ويعطينا تشخيصاً أكثر تحديداً لها، وهي أن ليلة القدر، ولكن يبقى الخفاء قائماً فمتى تكون ليلة القدر؟ وإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}، فسيتضح أن الليلة المباركة وهي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هي في شهر رمضان المبارك.
ماذا عن دور السنة؟
وأما التفسير بالمأثور فما يمكننا أن نقوله بشأنه هو عدة نقاط:
أولاً: إنّ الرجوع إلى الّسنة في تفسير القرآن هو أمر طبيعي وبديهي، فالقرآن نزل على رسول الله فهو أعلم الناس به، محكمه ومتشابهه، مجمله ومبينه، مكيه ومدنيه، ناسخه ومنسوخه.. كما أنّه مكلّف من قبل الله تعالى بأن يبين ما نزل من القرآن للناس، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون}، وعليه فيكون قوله في تفسير كلام الله حجة ومقدم على كل قول، لأنه لا يخضع للاجتهاد أو التفسير بالرأي، بل هو وحي يوحى.
وهكذا فإنّ الرجوع إلى العترة الطاهرة من أهل البيت(ع) في تفسير القرآن هو أمر طبيعي، فهم عدل الكتاب بنص حديث الثقلين الذي أكّد على عدم افتراقهم عن القرآن، "وإنهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" ، على أنّ أمير المؤمنين (ع) هو ربيب القرآن الكريم، وأعلم الناس - بعد رسول الله (ص) - بمواقع نزول الآيات، وهو الذي خاض كل معاركه من أجل القرآن، فقاتل مرّة على تنزيله وأخرى على تأويله.
ثانياً: إلاّ أنّ روايات التفسير لا بدّ أن تخضع لما تخضع له سائر الروايات من ضرورة التوثق من صدورها، لأنّها تعرّضت للوضع والدس، وهذه آفة التفسير بالمأثور، أي أنّ حقل التفسير هو حقل خصب للوضع، فقد روي أنّه قيل لأبي عصمة نوح من أبن مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن الكريم سورة سورة؟ قال: إنّي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة! ولما قيل لبعضهم: "إنّ رسول الله (ص) يقول: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، قال: إنما كذبت له لا عليه!!
وينقل عن أحد الخوارج: "إنّ هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنّا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" .
وأخطر ما تعرض له التفسير بالمأثور على هذا الصعيد هو دخول الإسرائيليات، وهي ما دسّه مسلمة أهل الكتاب، وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منية وعبد الله بن سلام، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ التفسير هو من أكثر من أكثر المجالات التي عبثت فيه أيدي هؤلاء، وقد كان ابن عباس يقول: " كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤنه محضاً لم يشب وقد حدثكم أنّ أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً .." .
والإسرائيليات المذكورة نجدها منتشرة في تفسير"الدر المنثور" و"تفسير جامع الطبري"، ولا سيما في قصص الأنبياء السابقين، كما في قصة هاروت وماروت، وفي قضية المسوخ، وفي إخراج آدم من الجنة ودور الحيّة التي تمثّل بها الشيطان وأغوت حواء، وفي قصة يوسف (ع) وقوله تعالى: "همت به وهمّ بها"، وهكذا قصص كافة الأنبياء فإنها مليئة بالإسرائيليات، وكذا ما يتعلق ببعض الظواهر الكونية، ولهذا نحن معنيون بأن نطهر كتب التفسير من هذه الأكاذيب.
وبصرف النظر عن الإسرائيليات، فإنّ التفسير بالمأثور في الأعم الأغلب يعتمد على أخبار ضعيفة، سواء كان ذلك لدى السنة أو الشيعة، ومن التفاسير بالمأثور عند الشيعة "نور الثقلين" للحويزي و"البرهان" للسيد هاشم البحراني، و"كنز الدقائق" للمشهدي، وهي تفاسير تعود إلى حقبة زمانية واحدة ومتأخرة، وهي القرن الحادي عشر.
ولا بأس بأن نذكر مثالاً من كتب الشيعة للروايات الضعيفة الواردة في تفسير بعض الآيات، وهي رواية واردة في تفسير قوله تعالى: {إنّ الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بعوضة فما فوقها}، حيث يروى عن الإمام الصادق (ع) قوله: "فالبعوضة أمير المؤمنين، وما فوقها: رسول الله" !
ولا يستبعد أن تكون هذه الروايات من دس الغلاة والوضاعين، أمثال المغيرة بن سعيد الذي كذب على الإمام الباقر (ع)، ففي الرواية عن الإمام الصادق(ع): "كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، فكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة" ، وهكذا الحال في أبي الخطاب.
ثالثاً: إنّ توثيق الروايات ليس هو نهاية المطاف في التفسير بالمأثور، بل هناك خطوة أخرى في غاية الأهمية، وهي معرفة ما إذا كانت الرواية الواردة في تفسير القرآن مصداقية أو تفسيرية، فإن الروايات المذكورة على قسمين:
1- روايات تفسيرية، وهي التي تحدد المقصود بالآية، فلا يبقى مجال بعد ذلك لتفسيرها بأمر آخر، أو حملها على المثالية.
2- روايات مصداقية، وهي التي يتم فيها تفسير الآية تفسيراً معيناً يكون من باب ذكر المصداق، أو كما يعبر الطباطبائي بأن ذلك من باب الجري والتطبيق، وهو تعبير استخدمه في العديد من الموارد .
مثال الأول: ما ورد في قوله تعالى: {إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً}، حيث فسّرت هذه الآية من قبل الرسول الأكرم(ص) بالخمسة من أهل الكساء، ولما أدخلت أم سلمة رأسها وسألت النبي وأنا منهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنك على خير.
مثال الثاني: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ورد في الرواية: "نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون" ، وهذه الرواية تذكر مصداقاً للآية، لا أنّ الآية تنحصر بذلك، وهذا من قبيل ما لو نزلت الآية في مورد معين فإنّها لا تختص به، لأنّ المورد لا يخصص الوارد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه ميزة القرآن الكريم التي تمكّنه من مواكبة المستجدات، وهو ما عبرّت عنه الروايات من أنّه "يجري كما يجري الليل والنهار"، فعن الإمام الصادق (ع): "إنّ القرآن حي لم يمت وأنّه يجري ما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر" .
وطبيعي أنّ ثمة أبحاثاً كثيرة على هذا الصعيد تتصل بالتفسير بالمأثور، من قبيل معرفة المعيار الذي في ضوئه تعرف الرواية المصداقية والأخرى التفسيرية، أو غيرها من الأمور والأبحاث.
1-وسائل الشيعة ج27 ص 205، الحديث 79 الباب من أبواب صفات القاضي.
2-سنن الترمذي ج5 ص329.
3-تفسير القرطبي ج1 ص78.
4-الغدير ج5 ص276.
5-تفسير القرطبي ج1 ص78.
6-أنظر: صحيح البخاري ج8 ص160.
7-بحار الأنوار ج4 ص393.
8-اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي ج2 ص491.
9-الكافي ج1 ص211.
10-تفسير العياشي: ج2 ص204.