في رحاب الموت
الشيخ حسين الخشن
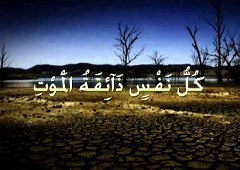
في ذكرى الموت نشعر أنّ حديث الموت هو الغائب الأكبر عن مناسباتنا، هذا مع أنّ الموت هو الأمر الأكثر حضوراً في حياتنا وهو غير تاركنا وإن تركناه ولا ينسانا وإن نسيناه ، وكل دقيقة بل ثانية تمر علينا فإنّها تأخذ معها بعض أفراد الإنسان إلى عالم الموت.
والسؤال: ما هو الموت؟ ما هو سرّه؟ لماذا نخاف الموت ونهرب منه؟ ما علاقة الموت بالحياة؟
1- الموت الحقيقة التي لا مفر منها
إنّ الموت هو الحقيقة التي لا يدانيها في بداهتها حقيقة، وهو السنة الإلهية التي لا تستثني أحداً، فهو يطال كل المخلوقات الحيّة، {كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران 185]، إنه قضاء إلهي مبرم ولا راد له، وسواء أطال عمر الإنسان أم قصر، فإنّ الموت لا محال آتيه، وهو الزائر الثقيل الذي لا يحتاج إلى استئذان ولا يحتاج إلى مناسبة، الموت يزحف إلينا زحفاَ، بل قل: إننا نحن الزاحفون إلى الموت شئنا أم أبينا، فأنفاسنا هي خطواتنا التي تسير بنا إلى الموت يقول الإمام علي (ع): "نفس المرء خطاه إلى أجله" 1، ودقات قلوبنا هي التي تسوقنا إلى الأجل المحتوم، يقول الشاعر:
دقات قلب المرء قائلة له إنّ الحياة دقائق وثوان
2- الموت ليس شراً
والموت في منطق الأديان السماوية ومنها الإسلام ليس عدماً، والتعبير عن القصاص بالإعدام تعبير خاطئ، الموت هو انتقال من عالم إلى آخر، يقول تعالى: {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملاً} [الملك 2]، فالموت مخلوق لله تعالى تماماً كما الحياة، فلو كان عدماً لما كان مخلوقاً، لأنّ العدم ليس خلقاً.
وكما أنّ الموت ليس عدماً فإنّه ليس شراً، والله تعالى لم يجعل شيئاً شراً مطلقاً.
وقد تقول: وكيف لا يكون الموت شراً وهو الذي يسلب منا أغلى نعمة نملكها وهي نعمة الحياة؟ وهو الذي يفجعنا بفقيد هنا أو فقيدة هناك، وبكهل هنا أو شاب هناك ؟
ولكننا نجيب على ذلك:
أولاً: إنّ الموت طبقاً للرؤية الدينية هو نافذة نطلّ من خلالها على عالم الحياة الأبدية، أو جسر نعبر من خلاله إلى تلك الحياة، قد يكون عبور هذا الجسر صعباً وعسيراً لكنه على كل حال سوف يوصلك إلى المقصد، أرأيت إلى الطفل في بطن أمه قد لا يكون راغباً في الخروج إلى عالم الدنيا، لأنّه عالم مجهول بالنسبة، وهو يكره مفارقته، لأنه وطنه، وفراق الأوطان صعب على الإنسان، ولذا فإنّه عندما يطل على هذا العالم فإنّه يستهل حياته بصرخة باكية، إنّها صرخة فراق الوطن والانتقال إلى وطن جديد، لكنه بعد دقائق سوف يتأقلم مع العالم الجديد، ومع الوقت سيكتشف عالم الدنيا ويجد نفسه أمام آفاق رحبة وواسعة وميادين شتى للنشاط لا نظير لها في عالم الرحم المحدود والضيق، وعندما يفارق الإنسان وطنه هذا وهو عالم الدنيا الذي ألفه وارتبط به ويرتحل إلى عالم الآخرة فإنه لا يفارقه باختياره بل يفارقه بحسة وغم وقلق وخوف لا نظير له، ولكنه سيكتشف لاحقاً أن الفارق بين عالمي الدنيا والآخرة هو أكثر بكثير من الفارق بين عالمي الرحم والدنيا.
ثانياً: إنّ الموت هو سنة الحياة فالغصن يبدأ برعماً ثم يخضوضر ثم يميل إلى الإصفرار فالذبول، والإنسان كذلك يبدأ طفلاً فيافعاً فشاباً فكهلاً فشيخاً فانياً، إنّها الدنيا وقوانيها، وعالم الدنيا محفوفٌ – بطبيعته- بالمكاره والصعاب، فلا محالة سوف يمرض الإنسان ويتألم ويكابد { لقد خلقنا الإنسان في كبد}، وسوف يشيخ ويهرم، {ومنكم من يُرد إلى أرذل العمر كيلا يعلم بعد علم شيئاً} [النمل 70] {ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون} [يس 68]، ولذا فإنّ موته في نهاية المطاف سيكون رحمة له وأستر له كما نقول في أدبياتنا الشعبية، قال الشاعر:
راحل أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل
غاية الناس في الزمان فناء وكذا غاية الغصون الذبول
وفي الحديث عن أبي عبد الله (ع): "إنّ قوماً فيما مضى قالوا لنبي لهم: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل، ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده ويوضيهم ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش، فقالوا: سل لنا ربك أن يردنا إلى حالنا التي كنا عليها فسأل نبيهم ربه مردّهم إلى حالهم" 2، فالموت – إذن- قد يكون رحمة لكثير من العباد.
3- كفّى بالموت واعظاً
ومن مظاهر الرحمة الإلهية في الموت أنّه يشكل واعظاً للإنسان، في الحديث عن رسول الله (ص): "كفى بالموت واعظاً" 3، لكن ما أقل المتعظين والمعتبرين، إنّ موت أي إنسان فقيراً كان أو غنياً مؤمناً كان أو غير مؤمن عالماً أم جاهلاً ذكراً أم أنثى هو هاتف يصرخ بنا قائلاً: أيها الناس أفيقوا من كبوتكم فإنكم ميتون فانظروا ماذا أنتم عاملون؟ هو هاتف يهتف بنا قائلاً: إنّ الدنيا ليست دار بقاء بل دار فناء، الدنيا دار ممر الآخرة هي المقر، ويهتف بنا قائلاً: مهما استكبرتم وظلمتم فإنّ هناك من سيقهركم جميعاً ألا وهو الموت، "سبحان من قهر عباده بالموت والفناء"، ويهتف بنا قائلاً: مهما كنتم شجعاناً وأقوياء فأنتم ضعفاء أمام الموت، فهو طالبكم أينما كنتم، {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة} [النساء 78 ].
وخلاصة القول: إنّ الموت أفضل واعظ للإنسان، يساعده على أن يخفف من غروره وكبريائه، فإذا رأيت ميتاً أو محتضراً يلفظ أنفاسه ويصارع الموت فاعلم إنّك ميت مثله، وإذا رأيت جنازة تُحمَل على الأكف فاعلم إنّك محمول مثلها ذات يوم، فهل نتعظ بالموت؟ أو أنه على غيرنا كتب! إن من لم يتعظ بالموت ليس له من واعظ.
4- لماذا نكره الموت؟
لماذا نكره الموت؟ ولماذا نهرب منه، ونطرد فكرته من أذهاننا؟
ويمكننا أن نجيب على ذلك بإجابتين إجابة دينية وأخرى منطقية وهي أقرب إلى علم النفس التربوي:
أما الإجابة الأولى: وهي إجابة نقدمها لكل الناس سواء ممن يؤمن بالحياة بعد الموت أو لا يؤمن بها، وخلاصة هذه الإحابة: إننا نكره الموت لأننا عاديناه ونعمل على أن نطرد فكرة الموت من أذهاننا، ولهذ يبقى الموت عالماً مجهولاً، فنخافه ونصاب بالذعر إزاءه، "والناس أعداء ما جهلوا" 4، أما لو تعاملنا مع المسألة بواقعية ونظرنا إلى القضية من زاوية أنّ الموت آتينا لا محالة رضينا أم كرهنا، جزعنا أم صبرنا، فهذا ينبغي أن يقودنا إلى أن نتعرف على الموت ومن ثم نصادقه وإذا كانت مصادقته صعبة علينا فلا أقل من أن نتفهمه، لأنه القدر الذي لا مفر منه، ولهذا كلما فكرّت بالموت وتعايشت معه أكثر كلما هان عليك لقاؤه أكثر، وكلما طردت فكرة الموت من رأسك كلما أقلقك أكثر، أنا أتحدث عن مسألة نفسيّة مهمة، وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): "إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه" 5، فالموت آتيك والمرض على الأبواب فهل تنهزم وتضعف أمامه ؟ إنك إذا انهزمت أمام المرض أو تملكك هاجس الموت فقد قضيت على حياتك وعشت بقية عمرك محزوناً مهموماً.
لا أريد بهذا الكلام إلا أن نتعايش مع الموت ونتفهمه، ولا أقصد تشجيع أحد على أن يرمي نفسه في لهوات الموت، كلا فهذا انتحار وإلقاء للنفس في التهلكة وهو مرفوض شرعاً وعقلاً، إذ إنّ الله خلقنا في هذه الحياة وأراد لنا أن نعيشها ونتنعم بخيراتها ونتحسس جمالها، ونحرص على نعيشها بصحة وهدوء مهما تقدم بنا العمر، فاليأس مرفوض، فلنبقِ أبواب الأمل مشرعة إلى آخر نفس في حياتنا، وإذا رزقنا الله العمر الطويل فلنحرص على أن يكون في رضى الله، وقد كان إمامنا زين العابدين (ع) يدعو الله تعالى قائلاً: "وعمّرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ أو يستحكم غضبك عليّ" 6، وفي دعاءٍ آخر لبعض الأئمة (ع): "أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ليالموت يعلمنا كيف نعيش الحياة".
أما الإجابة الثانية، فهي أن السبب في أننا نكره الموت، يكمن في أننا لم نعمل لما بعد الموت، ففي الحديث عن الإمام الصادق(ع): جاء رجل إلى أبي ذر فقال : يا أبا ذر " ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب، فقال له: فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال: أما المحسن منكم فكالغائب يقدم على أهله،وأما المسيء منكم فكالآبق يرد على مولاه، قال: فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله إنّ الله يقول:{إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار 13- 14]، قال: فقال الرجل: فأين رحمة الله ؟ قال: {إن رحمة الله قريب من المحسنين} .7
إذا أردت أن تهوّن على نفسك من لقاء الموت ومن ذكرى الموت المزعجة، فإنّ ذلك يتصل برؤيتك لما بعد الموت، فعندما تطل على الموت وتنظر إليه من زاوية من يقول: {إن هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين} [المؤمنون37]، سيبقى الموت هو الهاجس الذي يؤرقك وينغص عليك حياتك والكابوس الذي يزعجك، بل ستشعر على الدوام أنّه الخسارة التي لا تعوّض.
وأمّا إذا نظرت إليه من زاوية أنّه نافذة على الحياة الأخرى، فإنّك حينئذ مهما تهيبت الموت وخفته ستجد أنّ وطأته عليك أخف.
5- الموت ومعنى الحياة
إنّ هذه الرؤية أو العقيدة (الإيمان بالحياة بعد الموت) هي التي تجعل لحياتك معنى، فكلما ازداد إيمانك بالحياة الآخرة أكثر أصبح لحياتك الدنيا معنى أكثر، لأنّك إذا فارقت الحياة الدنيا فلديك حياة أخرى قد تكون أجمل وأفضل، ومهما أخافك الموت فإنّه ليست نهاية المطاف. وإيمانك هذا بالحياة بعد الموت من المفترض أن يمنحك - كفرد - الاطمئنان ويدفعك لتعيش حياة هانئة مطمئنة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّه يمنح المجتمع برمته الاستقرار، لأنّه يدفع الفرد المؤمن لكي تكون إنساناً يعيش إنسانيته ويحترم إنسانية الآخر، فلا يعتدي ولا يظلم ولا يسرق، لأنّ {من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة]، ففكرة الحياة الآخرى تشكل أهم ضامن لانتظام الحياة الدنيا، من خلال لأن هذه الفكرة تتحول إلى رقيب داخلي يجعل ضمير الإنسان صاحياً يقظاً على الدوام، لإنّ عيون الخلق إن أخطأته ونامت عنه فلم تره فعين الخالق لا يمكن أن تنام، في الحديث عن علي (ع): " اتقوا معاصي الله في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاكم" .8
وربما يقول بعض الناس: لم تفسدون علينا حياتنا بحديث الموت؟
ونقول لهؤلاء: لسنا نحن من يفسد عليكم حياتكم بل عدم تفهمكم للموت هو الذي يفسد عليكم حياتكم، أما نحن فلا نريد إلا مصلحتكم وراحتكم، ولا شك أن الإيمان بالحياة الأخرى بعد الموت هو الذي يصلح حياتكم ويمنحكم الإستقرار والإطمئنان النفسي والاجتماعي، ولهذا لما أخذ بعض الزنادقة أو الملاحدة يجادل الإمام الصادق (ع) في أمر المعاد والحياة بعد الموت مع أنّه آيات الله لا تعد ولا تحصى، فقال له الإمام (ع):" إن كان الأمر كما تقول وهو ليس كما تقول فقد نجونا ونجوت وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول، فقد نجونا وهلكت" 9. فنحن عشنا حياتنا وتنعمنا كما تنعمت، ولكن مع ميزة لنا عليك، وهي أننا عشنا حياتنا ونعيشها مرتاحي البال، لأننا مطمئنون بلقاء الله، أما أنت فإنك تعيشها وهاجس الموت يلاحقك ويؤرقك.
6- القناعة واليقين
وهذا لا يعني أن كل من هو مقتنع بالحياة بعد الموت فإنه يعيش آمنا مستقراً على المستوى الفردي والاجتماعي، فالمؤمنون يتفاوتون على هذا الصعيد تبعاً لتفاوت إيمانهم وتفاوت عملهم.
فالكثيرون مقتنعون بالحياة بعد الموت ولكنّ الأقلية هم من يوقنون بذلك، والفارق بين القناعة واليقين هي أن القناعة أمر نظري فكري بحت، بينما اليقين هو حالة اطمئنان قلبي، وهذا نظير ما حدث عنه الله تعالى في شأن نبيه وخليله إبراهيم (ع): { قال ربي أرني كيف تحيي المنوتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة 260]، ألا ترى أن معظمنا مقتنع بأن الإنسان بعد موته هو جسد لا يضر ولا ينفع، ولكنك لو طلبت من معظم الناس أن يناموا إلى جانب الميت فإنهم يرفضون ذلك، لماذا ؟ لأن القناعة الفكرية شيء والقناعة الوجدانية شيء آخر، وفي ضوء هذا فإن المؤمن يترسخ الإيمان بالآخرة في وجدانه فسيبقى يخاف الموت.
ولا يكفي رسوخ الإيمان بالحياة الآخرة ليمنح الأنسان الأمن والسلام الروحيين، بل لا بد أن يتبعه العمل والاستعداد لذاك اليوم، فعلى قدر استعدادك لذلك اليوم يهون عليك استقباله، وكلما عملت ليوم المعاد أكثر كلما سهل وهان عليك مواجهة الموت أكثر. وابتعد عنك هاجس لقائه أكثر، والعمل لليوم الآخر هو في الحقيقة ثمرة طبيعية لرسوخ الإيمان، فمن حسن إيمانه باليوم الآخر فإنه لا محالة سوف يستعد له ويتجهز.
ومن هنا تعرف السر في كون بعض أولياء الله تعالى يصل الأمر بأحدهم إلى حد أن يقول عندما يضرب بالسيف على رأسه: "فزت ورب الكعبة" 10، كما قال علي (ع) أو يقول: "إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً"11 كما قال الإمام الحسين (ع)، وما ذلك إلاّ لأنّ الإيمان بلقاء الله تعالى كان مسيطراً على عقل علي والحسين عليهما السلام، وعلى وجدانهما، ولأنهما استعدا لذاك اليوم.
والاستعداد لذاك اليوم يكون بالعمل الصالح والتقوى: {وتزودوا فإنّ خير الزاد التقوى} [البقرة 197]، وفي بعض المأثورات: "يا ابن آدم أكثر من الزاد فإنّ الطريق بعيد بعيد وخفف الحمل فإن الصراط دقيق".
من كلمة في مناسبة وفاة بعض المؤمنين، بتاريخ 13 /10/ 2013.
1-نهج البلاغة ج4 ص16.
2-الكافي ج3 ص 260
3-الكافي ج2 ص58.
4-نهج البلاغة ج4 ص42.
5-نهج البلاغة ج4 ص42.
6-الصحيفة السجادية، من دعائه في مكارم الأخلاق.
7-الكافي ج2 ص458.
8-نهج البلاغة ج4 ص77.
9-الكافي ج1 ص78.
10-مناقب آل أبي طالب ج1 ص385.
11-تاريخ الطبري ج4 ص305.