عاشوراء والعودة إلى الذات
الشيخ حسين الخشن
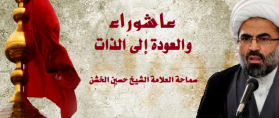
عاشوراء والعودة إلى الذات
إن واحداً من أشهر الشعارات التي رفعها الإمام الحسين (ع) عنواناً لنهضته وحركته هو ما عبّر عنه بقوله : " إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله .. " ، فقد كان (ع) لا يزال يرى أمامه أمة إسلامية وهو يرمي بنهضته إلى الإصلاح فيها أو إصلاحها ، أما عندما نحدّق نحن في واقعنا ، فإنّ السؤال الذي يطرحه البعض هو : هل أننا لا نزال أمة ؟ أم نحن أشلاء أمة ؟ هل نحن أمة واحدة أم أننا أمم غير متحدة ؟
1- الأمة وسؤال الهوية
سوف أتجاوز هذا السؤال اليائس لأقرّ بأننا لا نزال أمة ، لكن أي أمة ؟ بنظرة سريعة على حال أمتنا ماذا نجد ؟ وماذا نرى؟ هل يختلف إثنان أنّنا في حالة يرثى لها بحيث إنّه وأينما امتدت بنا الباصرة أو انطلقت المخيلة فسوف نرى أمة حائرة تائهة متشتتة قد أضاعت بوصلتها الأساسية ، أمة - كما أرى وترون - متناحرة متمزقة تفتك بها الصراعات المذهبية والعرقيّة والحزبية ، أمة مسلوبة الإرادة يعمل الآخرون على مصادرة عقولها وطاقاتها وثرواتها وإذكاء نار الفتنة في كل ساحاتها وواقعها ؟
وفي ظل هذه الواقع ، فإنّ الأسئلة تتزاحم علينا ، والسؤال الأبرز: لماذا نحن على هذه الحالة من التخلف الحضاري والتردي الفكري والانحطاط الأخلاقي والتشظي الاجتماعي؟ أكتب علينا ذلك الذل والهوان ؟ على طريقة ذلك الشاعر :
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها
وكما ألمحنا فإنّ البعض في أسئلته يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يصل به الأمر إلى أن يطرح سؤال الهوية: من نحن ؟ هل نحن أمة ؟ وأي أمة نحن ؟ وما الذي يجمعنا ؟ وهذا السؤال وغيره أخذ يفرض نفسه على الكثيرين ممن لا يمكننا تخوينهم ورميهم بالعمالة والتغرّب ؟ فقد أخذوا يتساءلون همساً أو علنا : من نحن ؟ ولماذا هذه حالنا يا ترى ؟ ألم يأن لنا أن نصحو من هذا السبات العميق ؟ وكيف نصحو وهناك من القيود والأغلال ما يمنع الصحوة ويعرقل الحركة سواء كانت قيودا ًداخلية أو خارجية ؟ وما السبيل إلى ذلك ؟.
2- فقد الثقة بالذات
في البدء دعوني ألفت الأنظار إلى أنني - وبالرغم من هذه الصورة السوداوية - لست متشائماً ولا يائساً من إمكانية التغيير والإصلاح ، فأنا لا أغفل وجود علامات مضيئة وتجارب مشرقة معاصرة في هذه الأمة ، ويمكن الانطلاق منها والبناء عليها لغد أفضل ، ولكنني أتحدث عن المسار العام للأمة، أتحدث عن المليار ونصف المليار مسلم الذين "لا ريح" لهم ، وفقاً للمصطلح القرآني ، { ولا تنازعو فتفشلوا وتذهب ريحكم} .
وانطلاقاً من عاشوراء دعونا نفكّر في حال أمتنا ، فهل نعثر على إجابة لتلك الأسئلة في مدرسة عاشوراء ؟ وهل ثمّة قاسم مشترك بين واقعنا وبين تلك المرحلة التي ثار فيها الحسين(ع) ؟
بالتأكيد هناك أكثر من عنصر مشترك بين مرحلتنا الزمانية وبين تلك المرحلة ، وبين واقعنا وذاك الواقع ، لأنّ أمراض الأمم والشعوب – وبخلاف أمراض الفرد الجسدية التي تختلف من شخص لآخر وقد تستجد أمراض لم تكن معهودة في الزمن السابق- هي في الأعم متقاربة ومتشابهة ، وذات مناشىئ معروفة ومتجانسة .
ومن أبرز وأخطر هذه الأمراض التي تفتك بالأمم مرض فقد الثقة بالنفس ، بحيث تعيش الشخصية الإنسانية الاهتزاز وعدم التوازن ، والثقة بالنفس هي الحصن المنيع لسلامة الفرد وحماية الأمة ، وكما أنّ جسد المرء إذا فقد مناعته فإنّه يصبح عرضة لهجوم "الفيروسات" الإنتهازية الكامنة وغزو الجراثيم المسمّة ، كذلك هو حال الأمة إذا فقدت ثقتها بنفسها فإنها ستفقد مناعتها وحصنها الحصين وتصبح عرضة للغزو الثقافي أو غزو العقول والإرادات .
3- مخاطر فقد الثقة بالذات وأعراضه
ومجدداً تتزاحم الأسئلة : كيف تفقد الأمة ثقتها بذاتها ؟ وكيف تصل الأمة إلى هذا المستوى المرضي ؟ وقبل ذلك ما هي مخاطر هذا المرض وما هي أعراضه ؟ دعوني في هذه العجالة أركز النظر على السؤال الأخير، فأقول : إنّ مخاطر هذا المرض وأعراضه هي التالية :
1- الإزداوجية بين المشاعر والمواقف ، وانفصام الشخصية بين ما يعلم وما يعمل ، { لم تقولون ما لا تعلمون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون } ، وقد قالها الفرزدق عندما التقاه الحسين(ع) في الطريق وسأله عن حال الناس خلفه فأجابه: " قلوبهم معك وسيوفهم عليك " . ونموذج ابن سعد بين أيدينا ، فهو خير مثال على الشخصية التي تعيش الإزدواجية المذكورة ، وهذا ما يعبر عنه الشعر المنسوب إليه :
أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوماً بقتل حسين
2- الشلل التام وضعف الإرادة ، على سبيل المثال : لو أننا أخذنا - مثلاً – من تاريخ الثورة الحسينية ، وتساءلنا عما جرى مع مسلم بن عقيل ، حيث اجتمع عليه وبايعه الألوف من أهالي الكوفة ، ثم بين ليلة وضحاها تبددت عنه تلك الجموع ليجد مسلم نفسه وحيداَ فريداً على باب تلك المرأة الصالحة " طوعة " ، فما الذي جرى يا ترى ؟ ما جرى باختصار أنّ الشخصيّة الكوفيّة أنذاك قد غدت شخصيّة ضعيفة حائرة خائفة تتجاذبها المشاعر والمصالح يميناً وشمالا .
3- الخوف من المواجهة الفكرية وعدم الاستعداد للإستماع إلى الآخرين ، ولذا فهو يتهرب من الحوار والمحاججة، وإذا أجاب فإن جوابه يكون: { قلوبنا غلف } ، فالإنسان الذي يمتلك ثقة بنفسه لا يهرب من الحوار ولا النقاش ولا يخيفه ذلك ، أمّا الإنسان الضعيف في حجّته ، فالهروب من المواجهة هو أسلم الطرق بالنسبة إليه ، والتشويش والتعمية هي أفضل خياراته ، كما حدثنا القرآن الكريم عن بعض المشركين: { لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه } ، ويصل الأمر إلى حد أن يسدّ الإنسان أذنيه عن الاستماع إلى دعوة الحق ، كما فعل الأسعد بن زرارة ، الذي دخل مكة وكان محرماً وخوّفه بعض عتاة المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام حتى لا يسحره محمد (ص) بكلماته ، سأله زرارة : ما الحلّ إذن وأنا محرم وأريد الطواف ؟ قال له ذلك القرشي : الحل أن تضع في أذنيك القطن وتذهب للطواف فلا تسمع شيئاً من كلامه ، وهكذا كان .. إنّ سياسة وضع القطن في الأذنين لا تزال قائمة إلى الآن ، وقد قيلت في وجه الإمام الحسين(ع): " لا نفقه ما تقول يا بن فاطمة"
4- انهيار منظومة القيم ، فعندما يقف الإمام الحسين (ع) يوم عاشوراء قائلاً : " إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونو أحراراً في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون.. " ، فهذا الكلام الذي يحاول فيه الإمام أن يستصرخ الضمير الإنساني فيهم عماذا يكشف ؟ إنه يكشف عن انهيار منظومة القيم والأخلاق والتي هي خط الدفاع الأخير ، والذي بانهياره تسقط وتنهار إنسانية الإنسان .
5- هدر الطاقات والعقول : إنّ النتيجة الطبيعية لفقد الثقة بالذات هو هدر الطاقات والعقول والكفاءات والمقدرات .
4- ما هو السبيل للخروج من المشكلة ؟
أولاً : العودة إلى الذات
أعتقد أن كل هذه الأسئلة المتقدمة مشروعة ، وهي بداية طبيعية لعلاج المشكلة ، فالتفكير بذلك يعبّر عن إدراكنا للمشكلة ، وإحساسنا بها ، لأنّ أخطر الأمراض وأشدها فتكاً هي تلك الأمراض التي لا يعيها الإنسان ولا يحس بها إلاّ بعد فوات الأوان ، { قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا }
ولهذا فالمدخل الضروري والمهم في عمليّة النهوض يتمثل بـ" العودة إلى الذات " ، والعودة إلى الذات عنوان صغير في حروفه كبير في مضمونه ، والذي أعتقده أنّه لن يتسنى لأمتنا أن صحو أو تستفيق من كبوتها ونخرج من هذا النفق المظلم الذي دخلته منذ قرون إلاّ بالعودة إلى الذات ، فماذا نعني بالعودة إلى الذات ؟ وكيف نجسد ذلك ؟
ثانياً: المراجعة النقدية
إنّ العودة إلى الذات تفرض علينا قبل كل شيء أن نحدد هذه الذات فمن نحن ؟ فكرياً وحضارياً ، ما هي علاقتنا بالآخر ونظرتنا إليه ؟ وكيف نبني هذه العلاقة مع أنفسنا ومع غيرنا ؟
وهذا يفرض علينا القيام بوقفة مطولة مع الذات ، وقفة مراجعة مع أنفسنا لمساءلتها ومحاسبتها ، ولا أقصد بالمحاسبة هنا أو المساءلة هنا المساءلة الفردية ، مع أنّ محاسبة ومساءلة أنفسنا كأفراد ضرورية ومهمة ، فلنسأل أنفسنا : كأفراد نحن من أين وإلى أين وفي أين ؟ ، بيد أننا نتحدث هنا عن الأمة ككيان ولها شخصيته المستقلة عن شخصية الفرد ، هذه الأمة مدعوة بنخبها بأهل الوعي والبصيرة فيها وبكل أفرادها من الفلاح إلى العامل إلى التاجر إلى الطبيب والمهندس .. إلى القيام بمراجعة نقدية مع الذات ، فلتُطرح الأسئلة الجريئة ، وأول تلك الأسئلة هو سؤال الذات والهوية فأي ذات نحن ؟ وماذا نريد ؟ وإلى ماذا نتطلع ونطمح ؟ ما موقفنا من التاريخ وكيف نستعيده ؟ فلنسأل أنفسنا كأمة أين كنا وأين أصبحنا ؟ ولماذا ؟ ما هي مكامن الخلل فينا ؟ هل الخلل فينا أم في فكرنا وديننا ؟ أم في تلقينا لهذا الفكر؟ أم الخلل في إرادتنا ؟ لماذا يتحول الإنسان المسلم إلى شخصية دموية وحشية بكل معنى الكلمة ؟ لماذا تمزقنا شيعاً وأحزاباً ولم نجد سبيلاً إلى الآن نلجأ إليه في إدارة الاختلاف أو تنظيمه ؟ إنّ انتماءنا للإسلام يحتم علينا أن نطرح هذه الأسئلة وأن يساهم كل واحد منا في إيجادج الحلول والإجابات عليها .
وإنّ منطق السنن التاريخية يعلمنا ويؤكد لنا بما لا مجال للبس فيه بأنّ هذه الوقفة والمراجعة مع أنها تحتاج إلى معاناة وكبد ومجاهدة وتحتاج إلى الكثير من التضحيات والشهداء ، أقصد شهداء الوعي الذين سوف يغتالهم الجهل بسهام التضليل والتكفير ، لكنها هي الأمل لأنها تمثل شرطاً أساسياً لاستفاقة الأمة ونهوضها، والمتأمل في تاريخ الأمم والشعوب التي استطاعت أن تحجز لها مكانة في سجلات التاريخ الذهبية لا يخالجه أدنى شك في أن الخطوة الأولى في نهوضها كانت في العودة إلى الذات .
ويقيني أنّ الخلاصة التي سوف توصلنا إليها هذه المراجعة هي أنّ الدين في نصوصه ومفاهيمه وقيمه - وبعد استبعاد نظرية المؤامرة - ليس سبباً لمآسينا وتخلفنا وتمزقنا .
أي دين ترك الناس طريقاً وطريقاً وأحال المنهج اللاحب سبعين فريقاً
فالمشكلة ليست في الدين بل في فهمنا له وفي كيفية تلقينا له ، هذا الدين الذي يحمل عنوان { وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين } لا يمكن أن يكون نقمة .
ثالثاً: التاريخ قاعدة انطلاق نحو المستقبل
وقد يتخيل البعض أننا عندما نطرح شعار العودة إلى الذات فإننا نريد للحياة أن تعود للوراء ، لتعيش في كهوف الماضي وزنازينه أو على زهوه ونشوة انتصاراته وأننا نريد أن نتشبث بتراثنا بغثه وسمينه ، مع أنّ هذا الماضي قد يكون جزءاً من تخلفنا .
ولكننا نعتقد أنّ العودة إلى الذات لا تعني الانسلاخ عن عصرنا لنعيش في غيابات الماضي ، ولكنها لا تعني حتماً أن ننسلخ من هويتنا وثقافتنا وننزع لبوسنا، فلا استنساخ تجربة الآخرين ومحاكاتهم كما يستهوي بعض المستغربين هي الحل الصحيح، ولا استنساخ تجربة ماضينا المنصرم كما يريد بعض الماضويين منا هي الحلّ ، فلا بد أن نتوازن، ففي الوقت الذي لا يحق لنا أن ننقطع عن عصرنا ومنجزاته لا يجوز لنا أن ننقطع عن تاريخنا ومحطاته المشرقة ، إنّ أمة بلا تاريخ هي أمة بلا هوية وبلا حاضر وبلا مستقبل .
المطلوب إذن أن نبني على هذا التاريخ لا أن نسكن فيه ، وأن نعيد قراءته لا أن نقدسه ونتجمد فيه ، أن نبني عليه للانطلاق إلى المستقبل ، وأن نفكك بين ثابته ومتحركه ، وأن نميز صفوه من كدره وأن لا نحلط بين ما هو مقدس وما هو نسبي ، لأننا - مع الأسف - أضفينا هالة من القداسة على هذا التاريخ بكل مفاصله ورموزه ، حتى أضحينا مسكونين فيه كما هو مسكون فينا ، وهكذا أصبح الكثيرون منا يعيشون على الأطلال فلا مشروع لهم ولا انجازات سوى التغنى بذكرى الأجداد ، دون أن نعمل على استعادة تلك الأمجاد أو تثمير تلك الانتصارات .
رابعاً: الثقة بالذات
إنّ العودة إلى الذات لا بد أن تتحرك على قاعدة الثقة بالذات ، فهذا الواقع المشرذم والمأزوم لا ينبغي أن يبعث فينا حالة من اليأس أو يدفعنا إلى الإحباط ، ومشكلة البعض منا أنه يريد القيام بمراجعة نقدية لتاريخه وتراثه تحت وطأة الانهزام النفسي والمعنوي ومن منطلق الشعور بالدونية ، ولهذا شرقوا وغربوا .
إنّ بداية انهيار الأمم وتقهقرها هي بداية فقدها ثقتها بذاتها ، فالأمم الرائدة والتي يكتب لها البقاء هي التي لا تخجل بانتمائها ولا تنسى أو تتناسى انتصاراتها ، إنّ البعض يريدنا أن نكون بلا ذاكرة لينسينا انتصاراتنا ويزيل من قاموسنا ذكرى التحرير، إنّ هؤلاء الذين يخجلون من حاضرهم المشرق أو يتناسون هذا الحاضر يسعون أن تبقى هذه الأمة على الهامش .
ولذا نجد أنّ الزيارة المعروفة للإمام الحسين(ع) تستحضر هذا الامتداد التاريخي للإمام، " السلام عليك يا وراث آدم صفوة الله السلام عليك يا وراث نوح نبي الله السلام عليك السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله السلام عليك يا وراث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله.. " ، فالإمام الحسين (ع) فهو ليس شخصية طارئة ، إنه خط ممتد وراسخ في أعماق التاريخ .
وفي ضوء ذلك فإنّ الخطاب التغييري لا بد أن يبتعد عن ممارسة النقد على طريقة جلد الذات التي لا تبقي بارقة أمل لدى أبناء الأمة ، وتهدم دون أن تقدم البدائل، فهذا الخطاب ليس موفقاً بل إنه سيزيد الأمة وهناً على وهن ، وسيفاقم مشكلة الثقة بالذات ويزيدها استفحالاً ، وهذه النقطة تشكل مرتكزاً في عملية استنهاض الأمة ، وثمة مرتكزات أخرى نتناولها في الفقرة التالية :
5- أسس ومنطلقات العودة إلى الذات
وعملية إعادة الثقة بالذات أو في عملية بناء الذات التي أصابها الضياع وتحكم بها ضعف الإرادة وتذبذب المواقف وازدواجيتها ليست مسألة بسيطة أو سهلة إنما تحتاج جهود جبارة وعمل دؤوب وكفاءات استثنائية ، والذي أراه وأعتقده أنّ هذه المهمة تحتاج إلى شخصيتين قياديتين : شخصيّة ثاثر وشخصية مفكر ومصلح ، وحاجتنا إلى شخصية الثائر تنبع من حاجة الأمة التي فقدت ثقتها بذاتها إلى صدمة عاطفية تهز الوجدان والمشاعر ، وتوقظ الوعي الذي دخل في سبات عميق، إنّ هذه الصدمة ضرورية ولا يستغنى عنها، لأنّ الأمة عندما تفقد ثقتها بذاتها فلن تنفعها المواعظ والتنظيرات الفكرية إن لم تترافق مع هزة وجدانية ، لأنّ الأفراد قد يعرفون الحق ولكنهم لضعف إرادتهم وتعلقهم بالمصالح الدنيوية والمؤقتة لا يتبعون الحق ، بل ربما حاربوه وعاندوه .
وكانت الصدمة التي أيقظت الأمة الإسلامية أنذاك هي أن يقدّم الحسين(ع) نفسه وعياله شهيداً على مذبح الحرية ، ليشكّل هذا الحدث بما يتضمنه من عناصر مأساوية دامية منقطعة النظيرأكبر هزة لضمائر المسلمين الذين راعهم ما حدث ، وسيطرت عليهم حالة الندم والإحساس بالتقصير والشعور بالذنب ، ومن هنا انطلقت حركات تحمل عناوين دالة ومعبرة عن الجرح العميق الذي حفره استشهاد الحسين(ع) في نفوس المسلمين كحركة التوابين مثلاً .
ولكن العملية الثورية هذه إن لم تترافق مع عملية إصلاحية لن تؤدي غرضها المنشود ، وهنا يأتي دور المصلح والمفكر ليقوم بتصحيح الانحراف الفكري وتقويمه ، بعد أن يقوم الثائر قد هيأ النفوس لتتلقى عملية الإصلاح وتقبلها .
وخلاصة القول : إنّ الأمة لتستفيق من كبوتها وتستعيد ثقتها بذاتها تحتاج إلى مفكر وثائر ، فالمفكر المصلح يعمل على الاجتهاد في النصوص والثائر يجتهد ويجهد في إيقاظ النفوس ، المصلح يعمل على تحريك عجلة الدين التي أصابها التكلس، بينما يعمل الثائر على تحريك نبض الأمة التي أصابها الشلل ، وظيفة المصلح أو المفكر أن يفك القيود عن عقل الإنسان ، بينما وظيفة الثائر أن يحرر الأمة من قيود الظلم والعدوان ، وربما اجتمعت شخصيتا الثائر والمصلح في شخص واحد ، كما حصل مع الإمام الحسين (ع) ، الذي كان المصلح والثائر في الآن عينه ، وقد تتعدد الشخصيتان ، وهنا لا بد أن يكمّل أحدهما دور الآخر .
وربما لا تكون القراءة التالية بعيدة عن الصواب ، وهي القراءة التي ترى أن الأمة الإسلامية في زمن الإمام الحسين (ع) لم تكن لتكفيها مواعظ المصلحين وتنظيراتهم الفكرية ، بل إنها تحتاج – بالإضافة إلى ذلك – إلى هزة وجدانية تستفيق لها الأمة، لأن مرض الأمة الأبرز هو مرض الوهن وضعف الإرادة والركون إلى الدنيا: " الناس عبيد الدنيا والدين لعقٌ على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا مُحصوا بالبلاء قلّ الديانون " .
ولكن ملاحظتنا على هذه القراءة هي أن العملية الثورية لا يمكن أن تصل إلى غايتها المنشودة إن لم يعقبها عملية إصلاحية تعمل على تصحيح الإنحراف الفكري والتشوه المفاهيمي الذي أصاب عقل الأمة ، ومن أولى بهذه العمليه التصحيحية التغييرية من الثائر نفسه ، والذي سيمنحه إخلاصه وتضحياته مشروعية غير اعتيادية .
وعلينا أن نعي جيداً أن المهمتين الثورية والإصلاحية لهما شروطهما وضوابطهما ، ولا يمكن أن يحصل التغيير خارج تلك الشروط، وإليك توضيح ذلك باختصار :
أولاً: أسس الممارسة الثورية
العمل الثوري لا يمكن أن يكتب له النجاح إلاّ إذا توفرت فيه جملة من العناصر والمرتكزات وأهمها :
1- شخصية الثائر وكفاءته وأهليته .
2- مشروعه الثوري والتغييري .
3- ممارسة الثورية ، التي تلزم الأخلاقية الثورية .
مع توفر هذه العناصر يمكن للممارسة الثورية أن تكون فاعلة ومؤثرة ، ويكتب لها النجاح ، وإن لم تؤثر في الزمن الحاضر فسوف تؤثر في المستقبل وتتحول إلى مثل يحتذى ومدرسة ترتادها الأجيال ، تماماً كما هو الحال في مدرسة الإمام الحسين (ع) .
ثانياً: ضوابط العمليّة الإصلاحيّة
والعملية الإصلاحيّة التي يرجى أن يكتب لها النجاح لا بد أن تراعي جملة من الضوابط :
أولاً: تحكيم العقل كقاعدة أساسية للفكر والسلوك ، وكركيزة صلبة للإيمان والتطور والإبداع ، لقد أعاد الإسلام إلى العقل مكانته ، وأزال كل العوائق التي تعيق حركة العقل فحرّم الشعوذة والسحر والكهانة ، وقد قالها رسول الله (ص) عندما يسمع الناس يقولون كسفت الشمس حزنا ًعلى إبراهيم .. لقد وعى أسلافنا قيمة العقل وقرأوا النص بالعقل فتقدّموا ، ولكن بعض الخلف جمّدوا العقل وحاصرواه بالنص فتخلفوا ، هَلاّ تأمّلنا كم مرة وردت كلمة " العقل " و" الفكر " ومشتقاتهما في القرآن الكريم ؟
نعم لقد جعل المسلمون الأوائل العلم فريضة وكان النبي (ص) يفكّ أسرى المشركين لمجرد أن يعلّم الواحد منهم عشرة من المسلمين ، أمّا الآن فنحن أجهل الأمم ، نحن أمة إقرأ ولا نقرأ ، تقول الاحصاءات لهذا العام ( 2013م) أنّ 80% من طلاب " البرويفه " رسبوا في اللغة العربية !
ولا بد أن نحرر العقل من القيود والمكبلات ، ونحن أمة تقدّس العقل وتفاخر بذلك وتجلّه وتكن له كل تقدير واحترام ولكننا نتركه في الأعالي ولا نسمح له بالنزول إلى الخطوط التشريعية العامة والتفصيلية بحجة أنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، مع أنّ الوارد في الحديث : إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ، لتتم المراجعة بعيداً عن الضوضاء والصخب ، ومؤثرات العقل الجمعي ، قال تعالى: { إنّما أعِظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنّة } .
أليست كارثة أن ترى أنّ المرأة قد وصلت إلى القمر وأنّ بعضنا لا يزال يمنعها من قيادة السيارة ؟ ولعلّي أخطأت في هذا المثال لأنّه الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة قد لا يوافق على أنّ الإنسان وصل إلى القمر !!
ثانياً : أن نعمل على تفعيل الثقافة النقدية ، ثقافة الاختلاف ، والرأي والرأي الآخر ، ثقافة { إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين } ، لقد قالها رسول الله وهو المعصوم " أشيروا علي أيها الناس " ، ليعلمنا منهجاً في التفكير وهو التفكر النقدي ، لننقد الحاكم عندما يخطئ ، فالحاكم ليس ظل الله على الأرض ، هو إنسان ووكيل عن الناس وإذا أخطأ فعلى الأمة أن تقوّمه ، لقد كانت المرأة المسلمة – التي لا يزال البعض يناقش في حقها في قيادة السيارة أو السفر بدون محرم - تخرج لتقطع المسافات الطويلة لتحاجج الحاكم ، فهذه سويدة الهمدانية تخرج من الكوفة إلى الشام وتقف أمام معاوية وتشكو ظلامتها .
ثالثاً : ومن هذه الأسس المهمة لبناء الذات والعودة الفاعلة والمؤثرة في ميدان الحياة الإنسانية أن نبني علاقاتنا الاجتماعية والإنسانية على أساس متين وجامع يوحد ولا يفرق أساس يصهر في داخله كل التنوعات الإنسانية ، وهذا الأساس الجامع هو مبدأ الأخوة الإنسانية ، والذي يترجم عملياً بأنّ الناس كلهم أخوة وأنّ المواطنية تجمعهم تحت سقف واحد ، مع غض النظر عن ألوانهم ومذاهبهم وأديانهم ، أن لا أرتاح لمصطلح " الشراكة " المتداول في قاموس السياسيين في لبنان ، الإسلام يطرح مصطلح الأخوة أخوة في الدين أو أخوة في الإنسانية ، الأخوة ليست شعاراً أو شعراً أو تعويذة هي منظومة من الحقوق والواجبات فالإنسان أخو الإنسان فعليه أن لا يخذله ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يغتابه ، لقد تسامى علي (ع) إلى حد أنه كان يقول لأعدائه وخصومه بأنهم أخوانه ، فلما سئل عن الخوارج ماذا نقول عنهم .. كان يقول: " إخوان لنا بغوا علينا " .
وفي حديث آخر عنه (ع) : كان يقول لأهل حربه: " إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ، ولكنا رأينا أنّا على حق، ورأوا أنهم على حق " [1] .
ماذا يعني ذلك ؟ إنّه يعني :
1- إنّ علينا أن ندير اختلافاتنا وتنوعاتنا بالحوار لا بالسيف .
2- وأن التكفير لا يواجه بتكفير مضاد ، بل بمنهج فكري يفكك البنى التحتية للتكفير ويعريه شرعياً .
ولا يعني هذا أبداً أن لا تدافع عن نفسك عندما يهجم عليك إنسان تكفيري يريد القضاء عليك وعلى كيانك ولكن الدفاع ليس حلاً للمعضلة .
هذا هو منطق الحسين (ع) ورسالته ، ولهذا لما دخلت زينب (ع) على يزيد وتطاول بعض رواد مجلسه طالبا ًمنه أن يعطيه بنتاً من بنات الحسين (ع) كأمة له ، وقفت شبلة علي (ع) لتقول له : كلا، هذه لا تكون لك ولا لأميرك ، قال يزيد : لو شئت لفعلت ، أجابته زينب : " إلاّ أن تخرج من ملتنا " .