قراءة في كتاب .. العقل التكفيري - قراءة في المنهج الإقصائي
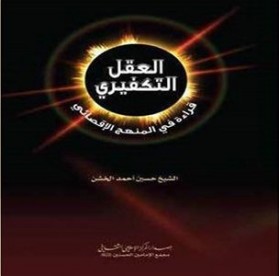
قراءة في كتاب العقل التكفيري
في زمن استفحال ظاهرة العنف الفكري والدموي، وفي مجتمع إسلامي باتت تمزّقه العصبيات، وتتلاعب به الأحقاد ورفضُ الآخر الذي لا يشبهنا، وفي حاضرٍ تتكاثر فيه فتاوى القتل والتمثيل بمن أخرجته عقولُنا المتحجّرة من الدين، يأتي سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن وبجرأته العلمية المعهودة، ليضع إصبع الدين والتسامح على جرح التكفير والجهل، وليضيء لنا ما أظلم علينا في غياهب وكهوف التعصّب... فيقول في مقدمة الكتاب " في ظل هذه الفتنة يكون لزاماً على أهل البصيرة والوعي من علماء الأمة ومفكّريها أن يقفوا ملياً أمام هذه الظاهرة ويتداعوا لدرس مخاطرها، ويستنفروا كافة طاقاتهم وجهودهم الفكرية لمعرفة أسباب انتشارها وسبل معالجتها، وليتفكّروا في مناشىء التكفير ودواعيه، ومنابع الفكر التكفيري، وضوابط حماية المجتمع الإسلامي من فتنته وشره"...
في بداية الكتاب يستعرض الشيخ الخشن نشوء ظاهرة التكفير في الإسلام والتي حدثت في زمن الإمام علي (ع)، وبالتحديد مع الخوارج الذين كفروه وأباحوا قتله وقتل كل من خالفهم الرأي... ولو أنّ الإمام علياً (ع) حاورهم في بداية الأمر ورفض تكفيرهم أو إخراجهم من الإسلام... ولم يحاربهم إلا عندما تلطخت أيديهم بدماء المسلمين، وعاثوا فساداً في الأمّة...
وفي الفصل الأول يعمد سماحته إلى تحديد المعايير التي تحدد من هو المسلم، وكيف يدخل الإنسان في الإسلام، وما هي شروط هذا الإسلام الذي يخرجه عن الكفر. ويفصل الكلام عن الأصول التي يعتمدها كل مذهب وفئة لما تعتقده... ويخلص إلى القول بأن الإسلام هو الشهادتان، ويستعرض أراء الفقهاء في ذلك وفي ما يرونه مُخرِجاً للإنسان من الإسلام..
ويطرح بعدها سؤالاً هل أن الإسلام مرتبة واحدة أم مراتب متعددة، وكذلك الإيمان والكفر أيضاً، فيخلص إلى القول بالتعددية في المراتب في الإسلام والإيمان والكفر، " إنّ الذي يستفاد من القرآن الكريم والسُّنة الشريفة أنّ هناك مرتبتين أساسيتين يندرج المسلمون في نطاقهما، وهما: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، ولا يخفى على المطلع على النصوص والآثار الإسلامية أنّ ثمة فارقاً جوهرياً وشاسعاً بين الإسلام والإيمان، فالإيمان يعبر عن تجذر العقيدة في القلب وتجسيد أحكام الشريعة من خلال السلوك والعمل، أمّا الإسلام، فيكتفى فيه – بلحاظ أدنى مراتبه - بالانتماء الظاهري والرسمي إلى الدين والمتمثِّل بالشهادتين ولو لم يتجذر في القلب ولم يُصدِّقْه العمل، وعليه يكون الإيمان أخص من الإسلام، فليس كلّ مسلم مؤمناً وإن كان كل مؤمن مسلماً"...
ثم يطرح سماحة الشيخ سؤالين جوهريين يحكمان علاقتنا بالآخرين، وكيف يجب أن نتعامل معهم، هل إنّ كل من ليس مسلماً كافراً؟ وهل كل كافر في النار؟!
ويجيب عن السؤال الأول: "والرأي الذي نرجّحه ونراه أقرب إلى الصواب هو الرأي القائل إنّ ثمة حالة وسطى بين الإسلام والكفر، أي إن النسبة بينهما ليست نسبة الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما هي نسبة الضدين اللذين لهما ثالث، كما هو الحال في السواد والبياض فإنّ لها ضداً ثالثاً، وهو الخضرة مثلاً، وقد اعترف بهذا الأمر – أعني ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر- الفقيه الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، مدعياً دلالة الأخبار المستفيضة على ذلك"...
ويستعرض مسألة الشك التي تعتري الإنسان الباحث عن الحقيقة والتفتيش عن العقيدة الحقة لا يتنافى مع الإيمان، بل إنّه قد يقود إليه في الأعم الأغلب، والشاك في هذا الطريق لا يحكم بكفره ولا تترتّب عليه آثار الكفر.
ويجيب على السؤال الثاني: الجنة والنار بيد الله , فليس كلّ كافر يعذّب بالنار كما أنّه لا يتحتّم أن يكون كلُّ مسلم من أهل الجنّة، وينبغي ترك أمر الجنّة والنار لله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحتّم على الله شيئاً، فلو أنّ ظاهر المرء كان حَسَناً بالنسبة لنا، فإنَّ ذلك لا يبرّر القطع بأنّه من أهل الجنّة، لأنّ الله تعالى أعلم به منّا، وهو المطّلع على السرائر وما يكون قد خفي عنّا...
ثم ينتقل في الفصل الثاني ليتحدث عن المفردة الأهم وهي "أصالة احترام النفس الإنسانية"، وما ينتج عنها من أحكام على ضوء اعتبار الأصل الاحترام للنفس الإنسانية أم لا. ويعرض لاختلاف آراء الفقهاء، ويخلص للقول إنّ: "الإنسان بشكل مطلق وبصرف النظر عن دينه محترم النفس والعرض والمال بلحاظ عالم الدنيا وقوانينها، ما لم يهدر هو احترامه بارتكاب ما يوجب سقوط حرمته"... ويعرض للاختلاف في الحكم على الكافر وقتاله، وهل أن سبب قتاله هو كفره أم حرابته للمسلمين، ويناقش الآراء التي تجعل من مجرد الكفر سبباً للقتال، دون الاكتراث إن كان هذا الشخص مسالماً وغير معادٍ للمسلمين، ويخلص إلى أن الحرابة تتوقف فقط على حرابة الكافر للمسلمين لا مجرد كونه كافراً، مستدلاً على ذلك بالعديد من الآيات والأحاديث الصحيحة... مؤكداً على تشديد الإسلام على التعايش مع الآخرين وعدم الانغلاق...
وفي الفصل الثالث يتحدث سماحة الشيخ الخشن عن مناشئ التكفير ودوافعه، وما هي مسبباته: " تفسيرنا وتحليلنا لظاهرة التكفير ودراستنا لأسبابها ومنطلقاتها لا نستطيع إرجاعها إلى عامل واحد، لأننا أمام ظاهرة دينيّة اجتماعية، أو ظاهرة دينيّة ذات بعد اجتماعي، ومن الخطأ تفسير الظواهر الاجتماعية على أساس نظرية العامل الواحد، فهناك أسباب مختلفة ودوافع شتى ومتداخلة تساهم في بناء الشخصية التكفيرية، ويتشابك فيها العامل النفسي مع الاجتماعي مع الاقتصادي مع السياسي مع الديني، وتداخل هذه الأسباب يفرز شخصيات تكفيرية صدامية،وليس من الصحيح إرجاع هذه الظاهرة إلى سبب بعينه، لأنّ في ذلك مجافاة للحقيقة والواقع"...
فيدعو إلى تنقية التراث الإسلامي من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والتي يتّخذها التكفيريون درعاً يتحصنون به أو مبرراً لأفعالهم. وكذلك العمل على فضح الجهلة الذين يعتبرون أحد أخطر الأسباب المشوهة للدين، " الحذر كل الحذر من الجهلة المتنسكين، الذين ينطقون باسم الدين ويحتكرونه لأنفسهم ويتصرّفون كأنّهم أوصياء عليه، فإنّهم يسيئون أكثر مما يحسنون، وربّما أساؤا من حيث يريدون الإحسان والخير... إنّ الجهل بأبعاد الدين ومقاصده مدّعاة إلى الانغلاق، والانغلاق مدّعاة إلى الصدام والتكفير، ومن جوامع كلمات عليّ (ع) في هذا الشأن قوله فيما روي عنه: "لا ترى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرِّطاً..."
ثم ينتقل في الفصل الرابع للحديث عن خصائص الشخصية التكفيرية، وما يحمله التكفيري من صفات تفكير يؤدي به إلى ما وصل إليه، كالاستعلاء والغرور الديني وسرعة انفعاله وتفلّته من عقال العقل والسير خلف ما يعتبره ثوابت ومسلماتٍ لا تقبل النقاش، فهو المعصوم وكل من يعانده خارج عن الدين... وهذا ما يقوده إلى العنف شيئاً فشيئاً تجاه الآخرين، وهذا ما يتعارض من الرفق في الإسلام والتسامح الذي يميزه ويُعلي من مكانته في نفوس الآخرين...
وفي الفصل الخامس يتحدث سماحته عن مفهوم الابتداع في الدين ورمي كلِّ فئة للأخرى بهذه الآفة لإخراجها من الإسلام والدين كله، " إن واحدة من أخطر أسلحة التراشق الداخلي التي يستخدمها المسلمون في وجه بعضهم البعض، رمي الآخر بالابتداع في الدين، الأمر الذي يستتبع إخراجه من الدائرة الإيمانية والحكم عليه بأنّه من أهل النار ومعاقبته بما يضع حداً لبدعته"... وما ينتج عن ذلك من احتكار كل فئة للهداية دون الآخرين... ويتحدث بعدها عن الاختلاف بين فقهاء الشيعة في الأصول والفروع، وكيف كان التلميذ يخالف أستاذه في أكثر من مائة مسألة عقائدية ولا أحد يخرج الآخر من التشيّع أو ينعته بالضلال.
ولظاهرة السباب واللعن بحث مفصل ضمن هذا الفصل، عن مسبباته وانتشاره في المجتمع الإسلامي، وما هي مساوئه وآفاته وكيفية معالجته، وما يجب على المؤمن العمل في هذه الحالة.
وفي الفصل السادس والأخير يطرح سماحة الشيخ الخشن مسألة الخطاب الديني بين المسلمين والتكفيريين، وعن الفوضى في تبني واحتكار الكلام باسم الدين، " إلاّ أنّ واقع الأُمة مغاير لذلك تماماً، حيث نشهد فوضوية شاملة في هذا المجال، فالكل يتكلم باسم الدين، سواءً من كان أهلاً لذلك أو من ليس أهلاً له، وهكذا يكثر المفتون والناطقون باسم الإسلام، وأخطر ما نواجهه في هذا المجال تصدي جماعة من المراهقين في العلوم الإسلامية لاسيّما من ذوي النزعات التكفيرية للإفتاء في صغار الأمور وكبارها، فتراهم يُحلّلون ويُحرّمون ويكفّرون ويضلّلون ويهدرون دماء الأعداء والأصدقاء، المجرمين والأبرياء متجاوزين بذلك أكابر الفقهاء وذوي الحلّ والعقد، وبذلك أدخلوا الأُمة في نفق مظلم لا يعلم منتهاه إلا الله..."
وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه في مسألة الصراع بين الماضي والحاضر التجديدي في الفقه والدين، وما ينتج عن التقديس الأعمى للماضي دون التدقيق فيه، ويفصّل الكلام في كيفية التوفيق بين الماضي الصحيح والمستحدث من الأمور ضمن ضوابط دينية محددة. وكيف يجب على الداعية أن يراعي العصر ومستلزماته، وكيف يجب أن يخاطب العقول في الدرجة الأولى وأن لا يكون منفراً بل مستقطباً، " أمّا علاقة الدين بالعقل فواضحة، فالعقل هو ميزان التديّن، قال أحدهم للإمام الصادق (ع): "فلان في دينه وفضله؟ فقال (ع): فكيف عقله؟ فقال السائل: لا أدري، فقال: "إنّ الثواب على قدر العقل"، وعن علاقة الدين بالقلب قال رسول الله (ص)– فيما روي عنه -: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه".
وكما أنّ الإنسان قد يصاب في جسده، فإنّه قد يصاب في عقله وقلبه، فكما أنّ للجسد أمراضاً، فإنّ لكلّ من العقل والقلب أمراضاً ومصارع.
وفي نهاية الكتاب يتحدث سماحته عن كيفية مواجهة التطرف والتكفير وسبل معالجته، من خلال معالجة أسبابه ومعاملته بالتسامح دون التكفير المضاد، ولا بد من النقاش وتقبل الرأي الآخر وأن يكون الاختلاف استزادة في المعرفة لا سبيلاً للتمزق والتشتت، " إنّ الاختلاف لا يساوي التمزق والتشتّت ولا يعني أنّ من ليس معي فهو ضدي ومن لا يوافقني الرأي فهو عدوي، وإذا ما قاد الاختلاف إلى التناحر والتنازع فهو تخلف وجاهلية، أما إذا تحرك وفق قانون التدافع والتنافس فهو ليس أمراً جائزاً وممدوحاً فحسب، بل هو شرط لديمومة الحياة الاجتماعية والإنسانية كما يؤكد علماء الاجتماع، وفي ذلك جاء قوله تعالى: {... نحن قسَمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخرياً..} [الزخرف: 32]...
يشكّل هذا الكتاب قيمة علمية ونقدية بارزة في هذا الزمن المليء بالتكفير ورفض الآخر، واستباحة دماء وأعراض الإنسان كل الإنسان بغض النظر عما يعتنقه من مذهب أو فكر... هو بصيص أمل ونافذة نور تدلّنا على أن هناك في الأفق نهاية لهذا النفق الدموي المظلم...
كتب محمد طراف
8/1/2014