(1) التكفير.. مناشئ ودوافع
الشيخ حسين الخشن
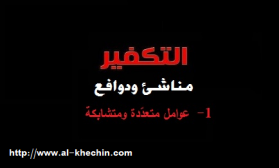
التكفير مناشئ ودوافع (1)
1- عوامل متعدّدة ومتشابكة
إنّ ظاهرة التكفير لم تأتِ من فراغ، ولم تنشأ اعتباطاً، بل إنّ لها أسبابها وبواعثها، وإذا وضعنا اليد على هذه الأسباب والبواعث، نكون قد خطونا خطوة البداية في طريق العلاج والتخلّص من هذه الآفة، لأنّ المرض لا يمكن القضاء عليه أو مقاومته إلاّ بعد تشخيصه، وتشخيصه لا يتمّ إلاّ بمعرفة أسبابه وعوارضه... فما هي أسباب هذه الظاهرة أو هذه الآفة؟
رفض نظرية العامل الواحد
في تفسيرنا وتحليلنا لظاهرة التكفير ودراستنا لأسبابها ومنطلقاتها لا نستطيع إرجاعها إلى عاملٍ واحد، لأنّنا أمام ظاهرة دينيّة اجتماعيّة، أو ظاهرة دينيّة ذات بُعد اجتماعي، ومن الخطأ تفسير الظواهر الاجتماعية على أساس نظرية العامل الواحد، لأنّ ذلك مجافٍ للحقيقة والواقع، فهناك أسباب مختلفة ودوافع شتّى ومتداخلة تُساهم في بناء الشخصيّة التكفيريّة، ويتشابك فيها العامل النفسي مع الاجتماعي مع الاقتصادي مع السياسي مع الديني، واجتماع هذه الأسباب ينتج شخصيات تكفيرية صدامية.
وفي مستهلِّ الحديث عن دوافع التكفير ومنطلقاته أرى أنَّ من الضروري أن أشير إلى بعض النِّقاط الأساسيّة المتّصلة بهذا الموضوع:
أولاً: على الرغم من إدراكنا لعمق ظاهرة التكفير وامتدادها التاريخي، بحيث إنّه لم يكد يخلو منها مجتمع من المجتمعات الدينية أو الوثنية أو غيرها، لكن لا يسعنا الموافقة على تفسيرها على أساس فطري وجبلي، بالقول إنّ الإنسان بدافع من فطرته فإنّه يمارس التطرف والإجرام وإقصاء الأخرين، وذلك لأننا ومن موقع معرفتنا بالإنسان وبخصائص شخصيته ندرك أنَّ الإجرام ليس صفة ذاتيّة متأصّلة فيه، بحيث إنّه يُولَد مجرماً، بل إنّه يكتسب الإجرام عن وعي واختيار، صحيح أنّ لدى الإنسان نوازع وميولاً تشدّه أو تغريه بالإجرام، لكن في المقابل فإنَّ لديه أيضاً ضميراً صاحياً يحذِّره من مغبة ذلك، ويشدّه نحو فعل الخير، ولديه أيضاً عقلٌ فطري يدرك بواسطته قبح الظلم والعدوان، ولذا فإذا اختار فعل الإجرام فبإرادته وسوء اختياره، وإذا اختار طريق الاستقامة والنزاهة فبإرادته وحسن اختياره، وهذا المعنى نؤمن به من منطلق ديني أيضاً، لأنَّ القرآن الكريم قد أكّد على حريّة الإنسان واختياره وأنّه هو الذي يصنع التغيير. والقول بفطريّة الإجرام باطل عقلاً أيضاً، لأنّه ينافي عدل الله تعالى، إذ كيف يحاسب المجرم على ما جنته يداه إذا كان الإجرام فطرياً؟!
ثانياً: لا شك أنّ للظروف الاجتماعية القاسية وما يرافقها من قهر وظلم واستبداد- وهكذا الظروف الاقتصادية الصعبة وما يصاحبها من فقر وعوز- دوراً كبيراً في تهيئة المناخ الأفضل والأرضيّة الملائمة للتكفير، بما شكّل أرضاً خصبة لنموّ بذرة التكفير، بيد أنّ ذلك لا يمثِّل الصورة الكاملة، وإلاّ كيف نفسّر انتماء الكثير من تكفيريّي زماننا- كما تُشير الإحصاءات- إلى مجتمعات ثريّة نسبيّاً، ومنها بعض المجتمعات العربية، على أنّ الفقر والعوز يدفعان نحو ممارسة الإجرام والعدوان، إمّا انتقاماً ممّا تعرّض له الشخص من ظلم وحيف، وإمّا بدافع تأمين لقمة العيش، وهذا لا يفسِّر حقيقة ظاهرة التكفير والتي لا يمارس أصحابها التطرّف بدافع الانتقام والإجرام أو السرقة، بل انطلاقاً من رؤية فكرية ترى أنّ الآخر يستحقّ الموت.
ثالثاً: ولا أراني أغفل دور العامل السياسيّ ومساهمته الفعّالة في تسعير ظاهرة التكفير، والمتأمّل في ظاهرة التكفير المعاصرة وظروف تكوينها منذ الثمانينيات من القرن الماضي يدرك جلياً أنّ العقل الاستكباري قام بدورٍ كبير في تشجيع هذه الظاهرة ورعايتها وتهيئة المناخات الملائمة لها ومساعدتها بكلِّ ما يلزم، وذلك لأهداف ومصالح متعدِّدة سياسية أو غيرها، ولم يعد خافياً أنّ ثمة دوائر خاصة مهمّتها العمل على تهيئة مناخات التطرّف وإدارة اللعبة، وتجنّد لهذا الغرض الأموال الطائلة ووسائل الإعلام وأجهزة الاستخبارات، ولذا فمن السذاجة بمكان إغفال هذا العامل ودوره الأساس في دراسة ظاهرة التكفير ومعرفة سبل علاجها، بيد أنّني مع ذلك لا أستطيع إلاّ أن أرى وراء ظاهرة التكفير سبباً أعمق شكَّل مدخلاً ملائماً استغلّه العقل الاستكباري ونفذ من خلاله إلى الساحة الإسلامية، بعبارة أخرى: إنّه لو لم تكن ثمّة أرضيّة خصبة ليشتغل عليها المستكبرون وأعوانهم لما استطاعوا أن يزرعوا بذرة التكفير ويرعوها ويسقوها من سمومهم، ومن واجبنا العمل على اكتشاف هذه الأرضية والتي هي أرضية ذات صلة بفهمنا للدين والتراث.
ولذا يهمّني أن أُركّز على ما يمكن اعتباره أسباباً فكرية وثقافية لظاهرة التكفير، لأنّها أُمّ الأسباب وأساس الداء. وفيما يلي نحاول أن نطلّ على هذه الأسباب في مقالات لاحقة بعون الله .
20/1/2014
[ من كتاب العقل التكفيري .. قراءة في المفهوم الاقصائي ]