(2) التكفير.. مناشئ ودوافع
الشيخ حسين الخشن
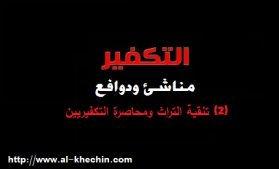
تنقية التراث ومحاصرة التكفيريين
السبب الأول: تقديس التراث
يجاهر بعض نقاد "العقل العربي" بالقول: إنّ التراث الإسلامي نفسه هو أحد المناشئ الأساسية للتكفير والحقل الخصب لذلك، إذ لا يعدم التكفيريون العثور على نص هنا أو هناك منسوب إلى رسول الله (ص) يتشبّثون به لتبرير أعمالهم وتصرّفاتهم التي قد نَسِمُها نحن بالعنف، لكنّها بنظرهم أعمال جهادية تقرّبهم إلى الله زلفى، ومن هنا يطرح هؤلاء فكرة الانعتاق من هذا التراث الخبري والاكتفاء بالقرآن الكريم، لأنّ التراث المذكور مشحون بالأكاذيب التي أدخلها عليه الوضّاعون على اختلاف أهوائهم وتعدّد منطلقاتهم وأغراضهم.
وإنّنا إذ نرفض فكرة انحصار مرجعية العقيدة والتشريع بخصوص الكتاب الكريم، لأنّ الكتاب نفسه يلزمنا بالرجوع إلى السُّنّة والأخذ بها والاعتماد عليها، وذلك في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر: 7] فإنّنا نعترف- في المقابل- بأنّ السُّنة أو التراث الخَبَري لا يمكن الوثوق فيه بأجمعه، والحقيقة أنّ المشكلة لا تكمن في التراث نفسه، بل في تعاملنا معه ونظرتنا التقديسيّة له، فتراثنا الإسلامي رغم اعتزازنا به، ورغم أنّه أنقى إرث إنساني ورثته أمة من الأمم، لكن مع ذلك، فإنّ فيه الغث إلى جانب السمين، والسقيم بجوار الصحيح، والمبين والمحكم إلى جانب المجمل والمضطرب.. ومن هنا انبثقت الحاجة إلى غربلته ونقده وتصفيته، وعملية الغربلة هذه هي جهدنا نحن، بل هي جزء من جهادنا ومسؤوليتنا إزاءه، لأنّ التراث في نفسه صامت لا يفصح ولا يعلن لنا عن صحيحه وضعيفه، فهذه الوظيفة- أعني الغربلة- هي من مسؤوليّة المنتمين لهذا التراث، إنّ محاكمة وغربلة التراث الصامت هي وظيفة الإنسان الناطق.
عِلْما الرجال والدراية ابتكار إسلامي
وقد أدرك المسلمون منذ أمد بعيد حاجة تراثهم إلى عملية غربلة وتصفية، والحق يقال: إنّهم أجادوا في وضع مجموعة ضوابط ومعايير لمحاكمة تراثهم وغربلته لجهتي السند والمتن، وابتكروا لهذه الغاية علمَي الرجال والدراية، فعلم الرجال يهتم بنقد سند الحديث، وعلم الدراية يهتم بنقد المتن، وبعبارة أخرى: إنّ موضوع علم الرجال هو المحدِّث أو الراوي، وغايته التعرّف على وثاقة الرواة أو ضعفهم، بينما موضوع علم الدراية هو الحديث نفسه، وغايته التعرّف على وثاقة الرواية وعِللها.
وإنّنا- كمسلمين- لا نخفي إعجابنا واعتزازنا بهذا الإبداع الإسلامي المتميّز في ابتكار هذين العِلْمين، وما بُذل في هذا السبيل من جهود جبّارة تهدف إلى تنقية تراثنا، بيد أنّ المشكلة هي أنّ الإعجاب بجهود السلف قد أصاب الخلف بعقدة التهيّب من التجديد ومخالفة السابقين، وتحوّل ذلك إلى نزعة من التقديس للسلف وجهودهم، ممّا أصاب العقل الإسلامي بالشلل، ووقع أسيراً لما وضعه أولئك العلماء من قواعد، وأصّلوه من ضوابط، مع أنّ إنتاجهم وإبداعهم على أهمّيته يبقى جهداً أو اجتهاداً بشرياً قابلاً للتطوير والتعديل، ولا سيّما أنّنا لا نتحدّث عن مدرسة واحدة في التفكير بل أمامنا تيّارات متعدّدة ومناهج مختلفة في التعاطي مع الحديث، فهناك منهج "أهل الحديث" المتساهل كثيراً في أمر الرواية، وبالمقابل هناك منهج "أهل الرأي" المتشدّد كثيراً في الأخذ بالخبر، وهناك منهج الشيعة ومنهج المعتزلة إلى غير ذلك.. فعلى الباحث المنصف أخذ هذه المناهج جميعاً بعين الاعتبار، محاولاً التعرّف على أقربها للصواب، مستبعداً كلّ الدعاوى العريضة لبعض المدارس– كمدرسة أهل الحديث- التي تقدّم نفسها على أنّها تمتلك الحقيقة المطلقة في كلِّ ما تقوله وتتبنّاه في الرجال والطوائف والأحاديث والأحكام، وأنّها هي دون سواها المؤهَّلة لوضع مصطلحات لكلِّ الأمة؛ إنّ هذه المزاعم بعيدة عن الصواب والواقع، ويكفيك شاهداً على ذلك أنّ أهل الحديث أنفسهم يختلفون في جملة من المعايير في نقد الأسانيد والمتون، كاختلافهم في رواية "المدلّس" و"المرسل" وتعريف العدالة وغيرها.
نقد المتون
وما يهمّنا التأكيد عليه في المقام هو أسانيد الأحاديث قد خُدمت كثيراً وبُذلت في دراستها جهود هامة وكبيرة ودوّنت لهذا الغرض آلاف الكتب المتخصّصة بمعرفة أحوال الرواة توثيقاً وتضعيفاً وضبطاً وحفظاً.. ما يجعل إمكانية الإضافة على تلك الجهود متواضعة، وليست ذات أهمية كبيرة، وإن كان يمكن الحديث عن تفعيل بعض المعايير الغائبة في توثيق الرواة، وأهمها محاولة اكتشاف شخصية الراوي وذهنيته من خلال ملاحظة مجموعة رواياته وتراثه، بدل دراسته بشكل مجتزأ أو الاقتصار في توثيقه أو تحصيل الوثاقة برواياته اعتماداً على أقوال الرجاليين في حقه، وقد غدا سبر وتجميع أحاديث الراوي الواحد أمراً ميسوراً في زماننا بسبب توافر الأجهزة والبرامج الحاسوبية (الكمبيوترية) التي توفر الكثير من الجهد والوقت على العلماء والباحثين.
وإنّما قلت: علينا تفعيل هذه المعايير لاعتقادي أنّها لا تمثّل اكتشافاً جديداً فقد تنبّه لها علماء الرجال منذ أمدٍ بعيد، ولذا تراهم كثيرا ًما يغمزون من قناة بعض الرواة بأنّه "يروي المناكير" أو "ما يعرف وينكر".
لكنّنا ومع الالتفات لأهمّية هذه البحوث المرتبطة بالسند نحسب أنّ الأمر الأهمّ في التعامل مع السُّنّة والتراث هو نقد المتون دون الاكتفاء بنقد الأسانيد، لأنّ الكثير من الأحاديث قد تكون صحيحة الإسناد لكنّها تشتمل على مضامين قلقة أو مضطربة لا يمكن الأخذ بها، وإذا كان السلف الصالح من علمائنا قد تطرّقوا إلى نقد المتون في مناسبات عديدة، بيد أنَّ هذا الأمر يبقى خاضعاً للاجتهاد، فهم بذلوا جهدهم وعالجوا الأمور بما ينسجم مع ثقافتهم ووعيهم، وعلى المتأخرين أن لا يستسلموا لجهد السلف على أهمّيته، وإنّما عليهم أن يراكموا على هذا الجهد أو يتجاوزه أو يضيفوا عليه استناداً إلى وعيهم الثقافي وفهمهم لدور الدين ورسالته، ويمكننا أن نسجِّل في هذه العجالة مجموعة من الضوابط والمصافي التي لا بدّ أن تعرض الأحاديث عليها قبل الأخذ بها:
أولاً: عرضها على القرآن الكريم، فكلّ حديث يخالف كتاب الله فهو ردّ أو زخرف كما قال الإمام الصادق (ع)[1]، والأمر المهم هنا تحديد معنى مخالفة الكتاب، فهل يُقتصر في ردِّ الحديث ورفضه على مخالفته لنصّ الآية، أو أنّ ذلك يشمل المخالفة لروح القرآن ومفاهيمه العامة كما هو الصحيح؟ ثم هل يمكن تبرير المخالفة وتوجيهها بالنسخ؟
وهل يمكن القبول بنسخ القرآن الكريم بالسنة القطعية كما هو المشهور؟ أم يقال: إنّ دور النبي (ص) هو شرح وتفسير الكتاب لا نسخه وإلغاء أحكامه، كما نص على ذلك قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل: 44].
ثانياً: عرضها على معطيات العقل القطعي، على اعتبار أنّ العقل الفطري هو مرآة صافية لوحي الله، ولا يمكن أن يتعارض العقل الظاهري أعني الرسول، مع الرسول الباطني وهو العقل.
ثالثاً: عرضها على معطيات العلم، ونقصد بها الحقائق العلميّة لا مجرّد النظريات التي لا تزال مثار جدلٍ أو التي لم تَرْقَ إلى مستوى اليقين، والمبرّر لهذا الضابط أنّ النبي (ص) ينهل من وحي الله وكلماته، فكيف لكلامه تعالى أن يتعارض مع فعله وخلقه؟
رابعاً: عرضها على الواقع، ونقصد بذلك الواقع الخارجي المحسوس، وكذا الواقع التاريخي، فإنّ بعض الروايات الصحيحة سنداً لا تنسجم مع الواقع الحسّي أو التاريخي، وقد تحدّثنا بشيءٍ من التفصيل عن هذه الضوابط في كتابنا "الشريعة تواكب الحياة".
إنّ إهمالنا لعملية نقد المتون وإغفالنا للضوابط المتقدّمة أو غيرها، والاستسلام لحسن الظنّ بوثاقة الرواة، والخضوع التام لكتب الحديث وإسباغ وصف الصحاح عليها، إنّ ذلك قد أسّس بشكل أو بآخر لمنطق التكفير وغذّاه بالكثير من الأحاديث التكفيريّة التي أسهمت في تعزيز ثقافة العنف وفي تعميق الهوة بين المسلمين وتمزيقهم شرّ ممزّق.
والنموذج الأبرز للأحاديث التكفيرية هو حديث الفرقة الناجية، وهو حديث مشهور ومعروف ومرويّ من طرق الفريقَيْن- السُّنّة والشيعة– ويُعتبر المرتكز والأساس لانطلاق ما يُعرف بعلم الملل والنحل، وقد ألّف العلماء كتباً كثيرة في شرحه وتفسيره وتحديد المقصود بالفرقة الناجية والفرقة الهالكة، وقد قدّمنا الكلام حول هذا الحديث في إشارة مختصرة تاركين التفصيل في ذلك إلى ما حقّقناه في كتاب "هل الجنّة للمسلمين وحدهم؟".
24/1/2014
[ من كتاب العقل التكفيري .. قراءة في المفهوم الإقصائي ]
[1] انظر: وسائل الشيعة ج27 ص110، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12 و13.