غياب الممارسة النقدية
الشيخ حسين الخشن
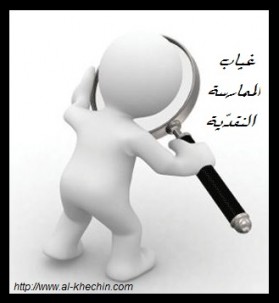
غياب الممارسة النقدية
وقيمة أخرى نراها غائبة أو مغيّبة ولا وجود لها في قاموس الكثير من الحركات الإسلامية ولاسيما السلفية التكفيرية منها، وهي قيمة النقد والمصارحة والمساءلة، ويحلّ محلها لغة التسليم الأعمى ومنطق "نفّذ ثم اعترض" وأنّ الأمير يُطاع ولا يناقَش وما إلى ذلك من تعبيرات تعكس ثقافة القمع والصمت والإسكات، وغياب هذه القيمة عن قاموس العقل التكفيري هو نتيجة طبيعيّة لتحكم الذهنية التعبديّة بهذا العقل.
مشروعية النقد
هذا مع أنّ النقد حالةٌ فطريةٌ تفرضها طبيعة الإنسان كما يوحي بذلك قوله تعالى: {وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً}[الكهف: 54]، حتى أنّنا نجد هذه الطبيعة لصيقة بكلِّ المخلوقات العاقلة، بما في ذلك الملائكة والجنّ، ولهذا انطلق التساؤل النقدي البريء من الملائكة عندما أعلمهم الله باستخلاف آدم على الأرض: {قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}[البقرة: 30]، والأمر نفسه قد حصل مع إبليس في رفضه السجود لآدم مع فارق جوهري، وهو أنّ إبليس انطلق من حال تمرّد على الله خلافاً للملائكة.
ولو غضَّينا النظر عن ذلك وأردنا الاستدلال على مشروعية الممارسة النقدية بالطريقة التقليدية لقلنا:
أولاً: إنّ الأنبياء (ع) مارسوا النقد كما يظهر للمتأمّل في سيرتهم التي عرضها القرآن، فهذا نبيّ الله موسى (ع) ينتقد أخاه هارون على عدم اتّباع طريقته في التشدّد مع بني إسرائيل، قال تعالى: {قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}[طه: 92- 93]، وهكذا نقدَ موسى (ع) العبدَ الصالحَ على تصرّفاته التي لم يُحِط بها خبراً ووجدها معارضة لظواهر الشريعة من قَتْل الغلام وخرق السفينة وإقامة الجدار.
ثانياً: إنّ عنوان النقد يندرج ويلتقي مع عنوان النصيحة أو المعاتبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه العناوين قد أكّدت النصوص الدينية على مشروعيّتها، فاعتبرت الآيات القرآنية أنّ النصح من وظيفة الأنبياء والرسل، قال تعالى على لسان نوح: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ}[الأعراف: 62][1] ويلخّص رسول الله (ص) الدين بالنصيحة، يقول (ص): "إنّ الدين النصيحة"، ولما سُئِل لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم"[2]، وتعتبر بعض الروايات أنّ ترك النصيحة للآخر خيانة، فعن الإمام الصادق (ع): "مَنْ رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يردّ عنه وهو يقدر فقد خانه"[3].
وعن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي (ع): قال لبعض مواليه: "عاتب فلاناً وقل له: إنّ الله إذا أراد بعبد خيراً إذا عوتب قبل"[4]، وعدّت بعض النصوص النصيحة "لجماعة المسلمين" في عداد أمور تُدخل الجنة[5]، وعن أمير المؤمنين (ع): "مِنْ أحسن النصيحة الإبانة عن القبيحة"، وقال: "لا نصح كالتحذير"، ومن "حذّرك كمن بشّرك"[6]، والنصوص في هذا المجال كثيرة.
وعن رسول الله (ص) أنّه قال ذات يوم وهو المعصوم المسدّد من الله: "أشيروا عليّ"[7] قاصداً ترشيد الأمّة وتبصيرها وتعليمها الفكر النقدي الذي لا يستبدّ صاحبه برأيه ولا يُصرّ على خطئه.
ضرورة النقد
وانطلاقاً ممّا تقدّم، يكون النقد أكثر من مجرّد أمر مشروع أكّدته النصوص الدينية وممارسات المعصومين ودعواتهم، بل هو ضرورة دينية إسلامية يُلام الإنسان على ترك الأخذ بها لا على فِعْلِها، لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ شرعيّ، والنُّصح مطلوب ومرغوب شرعاً، وقد عدّ الإمام الصادق (ع) في حديثه الآنف ترك النقد خيانةً، عندما يكون الآخر- فرداً أو جماعةً- في معرض ارتكاب خطأ في قول أو فعل، ومن هنا يكون من الضروري والملحّ جداً تعميم ثقافة النقد والتبشير بها بدل اعتبارها مسّاً بكرامة الآخر وهتكاً لحرمته.
النقد وترشيد الفكر وتقويم الخطى
إنّ الأُمة أو الجماعة أو الحركة التي تنعدم أو تخفت فيها ثقافة النقد لتحلّ محلّها ثقافة الطاعة والانقياد الأعمى، محكومة بإنتاج قادة طغاة وجبابرة، وخَلْقِ حالةٍ من التخشّب والجمود في كيانها، ما قد يجرّ إلى التعثّر أو السقوط، بينما تُشكّل المساءلة والمحاسبة ركناً أساسياً في حيوية وفاعلية واستمرارية الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية، لأنّها تُسهم في إثراء الفكر وترشيده، وإنضاج التجارب وتصويبها، وتسديد الخطى وتقويمها، وتمييز الحسن من الأفكار والبرامج من فاسدها، والصالح من الأفراد عن الطالح، قال عليّ (ع) فيما يُروى عنه: "الشركة في الرأي تؤدّي إلى الصواب" وعنه (ع) في حديث آخر: "امخضوا الرأي مخض السّقاء ينتج سديد الآراء"[8].
إنّ غياب الثقافة النقدية عن واقع أمّتنا وما رافقه من تنظير لثقافة الطاعة- حتى في ما لا ربط له بالطاعة ونظم الأمر- وإلباسها لبوساً إسلامياً من قبيل المفاهيم القائلة: "إنّ السلطان ظلّ الله على الأرض" و"أنّه يد" و"أنّه لا يجوز الخروج عليه ولو كان جائراً"، إنّ ذلك كلّه ساهم في نشوء ظاهرة الطغيان والاستبداد الذي عانت منه أُمّتنا لقرونٍ عديدة ولا تزال، وكانت نتائج ذلك الطبيعية: انحسار مساحة الحريّات، وإصابة الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والفكريّة بالشلل أو التراجع، وقد قالها الإمام عليّ (ع): "مَن استبدّ برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها"[9].
النقد المسموح والممنوع
إنّ الفارق بين النقد المسموح والنقد الممنوع كبير جداً، بحجم الفارق بين النصيحة والفضيحة، وبين التوضيح والتجريح، وبين الأمانة والخيانة، وبين الفتق والرتق، وبين تسديد الخطى وتسجيل النقاط.
فلا يُتوهّم أنّ النقد يلتقي أو يندرج تحت عنوان الغيبة أو عنوان هتك الآخر وفضحه، أو نحو ذلك من العناوين المذمومة شرعاً، فإنّ الغيبة هي كشف عيوب الآخر ممّا يرتبط بحياته الخاصة الشخصية، وأمّا النقد فهو عبارة عن الاعتراض على الآخر والتنديد بأخطائه فيما يرتبط بمواقفه وأفعاله وأقواله في الحياة العامة وما يتّصل بمصلحة الأُمّة، فالحياة الشخصية تُعتبر منطقة محرَّمة على الآخرين، لا يجوز لهم اقتحامها، وأمّا مواقف الآخر وآراؤه الفكرية والسياسية فهي ليست ملكاً شخصيّاً له، بل إنّها نشاط في الحقل العام، وهي ملك للأُمّة، ومن حقّها أن تتدخّل لتقويم أو تسديد ما يمسّها من أفعال وأقوال. وعن علي (ع) أنّه قال: "أيّها الناس إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليّ حقّ، فأمّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم... وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب..."[10]. فالنصيحة وظيفة متبادلة بين الحاكم والأمّة، كما بين أبناء الأمّة أنفسهم، وهي حقٌّ للحاكم على الأمّة وللأمّة على الحاكم، ولا يُسمح للإنسان بأن يتجاوز حقوق الآخرين.
آداب النقد وشروطه
بالإضافة إلى أنّ الممارسة النقدية يجب أن تبتعد عن دائرة التجريح الشخصي وكشف المعايب وفضح الأسرار الخاصة، فإنّه لا بدّ لهذه الممارسة أن تتحرّك أيضاً في إطار القول بالحقّ والحكم على أساس العلم والبرهان، وتبتعد عن الخوض وفق الأوهام والظنون، قال تعالى: {هَا أَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ}[آل عمران: 66]. وقال تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: 36].
وهكذا يجب أن يكون النقد هادفاً، لأنّ الإسلام لا يؤمن بالنقد العابث أو ما يُسمّى بالنقد لأجل النقد، والمعارضة لأجل المعارضة، وإنّما من حقّنا بل ينبغي علينا أن ننقد الآخر بهدف تسديد خطاه وتصويب فكره، ولو أنّ الممارسة النقدية تحرّكت ضمن هذه الضوابط، فإنّها بالتأكيد ستساعد على تلاحم أبناء المجتمع، وستعود بالخير على المنقود قبل الناقد، ويتحوّل الناقد إلى صديق للمنقود لا عدواً له، قال عليّ (ع) فيما يروى: "النصح يثمر المحبّة"، وعنه (ع): "لا عداوة مع نصح"[11]، وفي كلمة ثالثة له (ع): "العتاب حياة المودة"، وفي كلمة رابعة له (ع): "مَن أحبّك نهاك"[12].
نقد القيادة وإضعافها
وفي المقابل، قد يحلو للبعض ممَّن يرون إقفال باب النقد على أساس أنّ يبرّروا رفض الممارسة النقدية بأنَّ فتح هذا الباب على مصراعيه بما يشمل القادة– ولاسيّما الدينيّين- يؤدّي إلى إضعاف موقع القيادة ويجرّيء الناس على النيل منها والحطّ من كرامتها.
ولكنّنا نلاحظ على ذلك، أنّ الأُمّة التي تُثقَّف على معرفة الفرق الكبير بين النقد والتجريح سوف تتعامل مع نقد القائد في مواقفه أو فكره تعاملاً إيجابيّاً، وترى أنّ ذلك يحصّن موقع القيادة ويقوّيها لا أنّه يُضعفها، وأنَّ إقفال هذا الباب ومنع الأمّة من التعبير عن آرائها النقدية بطريقة حضارية قد يولِّد ردّة فعل سلبيّة تجاه القائد والنظام الذي يحميه من النقد.
والمفارقة الكبرى أن ترى عليّاً، وهو المعصوم في فكره المتسامي في عقله وعواطفه، يدعو الناس ويجتذبهم إلى مراقبته ونقده ويحثّهم على إبداء المشورة له في زمنٍ كانت سيرة الحاكم جارية على كمِّ الأفواه المعارضة، وذلك في كلمته الشهيرة: "فلا تكلّموني بما تكلَّم به الجبابرة، ولا تتحفّظوا منّي بما يتحفّظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنّ مَن استثقل الحقّ أن يُقال له، أو العدل أن يُعرَض عليه، كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍّ أو مشورة بعدل.."[13].
لكنّنا، ونحن نزعم الانتماء إلى مدرسة عليّ (ع)، نرفض نقد القادة ونُضفي عليهم هالة من القداسة المصطنعة، مع أنّ نقد القيادة ومساءلتها عندما يتحرّك ضمن الضوابط المتقدِّمة، يعود بالخير على الأُمّة جمعاء، لأنّه يحُول دون نشوء ظاهرة الاستبداد السياسي، وكذا الاستبداد الدينيّ الذي يُعتبر من أسوأ أنواع الاستبداد، وقد تكون الممارسة النقدية هي الضمانة الوحيدة التي تجنّبنا الوقوع في شرك هذا الاستبداد، وقد تنبّه لخطورة هذا الأمر الفقيه الشيعي الكبير الشيخ النائيني (1857م- 1936م) في رسالته "تنبيه الأُمة وتنزيه الملّة"[14] والتي تُعتبر أهم وثيقة في الفقه السياسيّ عند الشيعة الإمامية، فإنّه قد أكّد على تقسيم الاستبداد إلى استبدادٍ سياسي وآخر ديني، وعلى ربط كلّ منهما بالآخر واعتبارهما توأمين متآخيين، ويدعو إلى تشكيل هيئة مراقبة ومحاسبة "من عقلاء الأُمة وعلمائها الخبراء بالحقوق الدولية المطّلعين على مقتضيات العصر وخصائصه، ليقوموا بدور المحاسبة والمراقبة تجاه ولاة الأمور الماسكين بزمام الدولة بغية الحيلولة دون حصول أيّ تجاوز أو تفريط... ولا تتحقّق وظيفتهم من المحاسبة والمراقبة وحفظ محدودية السلطة ومَنْع تحولها إلى ملوكية، إلاّ إذا كان جميع موظَّفي الدولة، وهم القوّة التنفيذية في البلاد، تحت نظارة ومراقبة هذه الهيئة التي يجب أن تكون هي الأخرى مسؤولة أمام كلّ فرد من أفراد الأُمة..."[15].
وقد سبقه للتنبيه على ذلك المفكِّر الكبير عبد الرحمن الكواكبي (1854- 1902) في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، معتبِراً أنّ القهر أو الاستبداد هو سرّ تخلُّف هذه الأمّة، ومتحدِّثاً عن العلاقة بين الاستبداد السياسي والاستبداد الديني.
من كتاب "العقل التكفيري قراءة في المفهوم الاقصائي"
9/4/2014
[1] وراجع الأعراف: 68- 79- 93، التوبة: 91.
[2] راجع سنن أبي داوود ج2 ص 465 وغيره.
[4]وسائل الشيعة ج12 ص18، الحديث9، الباب من أبواب أحكام العِشرة.
[5]راجع بحار الأنوار ج72 ص65.
[6]انظر: تصنيف غرر الحكم ص225.
[7]كنز العمال ج10 ص 423 رقم 30021.
[11]تصنيف غرر الحكم ص226.
[14] نُشرت الرسالة بالعربية في كتاب بعنوان "ضدّ الاستبداد"، تأليف: د.توفيق السيف، وصدرت عن المركز الثقافي العربي – بيروت والدار البيضاء.
[15]تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ص: 106-114.