عقوبة المرتد بين الحد والتعزير(1/3)
الشيخ حسين الخشن
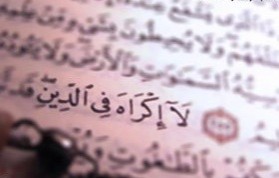
في مناسبات متعددة سجلنا ـ على صفحات "بينات" ـ جملة مداخلات وكتابات حول قضية الردّة وإشكاليتها ومدى مشروعيتها، ومن البحوث التي لا بدّ من التطرق إليها في هذا المقام هو الحديث عن طبيعة هذا الحد.
سؤالان أساسيان:
ولدينا سؤالان أساسيان بشأن طبيعته:
1 ـ هل أن حد الردّة حُكمٌ مولوي تشريعي أو أنه حُكمٌ تدبيري؟
ولا يخفى أنّ بين الحكمين(المولوي والتدبيري) فوارق عديدة أهمها: أن الحكم المولوي لا يحق لأحد رفعه أو تغييره، وهو يتسم بالثبات والديمومة، وتنطبق عليه القاعدة المأثورة"حلال محمدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة"(الكافي1/58)، وأما الحكم التدبيري فهو حكم مؤقت وقابل لرفع اليد عنه أو تجميده من قبل الحاكم الذي بيده السلطة الشرعية"(وقد بحثنا هذا الأمر مفصلاً في كتاب"الشريعة تواكب الحياة" فليراجع).
2ـ أنه وبناءً على كون حد الردة حكماً تشريعياً مولوياً فهل هو حدٌّ أو تعزير؟
والفارق بين الحد والتعزير كبير، فرغم اشتراكهما في أنهما معاً يمثلان عقوبة جزائية مجعولة بحق المتخلف عن الالتزام بالقوانين الإسلامية، إلاّ أن عقوبة الحد لها مقدر شرعي ثابت ومنصوص ولا يحق لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، بينما عقوبة التعزير ليس لها مقدر كذلك، وإنما هي بيد السلطة المتخصصة في الدولة الإسلامية، شريطة أن لا تبلغ مقدار الحد.
بين التشريع والتدبير:
فيما يرتبط بالسؤال الأول، فإن المعروف لدى فقهاء المسلمين أن حد الردّة هو حكم مولوي، وليس تدبيراً أو إجراءً مؤقتاً، إلا أنّ المولوية ليست بديهية، وثمة مجال للنظر فيها وإمكانية للقول: إن الحد المذكور هو إجراء تدبيري اتخذه الرسول(ص) حمايةً للمجتمع الإسلامي من مخاطر الردّة وتداعياتها السلبية على الكيان الإسلامي الحديث الولادة.
وفي المقابل: قد يُستبعد أن يكون حد الردّة (القتل) أمراً تدبيرياً، على اعتبار أنه لا يعقل أن يمنح التشريع السلطة ـ ولو كانت عادلة ـ حق إعدام بعض الناس بشكل استثنائي ومخالف للقاعدة الشرعية الأولية!
ولكن الاستبعاد المذكور ليس في محله، إذ لقائلٍ أن يقول: بأن ثمّة وجهاً وجيهاً للحكم بتدبيرية قتل المرتد، وحاصل هذا الوجه:
إن أي تشكيل اجتماعي أو تكوين ديني أو سياسي في بداية نشوئه وانطلاقه وفي سبيل تثبيت أركان الكيان الوليد وحمايته من القلاقل والهزائز الداخلية أو الخارجية قد يتخذ إجراءات قاسية تصل إلى حد الإعدام بحق المرتدين والمنشقين عليه، لأن الارتداد في هذه المرحلة قد يعرّض الكيان برمته للسقوط ويقوّض أركانه.
ومن الممكن والمعقول جداً أنّ الإسلام اتخذ الإجراء عينه في بداية تكوين وتأسيس المجتمع الإسلامي وتشكيل دولته التي لا تزال فتّية لم يقسُ عُودُها ولم يشتد ساعدها والمخاطر تتهددها والأعداء تحاصرها من كل جانب، ليس أعداء الخارج فحسب، بل أعداء الداخل أيضاً وهم الأخطر، أعني بهم المنافقين وذوي النفوس المريضة والضعيفة الذين كانوا يتربّصون بها ـ الدولة الإسلامية ـ الدوائر، ويتحيّنون الفرص للوثوب عليها، والأرضية مهيأة لذلك، حيث إن الروح القبلية العصبية ورواسب الجاهلية لا تزال مركوزةً في النفوس، ما يعني أن هذا المجتمع لا يزال في معرض التفكك والتشظيّ، وفتائل الانفجار وعناصر الإثارة متوفرة فيه بكثرة. أمام ذلك كله يكون تشدد الإسلام إزاء حالات الردّة أمراً مفهوماً ووجيهاً لئلا تؤدي ردّة من هنا وردّة من هناك إلى تعريض الكيان برمّته إلى خطر السقوط والانهيار.
وفي ضوء ذلك تكون عقوبة قتل المرتد حلاً اضطرارياً مؤقتاً اقتضته مصلحة حماية الكيان الإسلامي الوليد كمقدمة ضرورية لحفظ الرسالة الإسلامية.
إلا أن هذا التوجيه لتدبيرية حد الردّة يواجهه اعتراضان:
الأول: إن هذا التوجيه وإن كان ممكناً من الناحية الثبوتية إلا أنه لا شاهد عليه من الناحية الإثباتية، والأصل في كلام النبي(ص) وكذا المعصوم أن يُحمل على بيان الحكم التشريعي المولوي وليس الحكم التدبيري.
ويلاحظ عليه: إن أصالة المولوية لا أصل لها، فإن الرسول(ص) كما أنه مبلّغ عن الله، فهو الحاكم وبيده السلطة وإدارة شؤون المجتمع وهذا يقتضي أن يصدر عنه أحكام تدبيرية سلطانية، ومع نفي أصالة المولوية عنه(ص) يغدو احتمال التدبيرية وارداً بنحوٍ يكون كافياً لمنع ظهور النص الوارد في قتل المرتد على المولوية.
الثاني: إنه لو أمكن قبول التوجيه المذكور للتدبيرية في النصوص الواردة عن رسول الله(ص) بلحاظ حداثة عمر الدولة الإسلامية في هذه المرحلة ولين عودها وقرب عهدها بالجاهلية، لكن لا يمكن قبوله في الأحاديث المرويّة عن الأئمة(ع)، لا سيما المتأخرين كالإمام الصادق(ع) ومن بعده من الأئمة الذين عاشوا في ظل الدولة العباسية، حيث انتشر الإسلام في تلك المرحلة واستقر وقسا عُوده، ولم يعد تغيّر الدول فضلاً عن ارتداد الأفراد موهناً للدين أو موجباً لتعريضه إلى خطر الانهيار والسقوط، فلو كان الحكم المذكور تدبيرياً، لَنبَّه الأئمة(ع) إلى ذلك، كما نبّهوا في موارد أخرى، كقضية أكل لحوم الحُمر الأهلية، أو قضية تغيير الشيب بالحناء أو نحوها من القضايا.
أقول إن هذا الاعتراض وجيهٌ ومقبول ولكن شريطة توفر عدة عناصر:
1 ـ تمامية الروايات الواردة عن الأئمة(ع) بشأن قتل المرتد سنداً ودلالة.
2 ـ أن لا نجد شواهد من النصوص تؤكد التدبيرية.
3 ـ أن لا نجد أيضاًَ تفسيراً آخر للتدبيرية.
إلا أن كل هذه العناصر موضع تأمل، فروايات الردة لا تخلو من المناقشة في سندها أو دلالتها، وشواهد التدبيرية ليست معدومة، ووجود تفسير آخر للتدبيرية أمرٌ وارد، فإنه لو لم يكن لها من تفسير سوى منح السلطة الشرعية نوعاً من المرونة في التعامل مع هذا الأمر الحساس والخطير ـ أي الردة ـ والذي تختلف درجة خطورته من مورد لآخر ومن شخص لآخر ومن زمان لآخر لكفى ذلك.
بين الحدّ والتعزير:
أما فيما يرتبط بالسؤال الثاني عن طبيعة حكم الردة وأنه حدّ أو تعزير؟ فإنّ الرأي السائد والمعروف في الفقه الإسلامي يعتبر الردة جريمة حدٍ يُعاقَب عليها بالقتل، لكن بعض الباحثين المعاصرين اختار أنها جريمة تستوجب التعزير، فهو لا يناقش في مبدأ العقوبة، باعتبار أن تحريم وتجريم الردة هو من المُسلّمات، ولكنه يناقش في اعتبارها عقوبة حدّ، ويستقرب كونها عقوبة تعزير، وعقوبة التعزير "مفوّضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام"(محمد سليم العوا، في بحث منشور على الموقع الالكتروني: إسلام أون لاين، بعنوان"عقوبة الردة تعزيراً لا حداً".
وخلاصة وجهة نظره: أن القرآن لم يحدد للردة عقوبة دنيوية، وإنما وردت عقوبتها في السنة، ولكنه لاحظ أن روايات الردة في غالبها لا علاقة لها بالردة، وإنما هي ناظرة إلى الحرابة باستثناء رواية واحدة، هي رواية ابن عباس عن رسول الله(ص): "من بدّل دينه فاقتلوه".
وقد رأى أن مستند الفقهاء في افتراض واعتبار أن القتل هو حدٌ لعقوبة الارتداد هو: ظهور صيغة الأمر في قوله "فاقتلوه" في الوجوب، والوجوب وإن كان هو ظاهر الأمر إلا أن في المقام عدة قرائن تنفي كونه للوجوب وتشهد أنه للإباحة، وقد استنتج بعد عرض تلك القرائن أن الحكم في المرتد هو إباحة قتله، ما يعني أن القتل عقوبة تعزيرية فلا يتعين بل يمكن للحاكم اختيار عقوبة أخرى، والقرائن التي أوردها نعرض لها مع مناقشاتها في مقال لاحق.ٍ