الشذوذ وموازينه
الشيخ حسين الخشن
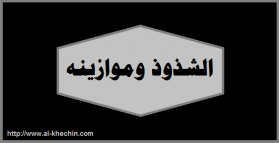
~ الشذوذ وموازينه ~
يستخدم البعض أساليب تهويلية متنوعة في مواجهة الآخر على طريقة الحرب النفسية، أو ما يُسمّى بحرب الأعصاب التي تستهدف التأثير على معنويّاته في محاولة لثنيه عن آرائه وتأليب الرأي العام ضدّه وعزْله عن التأثير في الأُمّة، ويأتي على رأس هذه الأساليب: رَمْي الآخر بالشذوذ عن الخطّ العام للجماعة التي ينتمي إليها، وقد اتّخذ الاتّهام بالشذوذ في الآونة الأخيرة بُعْداً خطيراً عندما تحرّك بدون ضوابط تحكمه أو قواعد يسير وَفْقَها، وهو ما يستدعي وضع النقاط على الحروف وتحديد الضوابط العامة التي يُعتبر الخروج عليها شذوذاً وتجاوزاً للخطوط الحمراء.
الإجماع في الميزان
غالباً ما تنطلق دعاوى الشذوذ لدى مخالفة الفقيه أو الباحث لبعض القضايا المُجْمَع عليها أو المشهورة، ولا يخفى أنّ مصداقية هذا الاتّهام موقوفة على حجيّة الإجماع أو الشهرة، وإلاّ فلن يكون لهذا الاتهام نصيب من الصحة، فهل إنّ الإجماع حُجّة في نفسه؟ وهل الشهرة حُجّة في نفسها؟
وقد أثبت المحقّقون من علماء الأصول أنّ الإجماع ليس حجّة في نفسه إلاّ إذا كشف عن رأي المعصوم، وكاشفيّته عن رأي المعصوم لها شروط من أهمّها: أن لا يكون في المسألة المجمع عليها مدرك آخر عقليّ أو نقليّ وإلاّ احتمل استناد المجمعين إلى ذلك المدرك، ومعه فلنا أن ننظر في هذا المدرك وقد لا نوافق المشهور على فهمهم، ومن المعلوم أنَّ فهم الفقهاء ليس حجّة إلاّ على مقلّديهم.
هذا من ناحية القاعدة أو الكبرى كما يصطلح العلماء، وأمّا من ناحية التطبيق أو الصغرى فإنّ تحصيل الإجماع في غاية الصعوبة، إذ كيف يتسنّى لنا إحصاء أقوال كلّ العلماء مع أنّ الكثيرين منهم لم تصلنا كتبهم أو لم يؤلّفوا كتباً أساساً، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنّ تحصيل الإجماع في غير ضروريّات الدين أو المذهب في غاية الندرة[1].
ومن جهة أخرى فإنّنا نلاحظ أنّه قد وقع الخلط والخطأ المكرّر في دعاوى الإجماع إلى درجة أن يُدعى الإجماع على الشيء وضدّه، وقد ألّف الشهيد الثاني رسالة خصّصها للحديث عن إجماعات الشيخ الطوسي (رحمه الله) التي ناقض فيها نفسه، فادّعى الإجماع على المسألة ونقيضها، أو ادّعى الإجماع على المسألة ثم خالف نفسه في محلٍّ آخر، وقال في أول تلك الرسالة: "قد أفردناها للتنبيه على أن لا يغترّ الفقيه بدعوى الإجماع، فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيراً من كلّ واحد من الفقهاء لاسيّما من الشيخ (الطوسي) والمرتضى"[2].
إنّ القول بعدم حجّية الإجماع هو الذي استقرّ عليه الرأي لدى المدرسة الأصولية الشيعيّة المتأخّرة، أمّا لدى المدرسة السّنية فعلى الرغم من أنّ موقفها الرسمي لا يزال هو القول بحجّية الإجماع، إلّا أنّ ذلك هو الموقف النظري، وأما من الناحية العملية فإنّنا نرى الكثيرين من أهل الرأي والاجتهاد قد خالفوا الإجماع في موارد عديدة، بل اقتربوا من القول بعدم حجّيته كمصدر مستقلٍّ من مصادر التشريع، يقول الشيخ فرج الله السنهوري:
"وبهذا اتّضح أنّ الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامي بأجمعه هو الوحي الإلهي وأنّ مَرَدّ الإجماع والقياس إليه"[3]، ويقول الشيخ محمد الغزالي: "إنّ قضية كون الإجماع في غير أصول الفرائض حجّة ليست موضع إجماع من علماء المسلمين..." ويُضيف قائلاً: "فلم يزعم أحد من الأوّلين أو الآخرين أنّ الإجماع يُنشئ حكماً شرعيّاً... إنّ الإجماع لا بدّ من استناده إلى حجّة شرعيّة كي يُعتبر دليلاً محترماً وإلّا فلا وزن له... وما ليس له إسناد شرعيّ من الكتاب والسنّة فلا صلة له للإجماع به، ولم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من جهالهم: إنّ الإجماع المجرّد العاري يوجِب واجباً أو يُحرِّم حراماً"[4].
ولقائل أن يقول للشيخ الغزالي: إنّه إذا كان مستند المجمعين هو الكتاب والسنّة فلن تبقى للإجماع ولرأي المجمعين قيمة تُذكر، وإنّما القيمة كلّ القيمة حينئذٍ هي للكتاب والسنّة، أما رأي المجمعين فهو حصيلة فهمهم للكتاب والسنّة، ورأي المجتهد ليس حُجّة إلّا عليه وعلى مقلّديه من عامة الناس دون الفقهاء الآخرين.
الشهرة ليست أفضل حالاً
وإذا كان الأمر كذلك في الإجماع، فالشهرة ليست أفضل حالاً منه، فإنّ الشهرة الفتوائية فضلاً عن الشهرة في المسائل التاريخيّة أو العقيديّة لا تملك دليلاً على حجيّتها، ولذا لا يصحّ عدّ مخالفها شاذّاً، وعدم حجيّة الشهرة أَمْر اتّفقت عليه المدرسة الأصولية في الآونة الأخيرة، نعم هناك نوع من الشهرة وهو الشهرة الروائية- بمعنى كون الرواية مشهورة بين الرواة وأصحاب الأئمّة- قد اعتبرها بعض العلماء مرجِّحاً من مرجِّحات باب التعارض، بمعنى أنّه لو تعارضت روايتان إحداهما مشهورة والأخرى ليست كذلك، فيؤخذ بالأولى، لما ورد عن الإمام الصادق (ع): "خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر"[5] لكنّ هذا النوع من الشهرة خارج عن محط النظر ومحل الكلام.
الجرأة في مخالفة الحجّة
وأمّا أن يقال: إنّ الإجماع وكذا الشهرة وإن لم يكونا حجّة لكن مخالفة الإجماع أو المشهور لا تخلو من جرأة في دين الله لا ينبغي للفقيه أن يرتكبها.
فيمكن الجواب عليه:
أولاً: بما ذكره السيد الخوئي (رحمه الله) من أنّ "الجرأة على خلاف المشهور لا محذور فيها لأنّ الشهرة ليست حجّة"[6]، إنّ معنى ذلك أنَّ الجرأة هي في مخالفة الحجّة فقط، فلو تمّ للفقيه دليل على خلاف المشهور أو الإجماع فلا جرأة في إفتائه وفق الدليل، بل ربّما تكون الجرأة في تركه للدليل وانحيازه للمشهور أو الإجماع.
ثانياً: إنّ فتوى المشهور قد تكون هي خلاف الاحتياط، لتضمّنها ما فيه انتهاك حرمة فرد أو جماعة، كما في الفتاوى التي تجيز غيبة الآخرين ممن يختلفون مع الإنسان في المذهب أو تجيز سبّهم أو لعنهم أو ما إلى ذلك، ولا شكّ أنّ الجرأة في إطلاق هذه الفتاوى وأمثالها هي المخالفة للاحتياط والورع.
مقياس الشذوذ
ويتردّد على ألسنة البعض: أنّ مخالفة الفقيه في فتوى أو فتويَيْن أو ثلاث.. لا تجعله شاذاً، بيد أنَّ مخالفته في عشرات الفتاوى تُدرجه في عداد الشاذّين وتكشف عن انحراف في سليقته ورغبته في التقاط الشواذ وتتبّع النوادر، وقد ينظّر بعضهم لذلك أو يُشَبِّهَه بما يذكره علماء البلاغة ممّا يسمّونه بـ "التنافر"، فإنّ بعض الكلمات لو نظرنا إليها بمفردها فإنّها لا تُشكّل ثِقْلاً على اللسان أو السمع، لكن إذا ما صيغت في جملة واحدة فإنّها تغدو نافرة وثقيلة على الحاسَّتَين المذكورتَيْن بسبب قرب مخارج الحروف فيها، كما هو الحال في قول الشاعر:
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر[7]
ولكنّنا نعلّق على هذا الكلام: بأنّ مقياس الشذوذ هو في مخالفة الحجّة والدليل فقط، وحيث إنّ الإجماع ليس حجّة وكذلك الشهرة فلا مبرّر لاعتبار مَنْ يخالفهما شاذّاً وإن تكرّرت منه المخالفة، بينما لو خالف الحجّة فهو شاذّ حتى لو كانت مخالفته يتيمة وحيدة.
وأما قياس مقامنا على مسألة تنافر الكلمات المذكورة في البلاغة فهو قياس مع الفارق، وخلط بين المباحث العلمية، والمسائل اللفظية، فإنّ الأولى ترتكز على الدليل ومقياس الشذوذ فيها يتحدّد بمقدار مخالفة الدليل لا المشهور، وأما الثانية فإنّها ترتكز على القاعدة اللُّغوية وترتكز أيضاً على التأثير الموسيقي للكلمات وهو يرتبط بحاسَّتَي السَّمْع والنُّطق ممّا يجعل بعض الكلمات ثقيلة رغم كونها على وفق القاعدة اللغوية والنحوية.
وإذا جاز لنا التَّشبيه والمقارنة فربّما يكون الأقرب تشبيه مقامنا بالعلوم المعتمدة على الحجّة والبرهان لا مثل علم البلاغة الذي يتحكّم به الوقع الموسيقي للألفاظ، وعليه فلنا أن نتساءل: أترى يسوغ لنا أن نرمي- مثلاً - عالماً فلكيّاً بالشذوذ- بطريقة تشهيرية- لأنّه قدّم نظرية جديدة مخالفة للسائد، معتمداً على معطيات جديدة ومبرهَنة!؟ أو يسوغ لنا أن نرمي بالشذوذ عالماً نفسيّاً لمجرّد أنّه قدّم نظرية جديدة في علم النفس!؟..
الإجماع حاجة نفسية
ويبقى لسائل أن يسأل:
أولاً: إذ كان الإجماع والشهرة ليسا حجّة شرعية فكيف شاع الاستدلال بهما في كلمات الفقهاء؟
ثانياً: إذا كانت قيمة الإجماع في كاشفيّته عن قول المعصوم (السنّة) فقط فكيف يُجعل دليلاً في مقابلها عندما يقال: الأدلّة الشرعية هي: الكتاب والسُّنّة والإجماع والعقل؟
ونترك الإجابة على السؤال الأول للشهيد الصدر (رحمه الله) الذي يعتقد أنّ لجوء الفقيه إلى التمسّك بالإجماع أو الشهرة كان تلبيةً لحاجة نفسية أكثر منها تلبية لحاجة علمية، يقول (رحمه الله) ما ملخّصه:
"إنّ هناك حالة نفسانية راسخة في ذهن الفقيه تمنعه عن مخالفة الأفكار والفتاوى السائدة والمنتشرة بين السلف الصالح، وهذه الحالة كما هي موجودة لدى علماء الشيعة موجودة لدى علماء السُّنّة أيضاً، وربما كانت هي السبب في سدّ باب الاجتهاد- عندهم- خارج المذاهب الأربعة المعروفة، لأنّ فتحه بشكلٍ مطلَق يؤدّي إلى الخروج على بعض مسلّمات عصر الصحابة وهو ما يصطدم مع الحالة النفسية المذكورة... وأما عند علماء الشيعة فبرزت نتائج هذه الحالة في علم الأصول، ذلك "أنّ علماء الأصول عندما واجهوا الفقه الموجود بأيديهم وكانت لديهم تلك الحالة النفسية وهي التحفّظ على أُطر ومسلَّمات ذلك الفقه صاروا بصدد إيجاد قواعد أصولية يمكن أن تشكّل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلَّمات الفقهية فنشأت عندنا قواعد: "حجيّة الشهرة"، و"الإجماع المنقول" و"انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب" و"وهن الخبر الصحيح بأعراضهم.."[8].
ونقول في الإجابة على السؤال الثاني: بأنّ عدّ الإجماع- عند الشيعة- دليلاً في قبال السنّة مع أنّ حجيّته منطلقة من كاشفيته عنها، كان نوعاً من المماشاة مع اخوانهم من أهل السنّة الذين "هم الأصل للإجماع وهو الأصل لهم"، على حدّ تعبير الشيخ الأنصاري في رسائله[9].
وأخيراً نقول لأنصار "الإجماع" و"المشهور" و"السائد": إنّ علينا أن نكون أنصار الحقيقة والبرهان والدليل سواء وافق المشهور أو خالفه، ونقول أيضاً: لا يتغنّى أحد بفتح باب الاجتهاد إذا كان الفقيه لا بدّ أن يبقى محكوماً بسقف المشهور.
من كتاب { العقل التكفيري قراءة في المنهج الاقصائي
26/5/2014
[1]هداية الأبرار للكركي ص259.
[2]رسائل الشهيد الثاني ج2 ص847.
[3]دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص161.
[5]مستدرك الوسائل ج17 ص303، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث2.
[6]مصباح الفقاهة ج1 ص126.
[7] إعجاز القرآن للباقلاني ص269.
[8]مباحث الأصول ج2 ص94، وقضايا إسلامية العدد3 ص238.
[9]فرائد الأصول ج1 ص184، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم.