موجات التضليل والتناحر الديني
الشيخ حسين الخشن
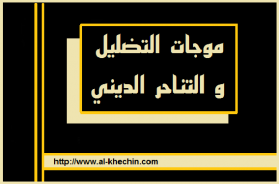
موجات التضليل والتناحر الديني
ثمّة أسلحة فتّاكة كثيرة يتمّ استخدامها في عمليات التناحر الديني والتراشق المذهبي المستعرّة منذ أمدٍ بعيد، ومن جملتها سلاح التضليل الذي يسلّه أتباع الأديان المختلفة بوجه بعضهم البعض ويشهره كلّ مذهب بوجه المذاهب الأخرى، وقد استفحلت موجات التضليل والتضليل المضادّ في الآونة الأخيرة وامتدّت إلى داخل الدائرة المذهبية الواحدة، وهو ما يستدعي تسليط الأضواء عليها بغية وضع الأمور في نصابها وتحديد موجبات الضلالة ومعالم الهداية.
موجبات الضلالة
بالعودة إلى الكتاب والسنّة نجد أنّهما حدَّدا لنا موجبات الضلال وأسبابه بما يمكن إرجاعه إلى العناوين التالية:
1- الشرك: قال سبحانه: {وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً}[النساء: 116].
2- الكفر: قال تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً}[النساء: 136].
3- النّفاق: روي عن الإمام عليّ (ع): "أحذّركم أهل النفاق، فإنّهم الضّالون المضلون والزالون المزلون"[1].
4- معصية الله ورسوله: قال سبحانه: {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}[الأحزاب: 36].
5- اتّباع الهوى: قال تعالى: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}[ص: 26] وقال سبحانه: { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ}[الجاثية: 23].
6- اتّباع الشيطان: قال سبحانه حكاية عن لسان إبليس: {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ}[النساء: 119].
والسببان الأخيران يندرجان في السبب الرابع، لأنّ اتباع الهوى أو الشيطان من مصاديق معصية الله تعالى.
7- الجهل بأئمّة الهدى: فعن عليّ (ع):"وأدنى ما يكون العبد ضالاًّ أن لا يعرف حجّة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده الذي أَمَرَ الله عزّ وجلّ بطاعته وفرض ولايته"[2] وهذا يمكن إرجاعه إلى الأمر الرابع أيضاً كما هو واضح.
العاصم من الضّلالة
وكما حدَّد لنا القرآن والسُّنّة موجبات الضلالة فقد حدّدا سُبُل الهداية والعواصم من الانحراف والتيه، ويمكن حصر ذلك بأمرَيْن:
1- التمسّك بالقرآن الكريم، فإنّه أساس الهداية ومنبعها، قال سبحانه: {إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}[الإسراء: 9]، وعن أمير المؤمنين (ع): "اعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشّ والهادي الذي لا يضلّ والمحدّث الذي لا يكذب"[3].
2- التمسّك بهدي النبيّ وعترته: قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر: 7]، وعن أمير المؤمنين (ع): "... واقتدوا بهَدْيِ نبيّكم فإنّه أفضل الهدي واستنّوا بسنّته فإنّها أهدى السُّنن"[4]، وقد روى المسلمون- سُنَّة وشيعة- عنه (ص) أنّه قال: "إنّي تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرِدا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما"[5].
المشكلة في التفاصيل
وهذا الكلام على عمومه قد لا يرتاب فيه أحد من المسلمين على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم، بيد أنّ المشكلة في التفاصيل وفي إثبات أنّ هذا الأمر أو ذاك مما جاء به النبيّ (ص) أو لا؟ لأنّه فيما عدا المسلمات العقيدية والضروريات الفقهية فقد وقع الخلاف الكثير في قضايا العقيدة والتشريع، للاختلاف في سندها أو دلالتها، فما ثبت لدى البعض أنّه من هدي الإسلام لم يثبت عند الآخر، وما اعتبره البعض ضلالاً لم يفهمه الآخر على هذا النحو..
وإن دائرة القضايا البديهية والمسلّمة صغيرة جداً بالقياس إلى القضايا النظرية التي وقعت محلاً للأخذ والرد، ويعود السبب في كثرة القضايا النظرية بالقياس إلى البديهيات إلى عدة عوامل، أهمها: ابتعادنا عن عصر النص وما رافقه من دسّ ووضع، أو ضياع للنصوص أو للقرائن المحتفة بها ممّا قد يرفع غموضها، وقد قدّر أحد الفقهاء المعاصرين نسبة الضروريات الإسلاميّة إلى النظريات فبلغت نحو ستة في المائة، قال:
"الأحكام الشرعية الإسلامية تصنّف إلى قسمين:
أحدهما: الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين عامة... وهذا الصنف من الأحكام الذي يتمتّع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية.
والصنف الآخر: الأحكام الشرعية التي تتمتّع بطابع نظري، وهذا الصنف من الأحكام هو الذي يتوقّف إثباته على عملية الاجتهاد والاستنباط"[6].
وباتضاح ذلك نقول: إنّ رَمْي الآخر بالضلال إنّما يسوغ إذا كانت مخالفته في البديهيات دون النظريات، وإلاّ لجاز لكلّ عالم أن يضلِّل الآخرين الذين يختلفون معه في بعض الآراء، ولهذا قال الشهيد الثاني: "المراد بالأصول التي تُردّ شهادة المخالف فيها: أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد، أمّا فروعها من المعاني والأحوال وغيرها من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها، لأنّها مباحث ظنيّة، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير.."[7].
حذارِ من المسارعة في التضليل
وفي ضوء ذلك، يكون لزاماً علينا أن نُحذِّر من المسارعة في رمي الآخر بالضلال والإضلال، ولا سيّما في الدائرة المذهبية الواحدة، فإنّ في ذلك جرأة لا يرتكبها مَنْ أراد الاحتياط لنفسه ودينه، ولا يقتحمها إلاّ من قلّت معرفته بحقيقة القضايا الدينية واختلاف الأنظار فيها، وتعدّد الوجوه والمحتملات في فهمها، هذا الاختلاف الذي وصل إلى درجة أن يؤلّف التلميذ كتاباً يصحّح فيه اعتقادات شيخه، كما حصل مع عَلَمَيْن كبيرين من أعلام الإمامية وهما: الصدوق والمفيد، فقد ألّف الأول كتاباً أسماه "الاعتقادات"، وردّ عليه الثاني بـ "تصحيح الاعتقاد" دون أن يُخرِج أحدهما الآخر عن الدين أو المذهب.
وإنّ المثال المذكور كغيره من الأمثلة التي يلمسها الباحث لدى مراجعته لسيرة الماضين من علمائنا تكشف عن رحابة علميّة وروح موضوعية عالية هي أفضل بكثير ممّا عليه الحال اليوم، وعندما تسود الروح الموضوعية يكون الميزان هو الدليل، بعيداً عن كلِّ سهام التضليل التي يُرمى بها كلّ مَن يحاول مناقشة السائد من الأفكار والشائع من المفاهيم والاعتقادات حتى لو افتقرت إلى دليل يعضدها وبرهان يؤيّدها، أجل كان من دَأْبِ العلماء الماضين أن يقسو أحدهم على الآخر ويعنف ضده، بيد أنّ هذه القسوة تبقى في مقام البحث العلمي ولا تمتدّ إلى الواقع العملي، وكانت القسوة على الفكرة لا على صاحبها.
وأختم بذكر بعض النماذج التي تعكس الروح العلميّة والموضوعيّة التي تحلّى بها علماء المسلمين وفقهاؤهم رغم شدّة اختلافاتهم وكثرتها في تفاصيل العقيدة وفروع الشريعة:
النموذج الأول: إنّ السيد المرتضى (رحمه الله) خالَفَ أستاذه وشيخه المفيد- وكلاهما من أركان الطائفة- في ما يقرب من مائة مسألة عقائدية[8]، وقد ألّف الشيخ قطب الدين الراوندي رسالة في هذا الشأن وجمع فيها اختلافاتهما العقيدية فبلغت نحو خمس وتسعين مسألة، وقال في آخرها لو استوفيت كلّ ما اختلفا فيه لطال الكتاب[9].
النموذج الثاني: ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه عدّة الأصول عن اختلاف علماء الطائفة في الأحكام الشرعية قال: "فإنّي وجدتها- الطائفة- مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات الفرائض..." ثم يعدّد بعض اختلافاتهم ويضيف: "وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أنّ باباً منه لا يسلم إلاّ وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى"، إلى أن يقول: "حتى أنّك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينتهِ إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته!"[10].
أقول: لو شاهدت واقعنا يا شيخنا الطوسي لرأيت العجب العجاب حيث يضلّل بعضنا البعض الآخر لمجرّد رأي هنا أو فتوى هناك!
النموذج الثالث: "إنّ الخلاف في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب يقوم على اتّباع الأثر قد اتّسع للعديد من الروايات والأقوال بحيث ملأت كتاباً من اثني عشر مجلّداً هو كتاب الإنصاف في الراجح من الخلاف"[11].
من كتاب العقل التكفيري .. قراءة في المفهوم الاقصائي
[5]راجع: مسند أحمد ج3 ص14، وسنن الترمذي ج5 ص329، وكنز العمال ج1 ص173، والكافي ج2 ص415.
[6]النظرة الخاطفة في الاجتهاد للشيخ إسحاق الفياض ص11.
[7]مسالك الأفهام ج14 ص172، ونحوه ما في مجمع الفائدة ج12 ص328.
[8] مسالك الإفهام ج14 ص172.
[9]كشف المحجّة لثمرة المهجة ص64.
[11] الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرّف للشيخ القرضاوي ص161.