ظاهرة السُّباب والموقف الإسلامي منها
الشيخ حسين الخشن
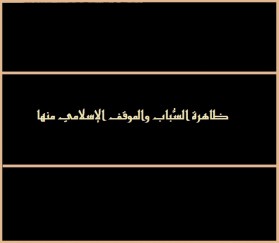
ظاهرة السُّباب والموقف الإسلامي منها
تتفشّى في مجتمعاتنا الإسلامية وغيرها عادة سيئة غدت تشكّل ظاهرة عامّة ومترسّخة في النفوس، هي ظاهرة السبّ والشتم، فأتباع هذا الدين يسبّون أتباع الدين الآخر أو مقدّساتهم، وجماعة هذا الحزب يشتمون جماعة الحزب الآخر، والزوج يشتم زوجته، والأب ابنه والأخ أخاه والأستاذ تلميذه والمدير يشتم الموظّف العادي وهكذا، فالكلُّ يشتم الكلّ وإذا لم يجد البعض من يشتمه من الناس فإنّه يتجرّأ على سبِّ الله عزّ وجلّ، أو أنبيائه وأوليائه أو بعض مخلوقاته.
وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنّية للوقوف على أسبابها، ثم كيفيّة علاجها والموقف الإسلامي منها، وفيما يلي نحاول أن نسلّط الأضواء على هذا الموضوع الهام من الناحية الاجتماعية والرسالية.
معنى السبّ
السبّ أو الشتم هو عبارة عن توصيف الآخر بما فيه إزدراءَ به بقصد إهانته، كوصفه بالحقير والوضيع، أو الكلب والخنزير والكافر والمرتدّ والخائن والملعون والفاجر إلى غير ذلك من كلمات السّباب التي نستهلكها وإذا لم تسعفنا القواميس العربية بها- رغم وفرتها- استوردنا من اللغات الأخرى شتائمها.
الأسباب
أعتقد أنّ أسباب تفشّي هذه الظاهرة تعود إلى عدّة عوامل أهمّها:
1- العامل النفسي: وهو الحقد والحسد والضغينة والعصبيّات المقيتة على اختلافها التي قد يحملها الإنسان في قلبه تجاه الآخر، فالحاقد سوف يُترجم حقده ولو بشكلٍ غير شعوري إلى شتائم وسباب للمحقود عليه، فإنّه "ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه"[1]، كما نُقل عن الإمام علي (ع).
2- العامل الفكري: وهو ضعف الحجّة والبرهان، فإنّ ذلك يدفع صاحبه إلى شتم الآخر وسبّه إيحاءً منه لنفسه وللآخرين بأنّه قويّ في الجدال والمناظرة. لكن هذا العامل لا يبتعد كثيراً عن العامل النفسي، لأنّ ضعف الحجّة يستثير غضب الإنسان وحنقه ويدفعه إلى الشتم.
3 و4- العامل الاجتماعي والسياسي: ويتمثّل ذلك بالفقر والقهر، فإنّ الفقر الاقتصادي أو القهر السياسي يملآن النفوس غضباً وحنقاً، وإذا لم يجدا متنفَّساً فإنّهما سيتفجّران ويعبَّران عن نفسيهما بكلمات الشتائم والسباب.
ولهذا فأنّ ظاهرة السباب تعكس في طيّاتها الانحطاط الأخلاقي والفقر الاقتصادي والقهر السياسي وضعف الحجّة والبرهان، لأنّ الإنسان السويّ خُلُقيّاً والقوي مادياً وسياسياً وفكرياً لا يحتاج إلى كلِّ كلمات الشتم وقواميسه.
مكارم الأخلاق والتنزّه عن السبّ
لا شك أنّ السبّ أو الشتم خُلُق قبيح ولا يرتكبه صاحب الخُلُق الرفيع، ولذا فهو مذموم في ميزان العقل والعقلاء قبل أن يكون قبيحاً في موازين الشريعة الغرّاء، والتي جاءت بمكارم الأخلاق، ومنها خُلق التنزّه عن السبّ والشتم، وقد كَثُرت النصوص القرآنية والنبوية الواردة في حرمة السبّ والنهي عنه، ونقرأ في كتب الحديث السنيّة والشيعية أبواباً خاصة تحت عنوان "باب النهي عن السباب"، كما في صحيح مسلم، أو"باب السباب"، كما في الكافي للكليني.
إنَّ الموقف الإسلامي من ظاهرة الشتم يمكن استيحاؤه من عبادة الصوم فإنّ أحد أبعاد الصوم وأعماقه ومراميه أن تتربّى الجوارح على تَرْكِ الحرام، وأهم الجوارح اللسان الذي يمكنه- رغم صِغَر حجمه وقلّة وزنه- أن يُفسد العالم كما يمكنه أن يُصلحه، وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): "صوم اللسان خير من صيام البطن"[2]، وعن الإمام الصادق (ع): "سمع رسول الله (ص) امرأة تسبّ جاريتها وهي صائمة فدعا (ص) بطعام وقال لها كُلِي، فقالت: إنّي صائمة فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك! إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب"[3].
سبُّ الله وأوليائه
إنّ أدنى مستويات الخفّة والغباء أنْ يعمد الإنسان إلى سبِّ ربّه وخالقه والمُنْعِم عليه، فيكون قد ردّ إحسانه تعالى بالإساءة وقابَلَ نِعَمه بالكفران، ومن الطبيعي أنّ هذا السبَّ لن يضرَّ الله سبحانه أو ينقص من ملكه شيئاً– كما أنّ تمجيده والثناء عليه لن ينفعه أو يزيد في مُلْكِه شيئاً- وإنّما يضرُّ السابُّ نفسه ويبتعد بذلك عن ساحة القرب الإلهي كما أنّ لجوءه إلى سبِّ الله تعالى وأوليائه يكشف عن خبث سريرته وخفّة عقله.
وإنّ حرمة الله سبحانه وقداسته تنسحب على أنبيائه وأوصيائه وأوليائه لقربهم من الله، فيكون التعدّي عليهم وانتهاك حرمتهم تعدّياً على الله وانتهاكاً لحرمته، ولذا ورد في الحديث القدسي: "مَنْ أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة أو بالعداوة"[4]، وعن النبيّ (ص): "مَنْ سبّ عليّاً فقد سبَّني ومَنْ سبَّني فقد سبَّ الله"[5]، وعن رسول الله (ص) أيضاً: "سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة"[6]، وفي الصحيح عن الإمام الباقر (ع) قال: "قال رسول الله (ص): سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر"[7].
سبُّ الآخر
في عملية التعاطي والجدال مع الآخر الذي نختلف معه مذهبيّاً أو دينيّاً يدعونا الإسلام إلى الدقّة في انتقاء كلماتنا واختيار وتحرّي الكلمة الأحسن وليس الكلمة الحسنى فحسب، قال تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}[فصلت: 34]. وينهانا عن استعمال الكلمة الخبيثة، لأنّها قد تُشفي غيظ مُطْلِقها لكنّها لن تشرح قلب الآخر إلى الإسلام ونور الهداية، وهذا عليّ (ع) يقول لنا– بحسب الرواية -: "فلا يكن أفضلَ ما نلتَ في نفسك من دنياك بلوغُ لذّة أو شفاءُ غيظ ولكن إطفاءُ باطل أو إحياءُ حقّ"[8].
وهكذا وجدنا عليّاً (ع) يتسامى في هذا المجال- كما في غيره- عندما سمع أصحابه في معركة صفّين يسبّون أهل الشام، ونحن نعرف أنّه إذا رخصت الدماء وهانت فلن يبقى للكلمة السلبيّة أيّ معنى أو تأثير، لكن عليّاً (ع) وقف ليبيّن لهم أنّ القيمة تبقى قيمةً في حالتَيْ الحرب والسِّلم، وإنّ الكلمة الطيّبة ليس لها موسم، ولهذا أرسل لأصحابه: "كفّوا عمّا بلغني عنكم من الشتم والأذى"، فقالوا يا أمير المؤمنين ألسنا محقّين؟ قال: بلى، قالوا: ومَنْ خالفنا مبطلين؟ قال: بلى، قالوا: فلِمَ منعتنا من شتمهم؟ فقال:."كرهت أن تكونوا سبّابين."[9].
وهكذا نراه نادى يوم البصرة: "لا تسبّوا لهم ذرية"[10]، وهذا خُلُق كلّ الأئمّة من أهل البيت (ع)، فقد رُوِي أنّ رجلاً سبّ مجوسياً بحضرة أبي عبد الله (ع) فزجره ونهاه عن ذلك، فقال: إنّه تزوّج بأمِّه، فقال (ع): "أما علمت أنّ ذلك عندهم نكاح"[11]، وعن الإمام الباقر (ع) قال: "إنّ رجلاً من تميم أتى النبي (ص) فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه: لا تسبّوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم"[12].
فلسفة النَّهي عن السُّباب
بالإضافة إلى ما قلناه من أنّ السبَّ خُلُقٌ قبيح وأسلوب سخيف لا يلجأ إليه إلاّ السفهاء وأنّه لا يُثبت حقّاً ولا يُزهق باطلاً، فإنّ له تأثيرات وانعكاسات سلبية على استقرار الحياة الاجتماعية، لأنّ الكلمة الخبيثة سوف تدفع الآخر وتجرِّئه على سبِّك وسبِّ مقدّساتك، كما سَبَبْتَ مقدّساته، قال تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}[الأنعام: 108]، وقد رُوِيَ عن الإمام الصادق (ع) في تفسير الآية قال: "كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون فنهى الله عن سبِّ آلهتهم لكي لا يسبّ الكفّار إله المؤمنين.."[13]. ومن الواضح أنّ السبّ والسبّ المضادّ قد يُثير الفتنة بين الأطراف المتسابّة ويخلق العداوات والعصبيّات بين الناس، وقد يفضي إلى الوقوع في سفك الدماء وانتهاك الأعراض.
وتؤكّد بعض النصوص أنّ مَنْ تسبَّب في سبّ الآخرين لله سبحانه أو سبّهم لأوليائه تعالى فإنّ وِزْرَ ذلك عليه، ففي الرسالة التي كتبها الإمام الصادق (ع) لأصحابه وأَمَرَهم بمدارستها والنّظر فيها وتعاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، جاء ما يلي: ".. وإياكم وسبّ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبّوا الله عدوّاً بغير علم... ومن أظلم عند الله ممّن استسبّ لله ولأوليائه"[14].
وفي هذا المعنى ورد أيضاً أنّ من حقوق الأبوين: "أن لا تستسبّهما بأن تسبّ أبا غيرك وأمّه فيسبّ أباك وأمّك"[15]. وعن رسول الله (ص): "إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدَيْه! قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يسبُّ الرجل أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمّه فيسبّ أمه""[16]، وفي رواية أخرى عنه (ص): "إنّ أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: وكيف يشتمهما؟ قال: يشتم أبوي الرجل فيشتمهما"[17].
إنّ هذه النصوص وسواها تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ الإسلام لا يريد أن تكون لغة السب هي التي تحكم العلاقة بالآخر، لأنّ هذه اللغة- فضلاً عن كونها لا تمتّ إلى الأخلاق بِصِلَة- لا تُثبت حقّاً ولا تدفع باطلاً ولا تفتح قلب الآخر على الحقيقة، بل تُبعده عنها أميالاً.
سبُّ الحيوانات
ويمتدُّ الأدب الإسلامي في صون اللسان وحفظه عن البذاءة إلى خارج الدائرة الإنسانيّة ليُنهى الإنسان حتى عن سبِّ الحيوانات رغم إنّها لا تعقل، ففي الحديث المرويّ عن عليٍّ (ع) والمعروف بـ حديث المناهي:" ونهى (ص) عن سبِّ الديك وقال: إنّه يوقظ للصلاة"[18]، وعن الصادق (ع): "أنّ رسول الله (ص) سمع رجلاً يلعن بعيره فقال: إرجع ولا تصحبنا على بعير ملعون، "وكان علي (ع) يكره سبّ البهائم"[19]، وعن الأصبغ بن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي (ع): "لا تسبّوها فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها (الأطعمة) عندهم، كما يخزنون الذهب والفضة"[20].
سبُّ الأيام والزمان والريح
الزمان والعصر أو العمر المؤلف من ساعات وأيام وشهور وسنين هو نعمة كبرى وآية من آيات الله تعالى، وعلينا أن نملأها بالعمل النافع والصالح، وقد أقسم الله تعالى به في كتابه ليبيّن لنا أهمّيته، فقال عزّ مَنْ قائل: {وَالْعَصْرِ}، وقال: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، إلا أنّ الإنسان الجهول وبدل أن يملأ زمانه وعمره القصير عِلْماً وحركة ونشاطاً، يحاول الهروب منه ويملّه ويشتمه ويتشاءم من بعض أيامه.
وهكذا يدخل البعض منّا في عملية سبِّ وشتم لكثير من مخلوقات الله، فيسبّ الريح عندما تؤذي زرعه وبستانه مع أنّها تحمل بشائر الخير للناس جميعاً، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}[الأعراف: 57]، ويسبُّ الشمس التي قد تؤذيه بحرارتها في بعض الأحيان متناسياً أنّها تمدّه بالضياء والنور {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً..}[يونس: 5]، وبدونها لن ينعم لا هو ولا غيره بالحياة إطلاقاً، وهكذا فإنّه يَسبُّ ويَسبُّ في مخلوقات الله الأخرى وهو يتنعّم بها ويستفيد منها، فما أجهل هذا الإنسان وأغباه!
قال النبي (ص)- فيما رُوِي عنه-: "لا تسبّوا الريح فإنّها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوّذوا من شرّها"[21].
وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق (ع): "لا تسبّوا الرياح فإنّها مأمورة ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكم"[22]. وعن أبي الحسن الهادي (ع): "أنّ رجلاً نكبت إصبعه، وتلقّاه راكب فصدم كتفه، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه، فقال: كفاني الله شرّك فما أشأمك من يوم! فقال أبو الحسن: "هذا وأنت تغشانا (تتردّد علينا)! ترمي بذنبك مَنْ لا ذنب له، ما ذنب الأيام حتى صرتم تشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها! فقال الرجل: أنا أستغفر الله، فقال (ع): والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذمّ عليها فيه، أما علمت أنَّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال فلا تعد ولا تجعل للأيام صنعاً في حكم الله"[23].
وعن رسول الله (ص): "مَنْ قال: قبح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبح الله أعصانا للربّ"[24]، وعن بعض الأئمة (ع): "لا تسبّوا الدنيا فنعم المطية الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرّ، إنّه إذا قال العبد: لَعَنَ الله الدنيا، قالت الدنيا: لَعَن الله أعصانا لربه"[25].
كيف نقابل السبّابين؟
في مواجهة ظاهرة السُّباب والسبّابين نعتقد أنّ الأسلوب الأنجع يتلخّص في:
1- المحاججة بالمنطق والبرهان: وذلك فيما لو وجد المرء آذاناً صاغية عند السّاب، وإن كان الغالب أنّ السّاب قد ختم على سَمْعِه وعقله بالشَّمع الأحمر.
2- العفو والصفح والإعراض عنه: وقول "سلاماً" له إذا كان من السُّفهاء الجاهلين، وبهذا ينأى الإنسان بنفسه عن الانحطاط إلى مستواه، وربما يثمر أسلوب العفو فيوقظ ضميره ويعيده إلى سواء السبيل، وهذا ما علَّمنا إيّاه أمير المؤمنين (ع) فإنّه كان يقابل السيّئة بالحسنة والشتيمة بالعفو، فقد روى أنّه كان جالساً في أصحابه فمرّت بهم امرأة فرمقها القوم بأبصارهم فقال (ع): "إنّ أبصار هذه الفحول طوامح وإنّ ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنّما هي إمرأة كامرأة"، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه! فوثب القوم ليقتلوه، فقال (ع): رويداً إنّما هو سبٌ بسب أو عفو عن ذنب"[26].
3- الدعاء له بالهداية: وهذا ما نتعلّمه من عليٍّ (ع) أيضاً فإنّه لمّا سَمِع أصحابه يشتمون أهل الشام قال لهم: "إنّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبّكم إيّاهم: اللهمّ احقن دماءنا ودماءهم وأَصْلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحقّ مَنْ جَهِله ويرعوي عن الغيّ والعدوان مَنْ لهج به"[27].
وأما أسلوب ردّ الشتيمة بالشتيمة أو المجاهرة بتكفير الآخر فيما لو تناول بعض مقدَّساتنا بالسبّ والهتك، فإنّه أسلوب منحطّ وقد لا يكون مُجْدِياً كثيراً، وأنّ سلبيّاته أكثر من إيجابيّاته ولا سيّما عندما نواجه به بعض المغمورين الذين تستهويهم الشهرة ولا يجدون سُلّماً للوصول إلى غاياتهم إلاّ شتم الأنبياء والتعرّض للمقدّسات، فعلينا قبل المبادرة إلى هدر دماء هؤلاء انتصاراً للمقدَّسات أن ندرس القضية جيداً ونوازن بين السلبيّات والإيجابيّات، وحينها قد نكتشف أنّ أفضل أسلوب في مواجهتهم هو أن نميت باطلهم بإهماله وترك ذِكْره.
من كتاب " العقل التكفيري .. قراءة في المفهوم الإقصائي "
10/6/2014
[2]عيون الحكم والمواعظ ص305.
[4]مجمع الزوائد ج2 ص248، الكافي ج2 ص352.
[5]كنز العمال ج11 ص602، عيون أخبار الرضا ج1 ص72.
[6]كنز العمال ج3 ص598، الكافي: ج2 ص359.
[7] كنز العمال ج3 ص598، رقم الحديث 8094- 8095، الكافي ج2 ص359.
[9] المعيار والموازنة ص137.
[10] وسائل الشيعة ج15 ص27، الباب 5 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2.
[12]بحار الأنوار ج72 ص163.
[13]وسائل الشيعة ج16 ص255، الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي، الحديث3.
[15] شرح أصول الكافي للمازندراني ج1 ص267.
[16] صحيح البخاري ج7 ص69، وراجع ما ورد في هذا المعنى أيضاً في المصنّف للصنعاني ج11 ص138.
[18]مَنْ لا يحضره الفقيه ج4 ص5.
[23] تحف العقول ص483، وعنه وسائل الشيعة ج7 ص508، الباب 16 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 3.
[25] وسائل الشيعة ج7 ص508، الباب 16 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 4.
[27] المصدر نفسه ج2 ص186.