المسلمون وثقافة اللعن
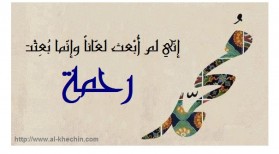
من جملة أساليب التراشق الداخلي المنتشرة في الأوساط الإسلامية أسلوب اللعن أو التلاعن المتبادل بين الناس، فكلُّ فئة تلعن الأخرى أو بعض رموزها ومقدّساتها، مع إسباغ اللعن لبوساً شرعيّاً وتبريره بمبرّرات "دينية" والتلاعن المذكور- في العمق- ليس مجرّد كلمات طائرة في الهواء يردّدها مُطْلقُها بلسانه، بل إنّه تعبير لفظيّ ينطلق من نزعة عدائية توغل في إسقاط الآخر ونزع الحرمة والقداسة عنه.
فما هو اللعن؟ وما هي مخاطره؟ وهل هناك لعن محرّم وآخر مباح ومقدّس؟
معنى اللعن
إنّ المعنى اللغوي[1] للعن هو الطرد والإبعاد، وعندما يضاف إلى الله يأخذ معنى دينياً هو طرد الملعون من ساحة الرحمة الإلهية، فقوله تعالى: {لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ}[النساء: 46]، معناه: أبعدهم وطردهم من رحمته، وإذا ورد في سياق الدعاء على الآخر، مثل "اللهم العن فلاناً" فيُراد به الطلب من الله أن يطرده من رحمته وعنايته، ويُبعده عن ساحة قُدْسِه ومحبَّتِه.
مخاطر اللعن
إنّ اللعن- كغيره من أساليب الطعن والغمز بالآخر- يخلق العداوة والبغضاء بين الناس، ويوتّر العلاقات بينهم، الأمر الذي يفرض مزيداً من الحذر في الاسترسال فيه، فكم من لعنة أعقبت فتنة وأورثت حسرة، ولهذا السبب قد حذّر الإسلام من إطلاق العنان للّسان في النيل من كرامات الناس والمسّ بأعراضهم، معتبراً أنّ كل كلمة تصدر من الإنسان فهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، ويعاقَب عليها مهما كانت صغيرة، فلا ينبغي الاستخفاف بكلمات الشتم واللعن واستصغارها، فقد ورد في بعض الأحاديث: "هل يكبُّ الناسَ على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم"، وفي الحديث عن رسول الله (ص): "إن استطعت أن لا تلعن شيئاً فافعل، فإنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها فكان الملعون أهلاً لها أصابته، وإن لم يكن أهلاً لها رجعت عليه.."[2]، وعن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال: "إنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن، فإن وجدت مساغاً وإلا عادت إلى صاحبها وكان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحلّ بكم"[3].
المؤمن لا يكون لعّاناً
إنّ المستفاد من التعاليم والآداب الإسلامية أنّ اللعن من حيث المبدأ ليس من خُلُقِ المؤمن في شيء، فالمؤمن لا ينبغي أن يكون لعاناً وآخذاً بهذا الأسلوب خائضاً فيه في صغائر الأمور وكبائرها، ومطلقاً للسانه العنان في لعن هذا وذاك.. في الحديث عن رسول الله (ص): "إنّي لم أُبْعث لعّاناً وإنّما بُعِثْت رحمة" وفي حديثٍ آخر عنه (ص): "لا يكون المؤمن لعّاناً"[4]، ويروى أنّ عبد الملك بن مروان كان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه، وقد سمعته ذات يوم يلعن خادمة له، فقالت: لا تلعن، فإنّ أبا الدرداء حدّثني عن رسول الله (ص): "إنّ اللعّانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء"[5].
لَعْنُ المخلوقات
إنّ اللعن تارة يطال الإنسان وأخرى يطال غيره من مخلوقات الله كالحيوان أو الزمان أو المكان أو الريح أو غيرها، وإذا أخذنا النحو الأخير من اللعن بعين الاعتبار وهو لعن المخلوقات الأخرى غير الإنسان، فنستطيع القول: إنّه لمن المستغرب حقّاً أن يصبّ المرء لعناته على الزمان أو المكان أو الحيوان أو الرياح أو سواها من مخلوقات الله، فإنّ هذه ليست سوى ظروف ووسائل لحركة الإنسان يلزمه استثمارها فيما يصلح شأنه ويرضي ربه، وليست مصدراً للشرور والمصائب والمتاعب، ليصبّ جام غضبه عليها ويأخذ بلعنها أو سبّها أو يتشاءم منها أو يرميها بالنحوسة أو ما إلى ذلك.
عن رسول الله (ص): "لا تلعن الريح فإنّها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه"[6]، وقد سمع (ص) رجلاً يلعن بعيره، فقال: "إنزل عنه فلا تصحبنا بملعون"[7].
لَعْنُ المؤمن كقتله
إذا كان لعن الحيوان منهيّاً عنه، فالأولى أن يكون لعن الإنسان المؤمن مبغوضاً عند الله، وقد ورد في بعض الروايات عن رسول الله (ص): "لعن المؤمن كقتله"[8]، ولعلَّ وجه هذا التشبيه أنّ الاعتداء المعنوي على المؤمن لا يقلّ خطراً وضرراً عن الاعتداء المادي عليه، وإن فسق المؤمن ووقوعه في المعصية لا يُسقط حرمته وبالتالي فهو لا يبرّر لعنه، ولذا نهى النبيّ (ص)- فيما رُوِيَ عنه- عن لعن نعميان الأنصاري الذي كان يؤتى به إليه مراراً فيحدّه في معصية ارتكبها، إلى أن أُتِيَ به مرة فحدّه، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يُؤتى به رسول الله! فقال (ص): "لا تلعنه فإنّه يحبّ الله ورسوله"[9].
اللعن المبرّر!
هل يُفهم من هذا الكلام أنّ لعن غير المؤمن جائز؟ مع الالتفات أنّ كلّ فرقة تحتكر الإيمان لجماعتها، ثم ماذا عن لعن الشخص الذي لا نلتقي معه في الدين؟
يظهر من الفقهاء تجويز لعن غير المؤمن وغير المسلم ويستندون في ذلك إلى بعض النصوص والروايات المتفرّقة، ممّا لا يَسَع المقام لاستعراضها وملاحظتها تفصيلاً، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل جملة من الملاحظات العامّة حولها:
ليس كلّ كافر يستحق اللعن
وأولى هذه الملاحظات هي: أنّه لا دليل على أنَّ كلّ مَن لم يكن مؤمناً فهو يستحق اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله، فربما كان الكافر أو غير المؤمن معذوراً، لجهله القصوري أو غفلته عن الحقّ، والله سبحانه لا يبعد رحمته إلا عن المعتدين والمعاندين والمقصِّرين، قال سبحانه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ}[المائدة: 78] وقال سبحانه: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ..}[المائدة: 13]، وانطلاقاً من هذا المبدأ قال بعض الفقهاء: "لا يجوز لعن مَن لا يستحقّ العقوبة من الأطفال والمجانين والبهائم، لأنّه تعالى لا يبعد من رحمته من لا يستحقّ الإبعاد عنها"[10].
إنّنا نتساءل: إذا كان المسلمون أمّة واحدة وأخوة في الدين والإيمان، فكيف يجوز للمسلم أن يلعن أخاه؟! إنّ الأخوّة- كما أسلفنا في الفصل الأول- تضفي على جميع المنضوين تحتها حرمةً وعصمةً في أنفسهم وكراماتهم وأعراضهم وأموالهم وإلّا كانت عداوة لا أخوّة، كما أنّ التلاعن بين المسلمين يمزِّق وحدة الأمّة ويُشرذمها، وإنّ كلَّ دعوات الوحدة وجهود الوحدويّين سوف تتبخّر أمام الفتاوى التي تُبيح لعن الآخر.
ولو انطلقنا إلى الدائرة الإنسانية الأوسع لحقّ لنا أن نتساءل: ألا يشكِّل لعن الإنسان الآخر اعتداءً معنويّاً على إنسانيّته وهتكاً لحرمته ونيلاً من كرامته؟!
وهل إنّ اللعن هو من الدفع بالتي هي أحسن أو من البرّ والإحسان الذي أمرنا الله بأن ننتهجه في التعامل مع المسلمين وغيرهم؟! قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة: 8].
ثم إنّه لا دليل على أنّ كلّ كافر يستحقّ اللعن والطرد من رحمة الله، ومن هنا كان بعض العرفاء من مشايخ الإمام الخميني ينهى عن لعن الكافر إلا إذا عُلم أنّه مات على الكفر، وينقل السيد الإمام كلامه هذا على سبيل التأييد والموافقة له، فيقول: "كان شيخنا العارف (روحي فداه) يقول: "لا تلعن أحداً أبداً حتى الكافر الذي لا تعلم أنّه مات كافراً إلا إذا أخبر المعصوم عن حاله بعد الموت، إذ لعلّه آمن أثناء موته، إذن لا تلعن أحداً بشكلٍ عام.."[11]، والمنع من لعن الكافر المعين لأنّا لا ندري بما يختم له قد أقتى به جمع من علماء المسلمين[12]
بين لَعْن الشخص ولَعْن العنوان
والملاحظة الثانية: إنّ المتأمّل في الآيات القرآنيّة المشتملة على ألفاظ اللعن يلفت انتباهه أمر هام وهو توجيه اللعن فيها إلى العنوان العام- عنوان الظالم أو الكافر- لا إلى الأشخاص بأعيانهم وأسمائهم- باستثناء إبليس- وهذا الأسلوب (لعن العنوان) يخفف من نتائج اللعن السلبية، لأنّه مع عدم تسمية أشخاص بأعيانهم فإنّ ذلك لا يوجب الاستفزاز للآخرولا يخلق مشكلة كبيرة معه، قال تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: ]، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً}[الأحزاب: 64]، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}[الأحزاب: 57]، وقال عزّ مَنْ قال: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}[الرعد: 25]، نعم من الملحوظ أنّ الله تعالى قد لَعَن اليهود في أكثر من مورد بسبب أفعالهم السيّئة قال تعالى: {... وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ}[النساء: 46].
أما إبليس فقد لعنه الله بشخصه، قال تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ}[الحجر: 35]، أجل هناك دعاء بالهلاك والخسران توجّه إلى شخص بعينه وهو أبو لهب، وذلك ما ورد في قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}[المسد: 1] والأمر الذي لاحظناه في الآيات القرآنيّة هو الشائع في الروايات وقد تقدَّم بعضها، وأما ما جاء من لعن الأشخاص بأعيانهم فهو يحتاج إلى ملاحقة ودراسة متأنّية تفصيليّة، والأمر الأكيد أنّ بعضه غير صحيح سنداً كما في بعض الأدعية والزيارات[13]، كما أنّ بعضه الآخر على فَرْض صحّته لا يدلّ على جواز اللعن، لأنّه في مقام الإخبار عن كون بعض الأشخاص مطرودين من رحمة الله، مع أنّ المصلحة العامة قد تقتضي فضح بعض المخادعين أو المعاندين والضالّين المضلّين، وبيان أنّهم ملعونون ومطرودون من رحمته تعالى حتى لا يتأثّر بهم عامة الناس[14]، ولا يأخذوا منهم معالم دينهم.
اللعن بين الإخبار والإنشاء
والملاحظة الثالثة في هذا المجال هي: ضرورة التفريق بين ورود اللعن في سياق الإخبار ووروده في سياق الإنشاء، فعندما يرد اللعن في كلام الله تعالى أو رسوله (ص) بحق بعض الجماعات أو الأشخاص، فعلينا التدقيق فيه ملياً، إذ ربّما كان ذلك إخباراً عن واقع حال الملعون وأنّه مطرود عن ساحة الرحمة الإلهية بسبب كفره أو عصيانه، وهذا لا يبرّر للآخرين إنشاء لعنه بالدعاء أو نحوه، لأنّه لا ملازمة عرفية بين الأمرين، ففساد عقيدة المرء وبُعْدُه عن مواقع رحمة الله أمر، وتجويز الإساءة المعنوية له بلعنه وشتمه أمر آخر.
ولهذا عندما نقرأ في الروايات تعابير: "لعن الله مَنْ عَمِلَ عَمَل قوم لوط"، أو "لعن مَن ادعى لغير أبيه" أو "لعن الراشي والمرتشي والماشي بينهما" أو نحوه، فإنّ ذلك قد لا يكون إنشاءً للعن من قبل النبي (ص) أو الإمام (ع) ليستفاد منه جواز لعن هؤلاء، وإنّما قد يكون إخباراً وحكاية عن حقيقة هؤلاء وواقع أمرهم، وأوضح من ذلك التعبير بـ "ملعون" كما في الرواية المروية عن رسول الله (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"[15] أو الحديث المرويّ عن أبي عبد الله (ع): "المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون وآكل كسبها ملعون"[16]، أو الحديث المرويّ عن رسول الله (ص) أيضاً: "ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون من عقّ والديه، ملعون ملعون مَن لم يوقّر المسجد"[17] فإنّ قوله: "ملعون" في هذه الموارد ظاهر في الإخبار أكثر منه في الإنشاء.
اللعن والسُّباب
والملاحظة الرابعة التي لا بدّ أن نسجِّلها في هذا المجال هي أنّ اللعن قد غدا في كثيرٍ من الحالات- بحسب الفهم العرفي- مصداقاً للسبّ، وقد أسلفنا أنّ السبّ خُلُق ذميم وعمل قبيح ومرفوض شرعاً، فعندما يقال إنّ فلاناً لعين أو ملعون فهي كلمة تختزن معنى السبّ والشتم، وهذا ما يظهر من عبارات أهل اللغة، ففي كتاب العين للفراهيدي: "واللعين: المشتوم المسبوب"[18].
اللعن يجرّ اللعن
والملاحظة الخامسة والأخيرة في هذا الصدد، هي أنّ اللعن لو سلّمنا أنّه ليس محرّماً بعنوانه الأوّلي، فإنّ انطباق بعض العناوين الثانوية عليه يقتضي تحريمه والمنع منه، ومن الواضح أنّ لعن الرموز والقادة الذين يقدِّسهم الآخر ويحترمهم يدفعه إلى المعاملة بالمثل مع الرموز التي يقدسها اللاعن، ولو كانت رموزاً تمثّل الحقّ والصدق وتحمل القيمة الكبرى، ولذلك نهى الله سبحانه عن سبِّ آلهة المشركين لئلا يسبّوا الله تعالى، ولا فرق بين السبّ واللعن من هذه الجهة، فإنّ المناط الموجود في السب موجود بعينه في اللعن، فكما أنّ السب يجر السب فإنّ اللعن يجر اللعن أيضاً.
ومن العناوين الثانوية التي لا بدّ أن تلحظ في المقام، إذ ربما توجب تغيير حكم اللعن في موارد إباحته: عنوان اصطباغ الجماعة المؤمنة أو خطّ أهل البيت (ع) بصبغة اللعانين، ليتحوّل ذلك إلى صفة عامّة لهذا الخطّ وأتباعه بما يُوجِب نفرة الآخرين من أتباع هذا الخطّ بحجّة أنّهم يلعنون الصحابة أو ما إلى ذلك، فالإصرار على لعن الآخرين واتّخاذ اللعن شعاراً مع المجاهرة به وإطلاقه من خلال المنابر الإعلامية العامّة قد أدّى إلى أن تصبح السِّمة العامة التي يحملها الكثيرون عن أتباع أهل البيت (ع) أنّهم لعّانون، الأمر الذي أساء إلى صورة الخطّ برمّته.
كما أنّ لعن الآخر أو مقدّساته قد يجرّ إلى فتنة عمياء ويخلق ردّات فعل غير محسوبة العواقب، ويضعف الساحة الداخلية ويفقدها مناعتها، وإذا كان النبي (ص) يقول كما في بعض الروايات: "لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر"[19] فكيف بإيذاء المسلم بشتم المسلم أو بلعنه! وعنه (ص): "ما بال قوم يؤذون الأحياء بشتم الأموات! ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات"[20]، فإنّ هؤلاء الأموات قد لا يكون لهم قدسية ذاتية تمنع من لِعْنهم، ولكن ينبغي ترك ذلك تجنّباً لإيذاء الأحياء وردّات فعلهم.
آن الآوان لإعادة النظر- إن لم نقل الإقلاع- في أساليب اللعن والطعن والهمز واللمز والهتك والفتك، ممّا شاع استخدامه في تعاطي المسلمين مع بعضهم البعض ومع بعض الرموز المثيرة للجدل، فإنّ لغة التلاعن والسُّباب لا تثبت حقّاً ولا تُزْهق باطلاً ولا تقنع أحداً، بل إنّها تصدّ عن الحقّ والحقيقة، وتشكِّل حاجزاً في وجه العمل الدعوي والتبليغي، وهذا الكلام لا يشكّل دعوة إلى تمييع الحقائق أو التسوية بين الظالم والمظلوم على طريقة ذلك الشخص الذي كتب على ضريح الصحابي حجر بن عدي: "هذا قبر سيدي حجر بن عدي رضي الله عنه قتله سيدي معاوية رضي الله عنه" إنّنا نرفض تزييف التاريخ وندعو إلى قراءته بعين النقد، ومحاكمة رموزه ورجالاته بكلِّ موضوعية وإنصاف، لكن بعيداً عن كلِّ أساليب التمويه أو التجريح.
التبرِّي لا ينحصر باللعن
وربّما يدافع البعض عن شرعية السبّ بل وضرورته العَقديّة لأنّه يعبّر عن التزام المؤمن بواجٍب ديني، ألا وهو ضرورة التبرّي من أعداء الله تعالى، إذ لا يكفي في الإيمان أن تتولّى أولياء الله تعالى، وإنّما عليك أن تتبرّأ من أعدائه وأعداء رُسُله، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم في العديد من آياته في دعوته إلى ضرورة التبرّؤ من أعداء الله قال تعالى: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ}[التوبة: 114]، وقال تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[الممتحنة : 9]، وقال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ...}[الحشر: 22]، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن.
ولكن ملاحظتنا على هذا الكلام بأنّ التبرّي من أعداء الله أو عدم تولّيهم لا ينحصر باللعن، فيمكن التعبير عنه بإعلان الموقف الواضح من جبهة الكفر أو من الخط المنحرف والضالّ، ورفض أفكارهم ودحض حُجَجهم وشبهاتهم.
من كتاب " العقل التكفيري . قراءة في المفهوم الاقصائي "
[1]قال ابن منظور: "واللعن: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله"، انظر: لسان العرب ج12 ص292، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، 1999م.
[3] قرب الأسناد ص10، وعنه بحار الأنوار ج69 ص208.
[9]المحجة البيضاء ج8 ص70.
[10]تفسير التبيان ج3 ص609.
[11] سيماء الصالحين للشيخ رضى المختاري ص212.
[12] انرظر: فيض الغدير في شرح الجامع الصغير ج2 ص534، وتفسير ابن كثير ج1 ص207.
[13]راجع ما قاله آية الله الصافي في كتابه "مع الخطيب في خطوطه العريضة" بشأن بعض الأدعية المتضمنة للعن، ص: 91- 92.
[14]ولعلّ من هذا القبيل ما ورد في لعن أبي الخطاب، انظر: معاني الأخبار ص389، واختيار معرفة الرجال ج2 ص490 و584.
[15] سنن الدارمي ج2 ص249.
[16] وسائل الشيعة ج17 ص143 الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
[17]المصدر نفسه ج16 ص181 الباب 41 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 7.
[18] انظر: ترتيب كتاب العين ج3 ص1642.
[19]مستدرك الحاكم ج1 ص385، وقال عنه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه"، يقصد الشيخين: مسلم والبخاري.