مَنْ ينطق باسم الدين؟
الشيخ حسين الخشن
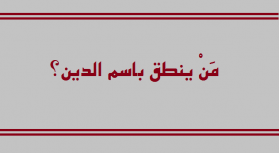
مَنْ ينطق باسم الدين؟
هل الخطاب الديني حِكْرٌ على طائفة وجماعة محدّدة وهم علماء الدين؟ أو أنّه يتاح لجميع أتباع الدين- أيّ دين- أن يتكلّموا باسم الدين الذي ينتمون إليه وعظاً وإفتاءً، تأليفاً وتحقيقاً؟ فيكون من حقِّ المسلم أن يتحدّث باسم الإسلام، ومن حقّ المسيحي أن يتحدّث باسم المسيحية وهكذا؟ وما هي الضوابط أو الشروط التي يلزم توفّرها في القائمين على الخطاب الديني ليكون منسجماً وسليماً وهادفاً؟
الكلُّ ينطق باسم الدين!
غير خفيّ أنَّ الخطاب الديني تتجاذبه في الواقع أطراف متعدّدة ومدارس متنوّعة في ثقافتها وأسلوبها ومنطلقاتها وأهدافها، والذي أعتقده أنّ أحد سُبُل مواجهة الموجات التكفيريّة التي تجتاح عالمنا العربي والإسلامي تفرض وتحتّم تواجد مجموعة من الضوابط والمواصفات في الناطقين باسم الدين إفتاءً أو وعظاً، تعليماً وتدريساً، وأولى هذه الضوابط هي أن يكون المتحدِّث باسم الدين مزوّداً ومسلَّحاً من العلم والمعرفة بما يؤهّله للحديث عن الدين، وقد قال الله سبحانه: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}[الإسراء: 36].
وقال تعالى: {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ}[آل عمران: 66]، وقال الإمام الباقر (ع) في الخبر الصحيح: "مَنْ أفتى بغير علم ولا هدىً لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر مَنْ عمل بفتياه"[1].
وإذا أخذنا بعين الاعتبار سِعة وعمق المعارف الدينية، لاسيّما الإسلامية، باعتبار أنّ الإسلام هو عقيدةٌ وشريعةٌ ومنهج حياة متكامل، يكون من البديهي لزوم توفير وإعداد جماعة معيّنة تتخصّص في المعارف المذكورة وتكون مرجعاً للأُمة في هذا الشأن، وذلك في ظل عدم تمكّن جميع الناس من التخصّص والاجتهاد في القضايا الدينية، بل عدم منطقية ذلك، لأنّ من اللازم أن تُوزِّع الأُمة جهودها وطاقاتها في شتى الميادين والتخصصات التي يحتاج له الاجتماع الإنساني في عملية نهوضه وتطوّره وتكامله، وهذا ما أشارت له الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[التوبة: 122]، وقال سبحانه: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[آل عمران: 104].
ومن الطبيعي بعد هذا أن يؤخذ الدين في عقيدته وشريعته ومفاهيمه من أهل الاختصاص، عملاً بالقاعدة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم، والتي أرشد إليها القرآن بقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7].
إلاّ أنّ واقع الأُمّة مغاير لذلك تماماً، حيث نشهد فوضوية شاملة في هذا المجال، فالكل يتكلم باسم الدين، سواءً مَن كان أهلاً لذلك أو مَن ليس أهلاً له، وهكذا يكثر المفتون والناطقون باسم الإسلام، وأخطر ما نواجهه في هذا المجال تصدّي جماعة من المراهقين في العلوم الإسلامية لاسيّما من ذوي النزعات التكفيرية للإفتاء في صغار الأمور وكبارها، فتراهم يُحلّلون ويُحرّمون ويكفرون ويضلّلون ويهدرون دماء الأعداء والأصدقاء، المجرمين والأبرياء متجاوزين بذلك أكابر الفقهاء وذوي الحلّ والعقد، وبذلك أدخلوا الأُمة في نفق مظلم لا يعلم منتهاه إلا الله.
وإنّنا نلاحظ أنّ كلّ العلوم والتخصّصات قد تُخترق وينتحلها المتطفّلون، ففي مجال الطبّ- مثلاً- نجد أطباء ومتطبّبين ودعاة طبّ وهكذا في سائر العلوم، ولكن رغم ذلك، لا يصل الأمر إلى درجة الظاهرة المخيفة، لاسيّما في ظلِّ وجود رقابة وضوابط قانونية تَحُول دون استفحال المشكلة، أما في المعارف الدينية فالأمر مختلف تماماً، فالمتطفّلون كثر، و"انتحال الصفة" يصل إلى درجة الظاهرة، ويعزّز ذلك غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة في ظلّ عدم الالتزام بضوابط محدّدة ودقيقة في عملية الانتساب إلى "السلك الديني"، وهو ما سهّل الطريق وفتح الباب أمام الكثير من المخادعين والكسالى الذين يعتاشون باسم الدين والغيب، وكانت نتيجة ذلك كلّه ما نراه من كثرة الدكاكين المفتوحة باسم الدين و"العلم الروحاني" وقراءة الأكفّ والفناجين .. وتصل الفوضى في هذا المجال إلى مستوى أن يصبح الحقل الديني شرعة لكلّ وارد، ومرتعاً لكلّ شارد، فلا يتورّع حتى البقّال أو القصّاب أو راعي الماعز والأبقار- مع احترامنا لأشخاصهم- من أن يُدلي كلّ بدلوه في مختلف القضايا الدينية، مع أنّه قد لا يملك ألف باء الإسلام.
ولهذا، يكون لزاماً على كلّ الحريصين على الإسلام السعي لوضع حدٍّ لهذا الفلتان وهذه الفوضى، والعمل على تثقيف الأُمّة على احترام التخصّصات، لأنّ الأُمّة التي لا تحترم التخصّصات العلمية هي أُمّة لا تحترم نفسها، ولن توفّق في عملية النهوض، وكيف تنهض أُمّة يغدو كلّ فرد من أفرادها فقيهاً وطبيباً ومهندساً وفلكياً .. في آنٍ واحد، على الرّغم من اتجاه العالم إلى التخصّص حتى في فروع محدّدة من كلِّ علم من العلوم المذكورة، لصعوبة الإلمام بجوانب كلّ هذا العلم!
مساءلة الفقيه ومناقشته
ما تقدّم من حديث لا يُشكّل- في كلِّ الأحوال- دعوةً إلى كمّ الأفواه وإسكات الأصوات، وإنّما هي دعوة إلى احترام التخصّصات، كما أنّ ذلك ليس دعوة للتسليم المطلَق والانقياد الأعمى للناطقين باسم الدين، فقهاء كانوا أو وعّاظاً ومرشدين، فمن حقّ كلّ مسلم أن يسأل الفقيه والعالم، ويناقش في الأمر بكلِّ موضوعية ما دامت المسألة في دائرة القضايا الاجتهادية، نعم ليس لأحد من الناس أن يُفتي في ما لا يملك عِلْمه أو يتمرّد على ما قامت الحُجّة الشرعية عليه، وقد كان المسلمون من صحابة النبيّ (ص) أو أصحاب الأئمّة (ع) يسألون ويناقشون النبيّ (ص) أو الإمام (ع) رغم عصمته، وكان هو يتقبّل ذلك بكلّ رحابة صدر، وفي الخبر الصحيح، أنّ زرارة، وهو من أجلّاء أصحاب الإمامين الباقر والصادق (ع) دخل على الباقر (ع) بصحبة رجل آخر وقال له: إنّا نقيس الناس بالمطمار أو التر (وهو خيط دقيق للقياس الهندسي) فمن وافقنا من علويّ أو غيره تولّيناه، ومن خالفنا من علويّ أو غيره برئنا منه، فقال له الإمام: يا زرارة: قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عزّ وجلّ: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً}[النساء : 98]؟ أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ يقول زرارة: فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتى كان يسمعه مَنْ على باب الدار![2].
إنّ ما نستوحيه من ذلك أنّ على الأُمّة أن لا تكون مجرّد أُمة متلقّية تصفِّق لما تسمع، بل عليها أن تقوم بمراقبة ومحاسبة الأشخاص الذين ينطقون باسمها واسم الدين الذي ينتمي إليه أبناؤها، لأنّ البعض من هؤلاء قد يُسيئون أكثر ممّا يحسنون.
احتكار الخطاب الديني
وما ذكرناه من ضرورة احترام التخصّصات وأن لا يتكلّم المرء في ما لا يملك علمه، لا يعني أنّ الفكر الديني حِكْرُ على طبقة معيّنة أو على جهاز كهنوتي خاصّ هو المخوّل أن ينطق باسم الدين أو يحتكر فهم النص وتفسيره، كما يخال البعض ويتوهّم، وربّما نظّر لذلك سعياً لرفض كلّ محاولة لتفسير النصّ الديني تأتي من خارج المؤسّسة الرسمية الدينية. نعم، القضية كلّها أن يتكلّم المرء بعلم ووفق القواعد المسلّمة، سواء كان من داخل المؤسّسة المذكورة أو من خارجها. وعلى ضوء ذلك يمكننا القول:
1- إنّ كل مسلم مأذون، بل مدعوّ- بحدود ما يعرف- إلى تبليغ الدين والتبشير به في عقيدته وشريعته ومفاهيمه، مبتدئاً بأسرته وأقرب الناس إليه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}[التحريم: 6]، وقال سبحانه: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}[الشعراء: 214]، وتالياً بكلّ الناس من حوله، سواء كان هذا المسلم من داخل المدرسة التقليدية أو من خارجها، معمَّماً أو غير معمَّم، تاجراً أو طبيباً أو مهندساً أو غير ذلك. والحقيقة أنّ الروح الرساليّة هي التي كانت سبباً في نجاح المسلمين الأوائل في نَشْرِ الدعوة الإسلامية في الكثير من الأقطار. وتُشير المصادر إلى أنّ التجّار المسلمين كان لهم الدور المباشر والأساسي في نشر الإسلام في دول جنوب شرق آسيا والصين وغيرها، وكان المحرِّك الرئيسي لهم هو روح المسؤوليّة والحسّ الرسالي، وليس دافع المهنة وأداء العبء الوظيفي، كما أصبح عليه الحال في أيامنا هذه، وخلافاً لما عليه البعض من أتباع الديانات الأخرى، حيث نجد أنّ الأطباء المسيحيّين- وليس الرهبان فقط- يقومون بمهمّة التبشير الديني، وما ذكرناه لا يتنافى مع فكرة تأسيس معاهد مختصّة ومعنيّة بإعداد وتأهيل مبلّغين ومرشدين يتفرّغون للوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله والقيم السماوية.
2- إنّه ليس كلّ مَنْ يرتدي زيّ علماء الدين مخوّلاً للتكلّم في مختلف القضايا الدينية- كما قد يُخيّل إلى بعض الناس- والمطلوب منه أن يحترم علمه، فلا يتحدّث إلاّ في حدود ما يعلمه، ولا يستحي لو سُئِل عمّا لا يملك علمه أن يقول: لا أعلم، ففي الحديث عن أمير المؤمنين (ع): "مَنْ تَرَكَ قول لا أدري أُصيبت مقاتله"[3].
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الإفتاء بغير علم المنهي عنه لا يقتصر على قضايا الحلال والحرام وغيرها من الأحكام الشرعية، بل يتعدّاه إلى المفاهيم الإسلامية أيضاً، من قبيل مفهوم الزهد والعزلة أو الانفتاح على الآخر.. وهذا ما يغفل عنه الكثير من الوعّاظ والخطباء، فتراهم يتكلّمون بحريّة شبه تامّة في المفاهيم الإسلامية، ويتحدثون فيها بضرسٍ قاطع فيقولون أو يكتبون عن رأي الإسلام في الزهد أو العزلة، أو نحوها من المفاهيم الإسلامية، مع أنّ هذا شكل من أشكال الإفتاء، وهو يحتاج إلى استنباط من الكتاب والسنّة، كما هو الحال في الأحكام الفقهية، وبالتالي فكل من لا يملك ثقافة الكتاب والسنّة، فعليه أن يرجع إلى العالم بذلك ويعتمد على قوله وفهمه.
من كتاب " العقل التكفيري . قراءة في المفهوم الاقصائي "
[1]وسائل الشيعة ج27 ص21 الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 1.