الخطاب الديني بين المصطلحات الموروثة والمستوردة
الشيخ حسين الخشن
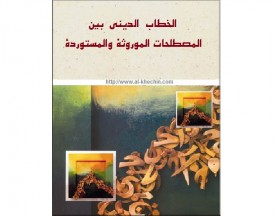
الخطاب الديني بين
المصطلحات الموروثة والمستوردة
هل للإسلام لغة خاصة وألفاظ معيّنة يدعو أتباعه إلى التقيّد بها في مقام التعبير والمحاورة؟ وما هو الموقف الإسلامي من استخدام مصطلحات الآخرين الوافدة علينا؟ وهل يمكننا هَجْر بعض المصطلحات الإسلامية وسَحْبها من مقام التداول إذا أصبحت تَحْمِل إيحاءً سلبياً بفعل بعض الظروف الطارئة؟
لا تعبّد في المصطلحات
قد يُخيَّل إلى البعض أنّ للإسلام قاموسه الخاص ومصطلحاته المحدّدة التي لا يسمح لأتباعه بتجاوزها في عملية التخاطب أو الدعوة إلى الله سبحانه، ولهذا يتقيّدون بألفاظ الكتاب والسنّة، وقد ذكر الشيخ الطوسي (قده) في مقدّمة كتاب "المبسوط"، أنّ الكتب الفقهية لعلماء الشيعة كانت تُصاغ بنصوص الروايات، حتى لو أنّ مسألة غُيّر لفظها وعُبِّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد، لتعجّب عامة الناس من ذلك.
ولكنّنا نعتقد أنّ التقيّد بألفاظ محدَّدة مستقاة من الكتاب والسنّة لا أساس شرعيّ له ولا دليل يعضده، وذلك لأنّ حال الخطاب ليس كحال العبادة القولية المتقوّمة بألفاظ معيّنة توقيفيّة لا يسمح بإنقاصها أو الزيادة عليها (من قبيل: القراءة والذكر في الصلاة وهكذا الأذان والإقامة ونحوها ويندرج في ذلك ألفاظ الطلاق والنكاح على رأي فقهي وكذا ألفاظ الظهار ونحو ذلك)، فلا يوجد تَعبّد في المصطلحات أو حَجْر على الألفاظ أو عقدة من اللغات، وذلك لأن "قيمة الكلمة تتمثّل في عطائها الفكري وفي تجسيدها للمعنى الذي يراد التعبير عنه بها، ولا تحمل أيّة قيمة ذاتية. وإنّنا نؤمن بأنّ الكلمات تموت كما يموت الأشخاص، وقد تصاب بالتشويه كما يصاب بالتشويه كثير من الناس، وقد تحيا بعض الكلمات فتبعث من بعد موت... ونؤمن بأنّ احتضان الدين لأيّة كلمة في نصوصه الدينية أو في تصريحات قادته، لا يعني قداسة الكلمة أو اعتبارها جزءاً من شخصية الدين..."[1].
وممّا يؤيّد عدم قداسة الألفاظ في حدّ ذاتها حتى لو تكلم بها القديسون، أنّ الأنبياء لم يُبعثوا ليكونوا نحاة أو أصحاب معاجم لغوية، بل بُعثوا ليكونوا هداةً وأصحاب رسالة سماوية، ولذا كانوا يخاطبون الناس بنفس اللغة السائدة بينهم {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ}[إبراهيم: 4]. ولذا وجدنا أنّ علماء المسلمين في العصر الأول قد استخدموا المصطلحات اليونانية أو ذات الأصل اليوناني في علمَي الكلام والفلسفة ولم يجدوا غضاضة في ذلك، بل استوعبوا هذا الإرث الإنساني ووظّفوه في خدمة دينهم ومعتقداتهم.
وانطلاقاً من ذلك كان بعض العلماء[2] يرى أنّ التعبير عن الإنسان بأنّه ابن الله كما جاء في بعض الكتب السماوية ليس بالضرورة أنّه يمثّل تحريفاً في ذلك الكتاب انطلق لخدمة بعض العقائد الدينية التي تنظر للمسيح على أنّه ابن الله، بل ربّما كان تعبيراً صحيحاً وَرَدَ على نحو المجاز، وإنْ أُسيء فهمه فيما بعد عند أتباع تلك الديانة.
موقفنا من المصطلحات الوافدة
وعلى ضوء ذلك، لا نرى مانعاً من استخدام المصطلحات الوافدة علينا من لغات أخرى، سواء في المجالات العلمية أو القانونية أو السياسية أو غيرها، وقد تحدّث العلماء والمفسّرون عن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية من قبيل "أسباط، آزر، زنجبيل، سجّل، سجّيل، سرادق... وغيرها"[3]. وربما يكون تعبير أمير المؤمنين (ع): "اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً" أو قوله: "نورزونا كل يوم"، وذلك بعد أن قُدِّمت له هدية، فسأل عن السبب فقالوا: إنّ اليوم هو يوم النيروز، خير شاهد على عدم وجود عقدة إسلامية من مصطلحات الآخرين، على الرغم ممّا تحمله الكلمة المذكورة من مضمون شعائري لم يقره الإسلام وهو عيد "النوروز" الفارسي.
وقد اشتهرت بين الفقهاء عبارة تعكس هذه الذهنية المنفتحة، وهي جملة "لا مشاحة في الاصطلاح".
ضرورة رصد المصطلحات الوافدة
وهذا الموقف المبدئي المرن الذي لا يتعقَّد من مصطلحات الآخرين ولا يتّخذ موقفاً سلبياً شاملاً منها، لا يعفينا من مهمة رصد كلّ الكلمات الوافدة التي يراد لها أن تدخل قاموس التداول كمصطلحات مقررة، وذلك بغية التدقيق في مداليلها وإيحاءاتها، فإن كانت منسجمة مع المفاهيم الإسلامية، أو على الأقل غير متنافية معها، فلا غضاضة في استخدامها والأخذ بها، أما إذا كانت تختزن بعض المعاني التي لا تنسجم مع المفاهيم الإسلامية، فينبغي رفضها والتوقّف عن استعمالها ما دامت معبَّأة بذلك المعنى.
وعلى سبيل المثال:
1- فقد شاع في أوساطنا استخدام كلمة "الإعدام" للإشارة إلى مسألة قتل المجرم، مع كونها- لدى التأمّل- تعبيراً غير موفّق عن ذلك، لأنّ القتل أو الموت في المفهوم الإسلامي لا يشكّل عدماً، بل هو محطة من محطات مسيرة الإنسان، ولذا يكون الأفضل ترك تداول هذه الكلمة واستبدالها بالمصطلح الإسلامي والإنساني في هذا المجال، وهو القصاص أو القتل أو ما يرادف ذلك، هذا على الرغم من إقرارنا بأنّ المسلم الذي يستعمل كلمة الإعدام لا يدور في خلده معناها الحقيقي.
2- يُطلق بعض الناس عبارة "مشروبات روحية" على المسكرات والخمور، وهو إطلاق مضلِّل وغير صحيح، لأنّ هذه المشروبات تزيل العقل وتفقد الوعي بما يسيئ إلى كرامة الإنسان وينتهك حرمته.
3- استبدلت الكثير من المنظّمات العالمية عبارة "الشذوذ الجنسي" التي تُطلق على العلاقات الجنسية بن الرجال والرجال أو بين النساء والنساء، بعبارة أخرى، وهي "العلاقات المثلية"، معتبرة أنّ تعبير "الشذوذ الجنسي" فيه إساءة معنوية لهؤلاء، ونحن لا يسعنا الموافقة على هذا الاستبدال، وذلك من موقع اعتقادنا أنّ نظام الكائنات قائم على أساس قانون الزوجية بين الجنس والجنس المخالف، ما يجعل أية علاقة خارج هذا النطاق تمثّل شذوذاً عن القاعدة وخروجاً على السُّنّة التكوينية، ولذا فلتُسَمّ الأشياء بأسمائها، ولا يصحّ لنا إعطاء أسباب تخفيفيّة لهذا العمل أو المساهمة في تكريسه باعتباره عملاً مألوفاً واعتيادياً.
4- ومن المصطلحات التي يمكن رسم علامة استفهام حولها، مصطلح "رجل الدين"، لأنّها تنطلق من خلفية فكرية تؤمن بفصل الدين عن الدنيا وتصنّف الناس إلى رجال دين ورجال دنيا وكذلك النساء. وهذه الفكرة لا يوافق عليها الإسلام بوجه، لأنّه يرى أنّ الناس كلّ الناس، لا بدّ أن يعملوا للدين والدنيا: "اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً"[4]، ولذا فالأنسب استبدال المصطلح المذكور بمصطلح آخر، كعلماء الدين أو نحو ذلك.
5- ومن المصطلحات التي ثار الجدل حول استخدامها مصطلح الديمقراطية، فهناك وجهة نظر- تبنَّاها بعض العلماء- ترفض استخدامها، على اعتبار أنّ الكلمة المذكورة تختزن مضموناً فكرياً فلسفياً، يرى أنّ الأكثرية هي مصدر الشرعية وأنّها تملك كل القرارات، بما في ذلك حقّ تغيير حكم الله، ولذا فالأجدى أن نستخدم تعبيراً آخر لا يختزن المعنى المذكور، كما في مصطلح الشورى أو نحوه. وعليه، فأصحاب هذا الرأي يتحفّظون على استخدام كلّ الكلمات التي ولدت في أجواء فكرية تختلف عن أجوائنا وتحمل مضموناً لا ينسجم مع المضامين الإسلامية[5].
ولكن في المقابل، هناك وجهة نظر أخرى، ترى أنّه لا مانع من الحديث عن الديمقراطية الإسلامية وإدخال الكلمة إلى أدبياتنا الإسلامية بعد فصلها عن جذورها الفلسفية، واعتبار الديمقراطية مجرّد آلية لإدارة الحكم وتداول السلطة، وتجريدها عن كونها نظاماً فكرياً يرتكز على كون الأكثرية هي مصدر الشرعية.
أمّا مسألة أنّ علينا نسج أو نحت مصطلحاتنا بوحي من فكرنا وتراثنا فهي مسألة صحيحة، ولكن عندما ينتشر المصطلح الوافد في إعلامنا ويتردّد على ألسنة الكثيرين منّا، فلا نرى مانعاً من احتضانه واستيعابه والعمل على أسلمته وإلباسه لباساً شرعياً يجرّده من مضمونه الفكري المضادّ لفكرنا، لاسيّما عندما تترك مواجهته الحادة بعض السلبيات أو تخلق بعض الاتهامات الظالمة للإسلام والمسلمين.
وفي تاريخنا الفقهي الشيعي نموذج جليّ لاحتضان بعض المصطلحات بعد تجريدها من إيحاءاتها السلبية، عنيت بذلك مصطلح الاجتهاد، الذي كان يختزن في بداية الأمر معنى الأخذ بالرأي والاستحسان، ممّا لا يصحّ الاعتماد عليه لدى مدرسة أهل البيت (ع)، ولذا كان مرفوضاً عند الأقدمين من فقهائنا، ولكن بعد تطويره من قبل الفقهاء والأصوليين، ليصبح معناه: "بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي من مداركه الأصلية"، زالت العقدة تجاهه، وأصبح شائعاً في كتبهم ومتقبلاً لدى الرأي العام الشيعي[6].
التأكيد على المصطلحات القرآنية
والأمر الآخر الذي نذكره هنا، هو أنّ المرونة المذكورة تجاه المصطلحات الوافدة، لا تمنعنا من التأكيد على أولوية مراعاة المصطلحات القرآنية والحرص على استخدامها في لغتنا الإعلامية والسياسية والقانونية لتصبح جزءاً من أدبياتنا، لا لدقة هذه المصطلحات وعمقها فحسب، كونها صادرة عن الله سبحانه، بل بهدف تركيزها في وجدان الأُمة، وحرصاً على توطيد علاقة المسلم بكتابه، ليبقى حيّاً في النفوس وفاعلاً ومحرّكاً للواقع كلّه.
ولذا، فالمفترض بالمفكرين والحركيين العمل على ترويج المصطلحات القرآنية، واستخدامها في محاوراتهم ومواعظهم وخطبهم لتدخل القاموس السياسي والإعلامي والقانوني، لاسيّما ونحن أمام هجوم العولمة الذي لن يكتفي بعولمة الاقتصاد والثقافة والسياسة، بل إنّه يعمل على عولمة المصطلحات واللغات ليحيي لغات ويميت أخرى، وإنّنا نرى إرهاصات ذلك على لسان الكثيرين من إعلاميّي أُمتنا وسياسيّيها و"مفكريها"، ممّن يتجنّبون استخدام المصطلحات الإسلامية من موقع العقدة النفسية والانبهار بحضارة الآخر وتقليده، لأنّ المهزوم مغرم بتقليد المنتصر، وقد كان الإمام الخميني رحمه الله رائداً في هذا المجال، حيث حرّك الكثير من المصطلحات القرآنية في الواقع الإعلامي والسياسي، من قبيل مصطلحات الاستكبار والاستضعاف والشيطان وغيرها لتصبح جزءاً من القاموس السياسي الإسلامي المعاصر.
استبدال المصطلحات بأخرى
وانطلاقاً ممّا تقدَّم من أنّ الألفاظ لا تملك قداسةً في ذاتها، وأنّ اللغة كائن حيّ متحرّك، وربّما أصيبت بعض ألفاظها بالشيخوخة والهرم، فلا غضاضة في تجميد استخدام بعض الألفاظ وترك استعمالها إذا صارت تحمل معنى سلبياً لدى الرأي العام، أو شكَّلت علامة فارقة لحركة أو جماعة معادية أو منحرفة، وهذا ما يمكن استيحاؤه من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا}[البقرة: 104]، إذ على الرغم من أن كلمتي "راعنا" و"انظرنا" تحملان معنى واحداً، وهو الإمهال والانتظار، لكن حيث إنّ كلمة "راعنا" كان اليهود يردّدونها على وجه الاستهزاء بالرسول (ص)، أو أنّها تعني في لغتهم السبّ، أو لأنّهم كانوا يلوون بها ألسنتهم، كما يشهد به قوله تعالى: {وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ}[النساء: 46][7]، فلهذا أو ذاك نهى الله المسلمين عن استخدامها عند مخاطبة النبيّ الأكرم (ص).
وانسجاماً مع هذا المبدأ، رأينا أنّ الأئمة من أهل البيت (ع) يرفضون استخدام كلمة "مخلوق" لدى تعبيرهم عن فكرة حدوث القرآن وعدم كونه قديماً، وذلك في خضمّ الجدل القائم في الأوساط الثقافية آنذاك حول مسألة "خلق القرآن"، كما هو معروف ومسطور في الكتب الكلامية، ففي الخبر أنّ سليمان الجعفري سأل الإمام الكاظم (ع) عن رأيه في المسألة وبيّن له انقسام الناس في ذلك، فمنهم من يقول: إنّه مخلوق، ومنهم من يرفض ذلك، فكان جوابه (ع): "إنّي لا أقول في ذلك ما يقولون ولكنّي أقول إنّه كلام الله"[8]. ورفضه (ع) لاستخدام كلمة مخلوق يعود إمّا إلى كونها تحمل إيحاءً سلبيّاً يرادف معنى الكذب والاختلاق كما رجّحه الشيخ الصدوق[9]، أو لأنّ الكلمة أصبحت عَلَماً ومميزاً لفرقة إسلامية لم يجد الإمام (ع) مصلحة في تبنّي مصطلحاتها.
ومن هنا فقد رأى بعض الأعلام (السيد فضل الله رحمه الله)[10] أنّه لا ضير في تَرْك استعمال بعض الكلمات ولو كانت واردة في الكتاب أو السنّة، ومن ذلك كلمة العصابة التي أطلقها النبيّ (ص) على المجموعة القليلة من المسلمين في معركة بدر في قوله (ص): "اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد"[11]، ورَفْضُ استعمالها يعود لكونها تحوّلت إلى مدلول جديد يمثّل أفراد المجموعة القليلة الذين يمارسون العدوان على الناس، وأصبحت من كلمات السباب بدلاً من أن تكون من الكلمات التي تدلّ على التجمّع المترابط الذي يشبه إحاطة العصابة بالرأس، مع الإشارة إلى أنّ بعض الحركات السلفية قد أطلقت على نفسها مصطلح العُصبة في الآونة الأخيرة.
وهكذا دعا بعض العلماء إلى تَرْكِ استعمال كلمة الكافرين عند مخاطبة المسيحيين ومحاورتهم، لأنّها تحمل معنى الشتيمة، وتوحي بأنّهم يكفرون بذات الله سبحانه ويجحدونه، مع أنّهم ليسوا كذلك، وإنّما يجعلونه ثالث ثلاثة أو يجعلون له ولداً، أضف إلى أنّ القرآن الكريم يخاطبهم على الدوام بعبارة محبّبة، وهي قوله {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}، وأمّا الموارد التي وسمهم فيها بالكفر، فلم تكن في مقام المخاطبة معهم، بل في صدد تقرير واقع حالهم وحقيقة معتقدهم، وأمّا قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ...}[الكافرون: 2]، فهي نازلة- على الظاهر- في المشركين لا في أهل الكتاب.
والفكرة من حيث المبدأ لا اعتراض عليها، ويمكن استيحاؤها من الكتاب والسنّة- كما سلف- بل إنّها موافِقة للقاعدة المتسالَم عليها، وهي قاعدة تقديم الأهمّ على المهم عند تزاحم المصالح والمفاسد. ولكنّنا نخشى من التراخي في هذا الشأن للتفلّت من المصطلحات الإسلامية الذي قد ينطلق من عقدة نقص وانبهار من حضارة الآخر وقوّتها المادية، ولهذا علينا أن نركّز على الثقة بذاتنا وديننا ومصطلحاتنا، ونعمل على خَلْق المناخات الملائمة لتقبّل هذه المصطلحات وتفهُّمها وإزالة الّلبس العالق في الأذهان نحوها، فعندما يثور الحديث عن كلمة الكفر- مثلاً- ينبغي علينا أن نوضح للآخرين أنها عندما تطلق على أهل الكتاب، فإنّ ذلك لا يراد به الانتقاص من إنسانية الآخر، بل إنّه يرمز إلى حالة ثقافية بحتة وهي أنّهم يكفرون بالرسول محمد (ص) أو لا يؤمنون برسالته، وهكذا الحال في سائر المصطلحات الإسلامية التي يثور الجدل حولها، كمصطلح أهل الذمّة أو غيره.
من كتاب " العقل التكفيري .. قراءة في المنهج الإقصائي "
[1] خطوات على طريق الإسلام للسيد فضل الله ص334.
[3]راجع الإتقان في علوم القرآن ج2 ص129.
[4]بحار الأنوار ج44 ص138.
[5]راجع اتجاهات وأعلام: حوار مع العلامة المرجع السيد فضل الله رحمه الله ص20.
[6] راجع المعالم الجديدة للأصول للشهيد السيد محمد باقر الصدر ص22.
[10]خطوات على طريق الإسلام ص344.
[11] تاريخ الطبري ج2 ص134، وبحار الأنوار 9ج ص255، وكنز العمال ج1 ص399، وقد تكرر إطلاق كلمة العصابة على الجماعة المؤمنة في كلمات الأئمة (ع)، راجع على سبيل المثال الكافي ج5 ص110 وج8 ص2 و5 و7، ويلاحظ الأمر عينه في كلام الشيخين الكليني والطوسي، راجع: الكافي ج7 ص115، التهذيب ج1 ص2 ، 142، 157، 219، وغيرها.