الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير
الشيخ حسين الخشن
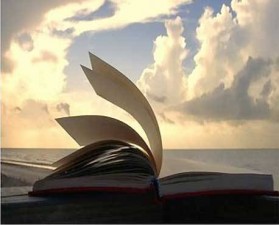
الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير
يلاحظ المتأمّل في أسلوب الخطاب الديني وجود أسلوبين في عملية التبشير الديني والدعوة إلى الله:
1- فهناك الأسلوب الكنسي الذي يعتمده المبشّرون المسيحيون، وهو- في الغالب- أسلوب ترغيبي يركّز على تقديم الله سبحانه إلى عباده بصفته رحيماً محبّاً غفوراً مسامحاً، وتكاد تغيب عن لغة الخطاب الكنسي صورة الإله العزيز الجبّار الشديد العقاب ذي الانتقام.
2- وهناك- في المقابل- أسلوب آخر ينتهجه الكثير من الوعّاظ المسلمين وغيرهم، وهو أسلوب ترهيبي تخويفي يطغى عليه الحديث عن شدّة عذاب الله وعظيم ناره التي أعدّها للعصاة من عباده، وكثيراً ما يخوض أرباب هذا الخطاب وهم من ذوي النزعات السلفية
والتكفيرية- غالباً- في بيان التفاصيل المرعبة لنار جهنم بما تقشعرُّ له الجلود ويشيب لهوله الوليد.
والسؤال الذي لا بدّ من طرحه: ما هو الموقف الإسلامي من هذين الأسلوبين؟ وما هو الأسلوب التبليغي الأجدى والأكثر إقناعاً وإيقاعاً في الواقع الإنساني، فهل التركيز على الرحمة الإلهية أجدى أم التركيز على الانتقام الإلهي، أم التركيز على الأمرين، أم أنّ لكلّ
مقام مقالاً؟
رفض التضليل
على العموم، يمكننا القول إنّ الخطاب الإسلامي لا يجوز أن يكون تضليلياً يمارس الخداع والتعمية على واقع صفات الله وحقيقة أفعاله، وممّا لا ريب فيه أنّ الله سبحانه يتّصف بالرحمة وأنّه أعدّ الجنة للمطيعين من عباده، كما أنّه ينتقم من العصاة ويُدخلهم النار
التي أعدّها لهم جزاءً بما كسبت أيديهم. وعليه، فلا يجوز تغييب صفة العزّة أو العدالة الإلهية أو إغفال الحديث كلياً عن عذاب الله، تماماً كما لا يجوز تغييب صفة الرحمة أو المحبة أو إغفال الحديث عن الجنة في الخطاب الإسلامي.
الغاية السامية والخطاب الملائم
ولكن بما أنّ الخطاب هو مفتاح القلوب والعقول، والإنسان هو الأسلوب- كما قيل- وبما أنّ الغاية السامية لله سبحانه وهدفه الأعلى هو جذب الناس نحو الدين والقيم الدينية، وتقريبهم من الهدى والإيمان، ولهذه الغاية (هداية العباد) أُرسل الرسل، وأُرسلت معهم الكتب
السماوية، قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}[البقرة: 2]، وفي الحديث النبوي الشريف: "يا عليّ، لئن يهدي الله بكَ رجلاً واحداً خيرٌ لكَ ممّا طلعت عليه الشمس"[1].
وفي ضوء ذلك، فلا بدّ أن يكون الخطاب الديني منسجماً مع تلك الغاية السامية لإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومقرّباً نحوها، الأمر الذي يفرض على الداعية سواء في مجال الوعظ الديني أو في مقام بيان المعتقدات أن يرصد باستمرار مدى تأثير خطابه على الناس
سلباً أو إيجاباً، فربَّ أسلوب كان مجدياً في زمن سابق لم يعد كذلك في زماننا، ما يفرض علينا تجديداً مستمرّاً في الخطاب مع بقاء الروح والمضمون، فليس كافياً أن تمتلك الحجّة والبرهان لتكون مقبولاً عند الناس وتكون ناجحاً في إقامة الحُجّة عليهم، بل الأهمّ- إلى
جانب امتلاك الحجّة- أن تعرف كيفية ايصالها إلى الناس باختيار الأسلوب الأنجح والأنجع والأكثر ملامسةً لوجدان الناس.
الأسلوب القرآني
وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في تقديم العقائد، وأهمّها عقيدتنا في الله تعالى، وأعتقد أنّ من الضروري استنطاق القرآن في ذلك واقتفاء أثره في الدعوة إلى الله وتعريف الناس بربّهم، فيكف قدّم الله لنا نفسه في كتابه؟ هل قدّم نفسه جلّاداً أو إلهاً مرعباً ومخيفاً؟ أم أنّه
قدّم نفسه بطريقة متوازنة، فهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشدُّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة؟
أذكر في هذا الصدد آيتَيْن قرآنيّتين:
الآية الأولى: قوله سبحانه وهو يعلِّم نبيّه (ص) كيف يقدّمه للناس ويعرفّهم به: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ}[الحجر: 49- 50] ويلاحظ المتأمّل في الآية:
أولاً: إنّه تعالى وصف نفسه بصفتَي المغفرة والرحمة، ونسبهما إليه لا إلى فعله، مع أنّهما من صفات الفعل، أمّا "الأليم"، فجاء في الآية وصفاً لفعله وهو العذاب لا لذاته مع أنّه كان بإمكانه القول: "وإنّي أنا المعذّب العذاب الأليم"، لكنّه قال: {وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الأَلِيمَ}[الحجر: 50] وما ذلك إلاّ ليبعد عن ذاته شبح الإله المخيف.
ثانياً: إنّ الملحوظ في الآية أنّ صفة الرحمة سبقت صورة العذاب، وقد ورد في بعض الأدعية "سبحان الذي سبقت رحمته غضبه"[2]، أضف إلى ذلك، أنّ تصدير الكلام بكلمة "عبادي"، حيث نسب الكلّ إليه، مطيعين أو مذنبين، فلم يقل "العباد" أو
"الناس"، إنّ ذلك يحمل معنىً إيحائياً محبَّباً، وأنّهم مهما فعلوا فهم عباده وهو ربّهم.
وهكذا نجد أنّ وصف "البشير" يسبق وصف "النّذير"الوارد في القرآن الكريم، قال تعالى: {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ}[النساء: 173]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً}[الأحزاب: 45- 46].
الآية الثانية: وهي تنسج على المنوال نفسه، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}[البقرة: 186]، وهذه الآية في مقام الإجابة على سؤال العباد عن ربّهم، قدّمت صورة الله إليهم
بطريقة محبَّبة تجذب الأرواح والنفوس إلى عظيم رحمته وواسع رأفته، وقد أشار المفسّرون إلى اشتمال هذه الآية على سبع نقاط مفعمة بالدلالات والمؤشرات على قرب الله تعالى من عباده ومحبّته لهم وهي:
1- إنّه نسب العباد إلى نفسه، فقال: "يا عبادي"، فهو لم يقل: "الناس" أو "العباد" وما شابه ذلك.
2- حذف الواسطة في الجواب، فقال: "فإنّي قريب"، ولم يقل: "فقل إنّي قريب".
3- تأكيد الجواب بـ "إنّ" حيث قال: "فإنّي".
4- الإتيان بالصفة "قريب" دون الفعل ليدل على ثبوت القرب ودوامه.
5- الإتيان بفعل المضارع "أجيب"، وهو يدل على تجدّد الإجابة واستمرارها.
6- تقييد الجواب بقوله: "إذا دعانِ"، وفيه إيحاء باستجابة دعوة الداعي من غير شرط، كما في قوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}[غافر: 60].
7- إنّ أساس الآية بُني على ضمير المتكلّم دون الغائب، وفي ذلك دلالة على كمال العناية والقرب، سيّما أنّ الضمير- ضمير المتكلّم- كُرِّر سبع مرات.
مقارنة إحصائية
وأضف إلى ذلك، أنّ أدنى مقارنة إحصائية يجريها الإنسان بين صفة الرحمة أو المغفرة وما شاكلها من الصفات الواردة في القرآن وبين الصفات المقابلة لها تدلّل على رجحان الكفّة بشكل ملفت للصنف الأول من الصفات. وعلى سبيل المثال:
فإنّ صفة "الرحمن" تكرّرت في القرآن 239 مرة، وصفة "الرحيم"أو "رحيم" أو"رحيماً" وردت 226 مرة، وَصِفَة "الغفور"، "الغفار"، "غفوراً" وردت 94 مرة، بينما في مقابل ذلك، نجد أنّ صفة "شديد العقاب" وردت 13 مرة، وصفة "ذو انتقام" وردت 3
مرات.
إنّ ما نستوحيه ونستلهمه من ذلك كلّه، أنّ الله تعالى يريد أن يقدّم لنا نفسه بصفته إلهاً رحماناً رحيماً أكثر ممّا يريد أن يقدّم نفسه بصفته معذباً شديد العقاب، ولهذا ابتدأت كل سور القرآن الكريم- عدا سورة البراءة- باسمه المقرون بالرحمانية والرحيمية، فالرحمة
عنده هي الصفة الأُم، وهي المبدأ والأساس، قال سبحانه: {كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ}[الأنعام: 12]، وفي آية أخرى: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً}[غافر: 7]، وأمّا العذاب والعقاب فهو استثناء {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[الأنعام: 54]. وعليه، فإذا كان الله قد قدّم لنا نفسه بصفة الرحمة، فعلينا في خطابنا التبليغي أن نقدّمه كذلك، وإذا كانت الرحمة عنده هي الأساس والعقوبة استثناء، فلا بدّ أن يكون حضور الرحمة والرحيمية في الخطاب
هو الأصل، وحضور العذاب هو الفرع.
العقوبة والرحمة
هذا ولكنّنا لا نوافق على إغفال الحديث عن العقوبة الإلهية التي توعّد بها العُصاة والظالمين، ليس لأنّ في ذلك تضليلاً وتجهيلاً للناس وربّما تشجيعاً لهم على الذنوب والمعاصي فحسب، بل لأنّ ذلك خلاف الرحمة والمحبة أيضاً، فإنّ المحبة للناس تفرض ضرورة
تنبيههم إلى المخاطر المحتمل تعرّضهم لها والأشواك والآلام التي قد تواجههم في نهاية الطريق.
إنّ كل ما أُريد قوله، إنّ علينا ونحن ندعو إلى الله ونبشّر به بين عباده، سواء في موقع رحمته وغفرانه أو في موقع غضبه وانتقامه، أن لا نصوّره إلهاً مرعباً أو جلّاداً مخيفاً تشمئز منه القلوب وتنفر منه النفوس، لأنّ في ذلك تعدّياً على ذاته المقدسة وتشويهاً
لصفاته وأسمائه الكريمة، وتنفيراً لعباده وإبعاداً لهم عن ساحة رحمته ومواقع رضاه.
وهذا الأمر ينسحب على كلّ العقائد والمفاهيم الدينية، كالنبوّة والمَعاد وحساب القبر وعذاب النار وما إلى ذلك. فكلّ هذه العقائد لا بدّ أن تُقدّم للرأي العام بطريقة متوازنة تبتعد عن التضليل والخداع وبأسلوب يجذب القلوب نحو الإيمان بها بدل أن ينفّر منها، بيدّ أنّ
الملحوظ في خطابنا أنّه يقدِّم هذه المعتقدات بطريقة منفرة ومخوفة ومرعبة.
بشِّروا ولا تنفِّروا
وقد رُوي عن رسول الله (ص) أنّه قال: "بشّروا ولا تنفّروا، ويسّروا ولا تعسّروا"[3]. إنّ قوله (ص): "بشّروا، لا تنفّروا" يشكّل دعوة صريحة إلى ضرورة اختيار أفضل الأساليب التبليغية وأحبّها إلى قلب الإنسان وأكثرها إيقاعاً وإقناعاً، وضرورة اجتناب
الأساليب المنفّرة شكلاً ومضموناً
حتى لو كانت ممّا درج عليه السلف، لأنّ الأساليب- في الغالب- لا تملك قدسية في ذاتها وإنّما هي مطلوبة لغيرها، فتكون من الأمور المتحرّكة التي قد تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، ومن جيل لآخر، فرُبَّ أسلوب كان في الماضي ناجعاً ومؤثّراً غدا اليوم
مقزِّزاً ومنفّراً.
وعلى سبيل المثال: إنّ صورة المبلّغ أو المعلّم الذي يحمل العصا في يده فيضرب بها العصاة والمقصّرين وينهال عليهم بأقسى الكلمات، ويصل به الأمر إلى درجة السبّ والشتم، إنّ هذه الصورة ربّما كانت مؤثّرة ونافعة في الزمن الغابر، ولذا قيل: "إنّ المتعلّم لم
يكن يتألم من شتم المعلم، لأنّه يعدّ
نفسه أدون من عبده، بل ربّما كان يفتخر بالسبّ لدلالاته على كمال لطف المعلّم به!"[4]، لكنها اليوم ليست مجدية ولا محبّبة بالتأكيد، بل إنّها منفّرة وغير مقبولة على الإطلاق.
وإنّ لغة الوعظ الاستعلائية التي يخاطب فيها الداعية مستمعيه بطريقة تصوّرهم أناساً يقبعون في دهاليز المعصية وظلماتها، بينما هو يعيش في نور الهداية والمعرفة، ولذا يقرع أسماعهم بضمائر المخاطب "اتقوا"، "أحسنوا"، "عليكم بكذا"، "توبوا" دون أن يشمل
نفسه بهذه الأوامر والنواهي؛ إنّ هذه اللغة لو كانت مجدية في يوم من الأيام، فإنّها اليوم ليست كذلك بالتأكيد، كما أنّ الزمن الذي كان يعتلي فيه الخطيب المنبر ويخطب في الناس لساعات طويلة قد ولّى إلى غير رجعة، ولم يعد إنسان اليوم، الذي يعيش زحمة الحياة
ويرهقه ضجيجها، مستعداً أن يستمع لأفضل الخطباء أكثر من ساعة من الوقت، يقول (ص)- فيما روي عنه -: "إنّ منكم منفّرين فمَنْ أمّ الناس فليوجِز، فإنّ مِن ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة"[5].
ضرورة قراءة كتاب الحياة
وعلى ضوء ذلك، يكون لزاماً على الداعية الإسلامي قبل أن يعتلي منبر الوعظ والإرشاد وقبل أن يحمل قلم الكتاب والتأليف، أن يقرأ في كتاب الحياة جيداً بمقدار قراءته في كتاب الفقه والأصول بل أكثر، لأنّ الحياة الاجتماعية في حركة مستمرّة في أساليبها
وعاداتها وتقاليدها والنموّ المعرفي لأهلها، ما يفرض عليه أن يدرس عصره وذهنية الناس فيه بشكلٍ جيد، حتى لا يخاطب الناس بما لا يفهمون، أو على الأقل بلغة لا تنتمي إلى عصرهم ولا تلامس مشاكلهم.
وباختصار: إنّ على الداعية ليكون مصداقاً لقول الإمام الصادق (ع): "رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس ولم يبغّضنا إليهم"[6]، أن يعرف أنّه يتعامل مع الإنسان، هذا المخلوق الذي يمكن وصفه بالسهل الممتنع، والذي يمكن أن تفتح قلبه كلمة أو ابتسامة ويمكن
أن تغلق قلبه كلمة أو نظرة عابسة، ويُنقل عن الإمام عليّ (ع)- وهو يبيّن طبيعة الإنسان هذه- أنّه قال في بعض الأبيات من الشعر:
أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر[7]
الخطاب الترهيبي ومحاذيره
إنّ للخطاب الترهيبي تأثيراً سلبيّاً على المستمع يفوق تأثيره الإيجابي بمراتب:
1- اليأس من روح الله: فهو قد يبعث على اليأس من روح الله ورحمته، ما يدفع اليائس إلى الانغماس في المعاصي والابتعاد عن مواقع رضا الله، مع أنّه تعالى يخاطب نبيّه بالقول: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ}[الزمر: 53]، ولذا يكون لزاماً على الداعية توخّي الحذر واعتماد الخطاب المتوازن الذي لا يبعث على اليأس والقنوط من رحمة الله، كما لا يؤدّي إلى الأمن من مكر الله وعقوبته، وقد ورد في الحديث عن أمير المؤمنين (ع): "الفقيه مَنْ لم يُقْنِط الناس من
رحمة الله ولم يؤيّسهم من
روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله"[8].
2- التنفير من الدين: إنّ الاستغراق في الخطاب الترهيبي التخويفي سيُسهم بلا شكّ في تشويه صورة الخالق في ذهن المخلوق، كما أنّ التركيز على صورة العذاب والتنكيل الإلهي ربّما شكّل دعوةً ضدّ الدين بدل أن يكون دعوة إليه، ولا نغالي إذا قلنا: إنّ المرء
يشعر وهو يستمع إلى بعض الخطباء وهو يصوّر عذاب الله وعظيم ناره، أنّه أمام إله مرعب يتلذّذ بِجَلد عباده، ما يجعل هذا العبد المسكين مرتعد الفرائص من خالقه وتسيطر عليه الكوابيس المزعجة التي تؤرّق نومه وحياته. إنّ تقديم الله بهذه الصورة المرعبة
مجافٍ للحقيقة، لأنّ الله تعالى غير مخيف أبداً، فهو الذي يتّصف بالعدل والرحمة، ومن يتّصف بهاتين الصفتين لا يُخاف منه. نعم، على الإنسان أن يخاف من ذنوبه وسيّئات عمله {وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ}[الرعد: 21].
أوَليس أسلوب الكثير من الآباء والأمّهات والمربّين قائماً على تخويف الطفل من الله؟! ولذا ترانا نقول له: إذا فعلت القبيح الفلاني "يخنقك الله" أو "يشنقك"! هل نتخيّل الصورة المرعبة والمشوّهة عن الله التي سيرسمها هذا اللون من الخطاب في ذهن الطفل وما قد
يتبع ذلك من ردّة فعل تجاه الدين والعقائد الدينية؟
لقد حدّثني بعض الأخوة أنّ ابنه البالغ من العمر خمس سنوات كان على الدوام يُخَاطَب بكلمة "الله سوف يخنقك" عندما يقوم ببعض الأعمال الطفولية، فما كانت ردّة فعله ذات يوم إلاّ أن قال: لماذا هو سيخنقني أنا سأخنقه!
3- الانكفاء والانعزال: إنّ بعض ردّات الفعل الطبيعية للخطاب الترهيبي أن ينكفئ المرء عن ساحة الحياة الاجتماعية وينعزل في بيته وصومعته خشية التلوث بالوحول والانغماس في المعاصي والذنوب التي سيعقبها غضب الجبّار وعذاب النار، وربّما يكون ذلك
هو أحد الأسباب في تكوّن ونشوء الحالة الصوفية في الإسلام بمعناها الانعزالي، على الرغم من أنّ الله سبحانه يريد للعبد أن يحفظ دينه وتقواه وهو في معترك الحياة ووسط التيار.
انطلاقاً ممّا تقدم، يكون من الضروري والملحّ إعادة النظر في أساليب خطابنا الإرشادي ودراسة مدى انسجامها مع غاية خلق الإنسان وهي هدايته وسوقه إلى رحمة الله لا إلى عذابه، ومن الضروري أيضاً، للخروج من عشوائية الخطاب الديني، تأسيس المعاهد
والمدارس التي تعنى بتربية الدعاة وتأهيلهم وإرشادهم إلى أفضل الأساليب التبليغية وأنجعها، وحتى نصل إلى هذه الغاية المنشودة، يلزمنا- في أضعف الإيمان- إسكات الكثير من الأصوات التي تنفّر الناس عن الدين باسم الدين، وتبعد الخلق عن الله باسم الله.
من كتاب: العقل التكفيري - قراءة في المنهج الإقصائي
[1]بحار الأنوار ج23 ص448.
[2]مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص442.
[3]الجامع الصغير ج2 ص323، وعوالي اللئالي ج1 ص381.
[4] كما ذكر الشيخ الأنصاري في آخر بحث السبّ من المكاسب.
[7]التفسير الصافي ج1 ص92.