حوار مع مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر: قراءة جديدة في نصوص قتل المرتد
الشيخ حسين الخشن
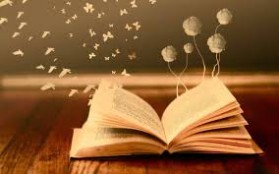
لقد أعادت العمليات الوحشية التي تقوم بها جماعات إسلامية متطرفة نظام العقوبات الإسلامي إلى الواجهة. مع استهجان واسع من المسلمين قبل غيرهم لهذه الممارسات التي اعتبرت مسيئة للإسلام ولا تمثل رحمانيته. ومن هذه الحدود كان حد قتل
المرتد، وخصوصاً مع إصدار دول كالسودان وموريتانيا هذه العقوبة مؤخراً بحق عدد من الأشخاص ومنهم الكاتب الموريتاني الشاب محمد شيخ ولد محمد. بعض الأسئلة الراهنة والمتصلة بالموضوع حملناها إلى فضيلة الشيخ حسين الخشن الذي
سيصدر في القريب كتاباً مفصلاً حول موضوع الردة في الإسلام.
فيما يلي نص الحوار:
1- قمتم بإعداد بحث حول موضوع الردة توصلتم فيه إلى أن لا حكم بالقتل على المرتد. هلا فصلتم قليلاً.. ولا سيما أن هناك شبه إجماع إسلامي على قتل المرتد؟
بملاحظة المرجعية التشريعية والعقدية الأساسية في الإسلام، وهي القرآن الكريم، نجده لم يتضمن أي إشارة إلى حكم قتل المرتد. مع أنه أشار إلى موضوع الردة في العديد من الآيات. وإذا أردت أن ألخص المسألة حول موضوع الردة من الناحية القرآنية فيمكن
أن ألخصها بنقطتين:
أولاً خلو القرآن من الإشارة إلى حكم قتل المرتد، مع أنّ المسألة هي محل ابتلاء، لوجود العديد من حالات الارتداد في زمن نزول القرآن، ومع أنّ العديد من الآيات تتحدث عن الارتداد ولكنها تشير إلى العقوبة الأخروية للمرتد وأن الله لا يهديه، أو أنّ الله
يستبدله بقوم آخرين أو ما إلى ذلك من آثار الردة، ولكن لم نجد آية تنص على قتله.
وهنا أستعرض بعض الآيات:
{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [آل عمران: 106].
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ} [آل عمران: 90].
{كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: 86].
{مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} [المائدة: 54].
ثانياً: قد يقال: إنّ في القرآن الكريم ما يصلح لنفي عقوبة المرتد بالقتل، فبعض الآيات القرآنية قد يستفاد منها أنّ الإنسان لا يقتل إلا في حالتين: وهما: حالة القصاص أو الإفساد في الأرض. فالمبرر لقتل النفس، هو النفس بالنفس أو الإفساد في الأرض. قال
تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة 32] وهناك آيات أخرى يستفاد منها ذلك.
2- لكن من يستطيع أن يحدد ما هو الفساد في الأرض؟ أحياناً يكون الخروج على نظام فاسد لتغييره، ومن الطبيعي أن يعتبر النظام أن هذا الخروج هو إفساد في الأرض؟
هذا بحث آخر. المفسد في الأرض أو ما يعبر عنه بالمحارب هو الذي يشهر السيف في وجه الناس، ويتحول إلى قاطع طريق أو شخص يثير القلاقل ويوتر المجتمع من خلال الإخلال بالأمن أو يسعى إلى قلب النظام وتغييره بالقوة وبالسلاح وما إلى ذلك. فمثل
هذا الشخص يستحق العقوبة في كل القوانين حتى القوانين الوضعية، ولا أحد يستشكل في أن شخصاً من هذا القبيل يستحق العقوبة ولو وصلت إلى القتل.
3- ماذا عن الآية {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}. ألا تنفي أيضاً قتل المرتد؟
لقد قادني البحث إلى أنّ هذه الآية المباركة تصلح لتأييد ما أشرت إليه سابقاً من أن في القرآن إشارات إلى نفي القتل عن المرتد، وذلك لأنّ القتل في نظر العرف هو نوع من أنواع الإكراه، فتهديد الإنسان إذا غيّر دينه بالقتل هو إكراه له للبقاء على الدين، والآية
تقول لا إكراه في الدين. قد يورد عليّ ببعض الإشكالات حول هذا الاستدلال بالآية لكن لدي إجابة حول كل هذه الإشكالات.
4- هل يعتبرونها منسوخة؟
هذا النوع من الآيات لا يمكن أن ينسخ، لأنها آيات مُعلّلة، والمعلل لا ينسخ إلا بنسخ علّته. فنفي الإكراه في الدين أو النهي عنه قد عُلل بأنه {قد تبين الرشد من الغي}، فنسخها معناه أن الرشد لم يعد متبيّناً من الغيّ، وهذا ما لا يمكن القبول به، فهذه الآية ليست
منسوخة على أصح الأقوال. بأي حال عدم نسخ الآية هو رأي معروف الآن، وليس رأياً شاذاً.
5- لم ينص القرآن كما فصلتم على قتل المرتد، ماذا عن السنة؟ هناك أحاديث يركن إليها المسلمون لتبرير قتل المرتد ولعل أكثرها شهرة حديث وارد عن النبي:"من بدل دينه فاقتلوه".
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تنسب إلى الرسول(ص)، وهو موجود في صحيح البخاري وغيره من المصادر. يقول الحديث أن علياً أحرق قوماً فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "لو كنت مكانه لما أحرقتهم، لأن النبي(ص) يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار،
ولكنت قتلتهم - بدل الإحراق - لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه". إلا أنّ هذا الحديث في نظري غير تام، لاعتبارين:
أولاً: لأنّ سند الحديث محل إشكال إذ أنّ الراوي له هو "عكرمة"، وهو من الخوارج المعادين لعلي (ع) فلا يوثق بروايته عنه.
ثانياً: لأنّ مضمون الحديث لا يمكن القبول به، إذ هل يعقل أن الإمام علي(ع) لا يعرف مسألةً شرعية قالها النبي(ص)، وهي أنّه لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى يأتي ابن عباس وهو تلميذ علي(ع) ليُشكل على علي(ع) أنه خالف الرسول؟! هذا يزيدنا ريبة.
ولذا لا نستطيع أن نقبل هذا الأمر، على أنه لم يثبت لدينا أنّ الإمام أحرق أحداً من الناس. أجل، هناك روايات أخرى عند السنة والشيعة في قتل المرتد لكنها في معظمها بل بأجمعها لا تخلو من مناقشات إما في السند أو الدلالة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا عندما نريد أن نصدر حكماً عن الله وباسمه استناداً إلى الرواية فلا بدّ لنا أن نأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، لا بد أولاً: أن تكون السنة ثابتة، أي الحديث صحيحاً وموثوقاً، وهنا لا يكفي الخبر الواحد، لأن الخبر الواحد الظني حتى
لو كان صحيح السند لا يكفي – في رأي بعض الفقهاء – وهو رأي صحيح للاستناد إليه في إصدار حكم شرعي ولا سيما في قضايا الدماء، بل لا بد أن يكون خبراً موثوقاً، تضافرت أسانيده ورواته بحيث يوثق ويطمئن بصدوره عن النبي(ع) أو عن الأئمة(ع).
ولا بدّ ثانياً أن لا يكون للخبر معارض لا من القرآن ولا من السنة. ومن جهة أخرى فإنّ علينا أن نعي معنى الردة الواردة في الروايات فهل يقصد بها الردة عن الإسلام أو الردة على النظام الإسلامي؟ هناك مؤشرات في الروايات تشير إلى الأمر الثاني.
وهذا ما أشرنا إليه مفصلاً في الكتاب المعد لهذا البحث والذي نسأل الله أن يوفق لطباعته قريباً إن شاء لله.
6- هل القرآن يطيح بالسيرة؟
القرآن هو الأساس، "كل ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما عارض كتاب الله فدعوه". وعليه فإذا استوحينا من القرآن أنه لا مبرر للقتل إلا في حالة القصاص وفي حالة الإفساد في الأرض فقط، وإذا تقبلنا بأنّ قتل المرتد هو
إكراه في الدين فهذا سيشكل - على أقل تقدير- عنصراً سلبياً يمنع من حصول الوثوق بالروايات. كما أننا نجد أنّ بعض الروايات الواردة في الردة تصلح لنفي الحكم بقتل المرتد، وهذا أيضاً يشكل عنصراً سلبياً يمنع من حصول الوثوق بروايات القتل.
وهناك مسألة أخرى لا بد أن نطرحها هنا في قضية الردة ونظائرها من قضايا الحدود، وهي أنّه لو سلّمنا بصدور هذه الروايات، فهل الحكم الذي صدر عن النبي(ص) أو الإمام(ع) في ذلك هو حكم تدبيري أم تشريعي؟ هل يمكن لنا - ولا أجزم الآن - أن نقول
بأن هذه الحدود وتحديداً حد الردة كانت عقوبات تدبيرية أم أنها عقوبات تشريعية أي ينطبق عليها قانون "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة"؟ ربما نستطيع أن نلتقط ونجد في الروايات العديد من الشواهد التي تؤيد أن هذا الحد كان
حكماً تدبيرياً وليس حكماً تشريعياً.
وهذا ما تؤيده فلسفة نظام العقوبات، فإنه نظام لا يهدف إلى التشفي أو الانتقام، وإنما يرمي إلى ردع الإنسان عن ارتكاب الجرائم وتجاوز القوانين، ونحن نعرف أن المجتمعات البشرية متطوّرة حتى في نظام العقوبات، لأن نظام العقوبات يراد منه إصلاح
المجتمع، وكلما كان المجتمع أقرب إلى الوحشية والبداوة ربما احتاج إلى نظام عقوبات صارم، لأن الإنسان لا يصلحه إلا القانون. ولكن كلما تحضّرت البشرية وتطورت وتمدنت فإن هذا يوجب التخفيف من العقوبة، هذا ما تعلمناه من القرآن الكريم، نجد أن
النبي عيسى(ع) يقول مخاطباً اليهود: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} فشريعة موسى كان فيها قسوة وتشدد، لأن بني إسرائيل كانوا غلاظاً ولإصلاحهم كان الأمر يتطلب نظام عقوبات شديداً وصارماً، ومن بعد النبي عيسى جاء النبي محمد(ص) ليقول:"
بعثت بالشريعة السمحة"، وهذا المعنى أريد أن أطبقه على نظام العقوبات.
7- من الذي يطبق قانون العقوبات؟
هناك روايات تقول إن الحد بيد الإمام، والإمام هو رمز السلطة، أما إذا لم يكن هناك سلطة مبسوطة اليد فلا نستطيع أن نقيم الحدود، فهذا الأمر لا يوكل إلى أفراد الناس لئلا يلزم الهرج والمرج، وإنما يحتاج إلى سلطة شرعية عادلة.
8- لماذا هناك إجماع عند المسلمين على مسألة الحدود والتشديد على إقامتها، ويبررون لها من غير الانتباه لما حصل من تطورات إنسانية وأن إقامة الحدود بهذا الشكل بات يؤذي صورة الإسلام؟
أعتقد أن موضوع الردة هي من المواضيع التي لا بد أن تبحث اليوم بحثاً اجتهادياً مستوعباً على ضوء النصوص الشرعية وعلى ضوء مقاصد الشريعة، ولا سيما أننا في عصر أصبح تطبيق هذه الحدود يستدعي ردود فعل من بعض المسلمين فضلاً عن غير
المسلمين من سائر الأديان ومنظمات حقوق الإنسان... إنّ الكثير من المسلمين أخذوا يرفعون الصوت عالياً محتجين ومستغربين عندما يرون بعض أشكال الحدود التي تقام في العالم الإسلامي من قبيل الرجم أو غيره، ولا بدّ لنا من إقناعهم بهذا النظام، وأعتقد
أن المبررات التي قدمها جماعة من العلماء المفكرين لتبرير قتل المرتد ليست مقنعة. فقد ذكر بعضهم أنّ قتل المرتد يهدف إلى حماية الدين وعقائد الناس لأنّ السماح بالردة سوف يزلزل عقائد الناس... أعتقد أن مثال هذه التبريرات غير تامة، لأن الإسلام ليس
بهذا المستوى من الضعف في حجته وبرهانه ليتم حمايته من خلال السيوف وقطع الرقاب. إنها تبريرات تختزن - من حيث لا نشعر - توهيناً بالإسلام وتوحي بضعف الحجة الإسلامية، كما أنها تختزن سوء الظن بالمسلمين. وأنا لا أعتقد أن ردة من هنا وردة
من هناك سوف تدفع المسلمين إلى ترك دينهم أو تشككهم في عقائدهم. لقد ترك عشرات الآلاف من المسيحيين دينهم ومع ذلك لم يؤد هذا إلى سقوط الهيكل المسيحي، بل ظلت المسيحية قائمة ومستمرة بزخم كبير، وكذلك الإسلام. كما أني أعتقد أنّ منطق ا
لتبرير هذا قد لا يساعد هؤلاء الفقهاء الذين التزموا بقتل المرتد، إذ لشخص أن يُشكل عليهم ويقول أنكم إذا بررتم قتل المرتد بحماية عقائد الناس فقد يقول لكم البعض إنّ قتل المرتد سوف يعزز نزعة النفاق عند المسلمين، لأنّ الكثيرين من خوف القتل سوف
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. والنفاق قد يكون في بعض مظاهره أسوء وأخطر من الكفر، لأنّ الكافر عدو واضح وعلني، أمّا إذا تحول الشخص إلى منافق فسوف يكيد إلى الإسلام من الداخل وهذا سيكون ضرره أكثر من الكافر الذي أعلن الكفر وخرج عن
الإسلام. لذلك لا أعتقد أن منطق التبرير ينفع في تبرير حد المرتد، إنما علينا أن نذهب إلى الدليل لنرى هل يتم دليل على قتل المرتد أم لا. ويمكن القول: إنّ القدر المتيقن مما دلت عليه الروايات في قتل المرتد هو المرتد الذي تتلازم ردته مع الخروج على
النظام العام وليس المرتد الذي يكون مجرد تعبير عن عدم القناعة بأصل من أصول الدين.
9- ماذا عن مسألة تطوير قانون العقوبات في الإسلام، وإعادة النظر فيه على ضوء وجود القانون الوضعي؟
أعتقد أن ثمة مجالاً للحديث عن تطوير نظام العقوبات في الإسلام، وأرى مشروعية لكل الأسئلة التي تثار من داخل البيت الإسلامي حول مسألة الرجم مثلاً، وهي أسئلة لا تخرج عن سياق القواعد المعروفة في إنتاج الفتوى، فالسؤال عن تدبيرية عقوبة المرتد
أو رجم الزاني ليس ما يمنع من طرحه، ولا بد أن تتابع هذه الأسئلة بطريقة علمية بعيداً عن الضغوط النفسيّة التي قد يخلفها الإعلام أو الضغط الذي تمارسه الكثير من الدول والمنظمات، وهكذا فإنّ سائر العقوبات يمكن أن يتم الحديث عن إمكانية تطويرها،
وهناك طرح تقدم به بعض الفقهاء وأخذ مجالاً للتداول داخل الأروقة الحوزوية وهو أنه هل يمكن أن نستبدل بعض العقوبات التعزيرية بالغرامات المالية، إذ ليس من شرط العقوبة أن تكون عقوبة بدنية في كل الأحوال؟ وأعتقد أن هناك مؤشرات في النصوص
تساعد على إمكانية أن نخرج بتصوّر يسمح بتطوير قانون العقوبات في الإسلام في الكثير من مفاصله، لا أزعم بطريقة شمولية، وأهم هذه العناصر التي يمكن أن تخدمنا في هذا المجال هي محاولة قراءة الكثير من مفردات نظام العقوبات على أساس أنها كانت
إجراءات تدبيرية ويمكن الاستعاضة عنها بأمور أخرى. نحن معنيون بأن نطرح الأسئلة وأن نفكر بطريقة جديدة قد لا تخرج عن آليات فهم النص الديني المعروفة، وما طرحته في هذا الكلام ربما يرى البعض فيه جرأة غير عادية ولكنني أعتقد أنني استطيع أن
أنظّر له من خلال آليات الاجتهاد المتعارفة.
ويمكن في هذا السياق أن يسأل: ما الهدف من نظام العقوبات؟ بالتأكيد ليس الغاية منه تعذيب الناس والانتقام منهم. نظام العقوبات في التشريع الإسلامي كما في سائر القوانين هو قوة ردع تهدف إلى حماية الاستقرار وتنظيم المجتمع ومنع الفوضى ووضع حد
للجريمة وما يراه التشريع حرام. وعليه فإذا كان هناك وسيلة أخرى تحقق هذه الغاية غير هذه الوسيلة التي تعتمد على العقوبة البدنية ألا يمكن لنا أن نعتمدها؟ هذا ومن جهة أخرى فإننا اليوم إذا لاحظنا أن قتل المرتد سيؤدي إلى نتائج عكسية، فبدلاً من أن
يحمي عقائد الناس فإنه سيدفع إلى أن يشك كثيرٌ من المسلمين في دينهم. وربما يرتد بعضهم عن الدين أفلا نستطيع حينئذٍ أن نجمد هذه العقوبة؟ وقد ورد في بعض الروايات أنه لا يقام الحد في أرض المعركة حتى لا يلتحق الشخص بالعدو ويرتد عن دينه. ثم
لنفرض أنه لم يسعفنا الاجتهاد إلى تغيير عقوبة ما كلياً، والقول إنها عقوبة تدبيرية ومؤقتة بزمان خاص، لكن لو وجدنا أن السمعة التي ستصيب الإسلام من وراء الإصرار على تطبيقها ولا سيما في الهواء الطلق كبيرة جداً، بل أكبر من الضرر في حال عدم
تطبيقها، ألا نستطيع حينئذٍ تجميدها استناداً إلى قانون التزاحم والأولويات، أو ما يسمى بالعناوين الثانوية التي قد تدخل في البين، وتوجب تجميد بعض الحدود والابتعاد عن تطبيقها، حفاظا على ما هو أهم وأولى.
لذا أنا أطلق دعوة وصرخة من أجل نقاش هذه الأمور في الأورقة العلمية بكل جرأة وجدية. فقد نجد أنّ هناك مجالاً كبيراً لتجديد الاجتهاد فيما يندرج تحت عنوان نظام العقوبات في الإسلام، وليست المسألة خروجاً عن المسلمات ولا الضروريات.
10- كيف تنظرون إلى انعكاس ما تقوم به الجماعات الإسلامية المتطرفة من أعمال وخصوصاً في إعادة النظر في الكثير من المسائل الدينية؟
رغم المشهد السوداوي فإني أنظر بإيجابية وأمل في المستقبل، وذلك لأنّ الظاهرة المتطرفة المعروفة بداعش، وإن أضرّت بسمعة الإسلام ، ولكن وكما قال تعالى: {وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم}. فلتشكل مثل هذه الظاهرة صدمةً إيجابية للفكر الإسلامي
ليندفع إلى إعادة النظر في الكثير من مقولاته، وليفكر المسلم وليتساءل: هل هذه هي الصورة التي نريدها للإسلام؟ وبالمناسبة إنّ داعش في بعض أفعالها وتصرفاتها تطبق بعض الأحكام الفقهية الموجودة عند فتاوى الفقهاء المسلمين من السنة والشيعة. ولذا
وبدل أن تعترضوا على هذه الجماعات وتشهّروا بها اذهبوا إلى النصوص الإسلامية وقدّموا اجتهاداً آخر، أو توقفوا عن الاعتراض على من يطبق هذه الأحكام.
أعتقد أنّ ما يجري في هذا الواقع المليء بالحراك والذي يضج بالإشكالات التي تسجل على الإسلام هو خير ولا بدّ أن يدفع المجتهد إلى أن يقدم حلولاً وأن يجد أجوبة وأن يطرح الإسلام بطريقة قابلة للحياة في هذا العصر، وأن تكون الأجوبة مقنعة للمسلمين
قبل غيرهم وليست أجوبة مفحمة وإسكاتية. إنّ المجتهد أو "المشرع" الإسلامي إذا جاز التعبير، إذا لم يصطدم بمثل هذا الواقع لن يستطيع أن يعيد النظر ويجدد الاجتهاد ويطور فيه.
وإني أرى حراكاً في الكثير من المعاهد العلمية، ولست متشائماً. ربما الآن بسبب الأجواء المذهبية الطائفية والصراع الطاغي لا يظهر مثل هذا الحراك، ولكن هناك حركة قد تبدو بطيئة أحياناً وقد تبدو متسارعة أحياناً أخرى، وقد تُطرح بعض الآراء التي
يراها البعض شاذة وخروجاً عن السياق، ولكن مع الوقت قد نكتشف أن هذا الرأي يأخذ مقبولية شيئاً فشيئاً، ويصبح هو الرأي الأكثر مقبولية دينياً حتى ممن كانوا يعترضون عليه بالأمس القريب.
حوار: رحيل دندش
التاريخ: ١٠/٢/٢٠١٥
تم نشر الحوار على الموقع في 16-2-2015