أسماء المواليد: تجاوز التقاليد والانتماء الحضاري
الشيخ حسين الخشن
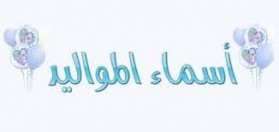
مرّت الإشارة إلى أنّ ثمّة حديثاً معروفاً مرويّاً عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأيضاً عن بعض الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) بصيغ متقاربة، وهو يتحدَّث عن حقوق الولد على والده، وجاء في إحدى صيغة: "حقّ الولد على الوالد: أن يحسن إسمه ويحسن أدبه ويعلِّمه
القرآن"(1)،
الأسماء وعلاقتها بحضارة الأُمّة
اهتم الإنسان من قديم الزمان باختيار أسماء الأولاد، وكانت ولا تزال عوامل عديدة تلعب دوراً في هذا الاختيار أهمّها العامل الديني والتاريخي والقومي، كما أنّ العنصر الجمالي له دوره في هذا المجال حيث يحرص الكثيرون على اختيار إسم ذي جرس موسيقي ووقع طيّب على الأذن، وهكذا فإنّ
للمستوى الحضاري والثقافي للأُمّة دوراً في ذلك، فالمجتمع الحضاري يختار أسماءً تختلف عن الأسماء المنتشرة في مجتمع البداوة، وقد عرف عن العرب اختيار الأسماء الموحية بالقوّة والقساوة والصلابة، ولذا انتشرت بينهم أسماء من قبيل صخر وحرب وحمزة وعبّاس.. هذا بالنسبة لأبنائهم، أمّا
غلمانهم فكانوا يختارون لهم أسماءً توحي باللطف والرقّة من قبيل سالم وريحان ولؤلؤ، وقد سئل أحدهم عن سبب ذلك فأجاب: "نسمّي أبناءنا لأعدائنا وغلماننا لأنفسنا"، وفي الحديث عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: لِمَ يُسمِّ العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت
العرب أصحاب حرب، فكانت تُهوِّل على العدو بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم: فَرَج، ومبارك وميمون، وأشباه هذا يتيمَّنون بها"(2)، وهكذا فإنّ للعامل البيئي والجغرافي دوره في اختيار الأسماء، ولذا شاع عند العرب التسمية باسم النباتات الصحراوية كما في حنظلة، وطلحة، أو أسماء
الحيوانات، كما في ثعلبة وذؤيب وكليب ونمر، أو اسم الحجارة كجبل وصخر ورملة... والسؤال: كيف ينظر الإسلام إلى أسماء الأولاد؟ وما هي الأسماء المفضّلة لديه؟
الاسم وتأثيره على شخصية صاحبه
إنّ أوّل أمرٍ يحرص عليه الإسلام في اسم الوليد هو اختيار اسم حسن له: "أن يحسن اسمه"، ما يعني أنّ على الوالدين اجتناب الأسماء القبيحة أو الوحشية التي توحي بالعنف، فإنّ للاسم تأثيراً على شخصية صاحبه ونفسيّته، فإنْ كان اسماً وحشياً وغليظاً فإنّه قد يوقع صاحبه بالخجل والمعرَّة
ويؤذيه معنوياً ونفسياً، خلافاً لما إذا كان اسماً طيّباً وجميلاً، وممّا يدعو للأسى أنّ للكثير من الآباء لا يزالون يختارون لأبنائهم أسماءً تنتمي إلى عصر الجاهلية وقيمها ولغتها الخشبية الجامدة، كما هو الحال في اسم: ذئب أو فهد أو ظالم أو طافش أو صايل، أو قذَّاف الدم، أو عديّ (تصغير عدو) أو
ما إلى ذلك من أسماء تحمل معانٍ سلبية نافرة.
إنّ الإسلام عندما يؤكّد أنّ الاسم الحَسَنْ حقّ للولد على والده، فإنّه يحمّل الأب مسؤولية اختيار الاسم، فهو ليس حرّاً في الاختيار بما يحلو له ليتحرّك في التسمية على ضوء هَوَس عقلي أو نزوة آنية أو موضة دارِجة، بل عليه أن يفكّر بالولد ومدى قبوله للاسم فيما بعد، أو ما قد يتركه الاسم من
تأثير على شخصيته أو يخلق له من عقدٍ ومشاكل فيما لو لم يكن حسناً، باختصار: إنّ التسمية حقّ للولد أكثر ممّا هي حقّ للوالد، ما يفرض على الوالد التجرُّد من التقاليد البالية والبيئة الضيّقة التي قد تفرض عليه بعض الأسماء النافرة، إنّ التقاليد في مجتمعاتنا العربية قد تفرض على الشخص تسمية
ابنه باسم والده، وابنته باسم والدته، إنّ هذا الأمر لا مانع منه من حيث المبدأ، وربّما يمثّل نوعاً من احترام الوالدين ومحبّتهما، بيد أنّ ذلك ليس لازماً ولا يعتبر تجاوزه إساءة لهما، ولن يكون ذلك ـــ بالتأكيد ـــ مستحبّاً فيما لو كان اسم الجدّ نافراً أو مُوحِياً بالوحشية والسلبية.
لا تسمُّوا بأسماء الطواغيت
وعلى ضوء ذلك يكون من المحتَّم على الآباء وكذا الأمهات الابتعاد عن الأسماء ذات المضامين القبيحة والدلالات السلبية أو التي توحي بالشرك أو الغلو كالتسمية بأسماء الله، أو العبودية لغير الله، أو التي توحي بالمهانة مثل "كلب محمّد" أو "كلب عليّ" وفي الحديث عن الإمام الباقر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) ألاَ خير الأسماء: عبد الله، وعبد الرحمن، وحارثة، وهمّام، وشرّ الأسماء: ضرار، ومرّة، وحرب، وظالم"(3)، وعرف عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) أنّه غيَّر أسماء صحابته لكونها تختزن معنىً سلبياً، فقد جاءه بعض
الأشخاص وكان اسمه قليلاً فسمَّاه كثيراً، وبعضهم كان اسمه العاصّ فسمَّاه مطيعاً، وجاءته امرأة تسمّى عاصية فسمَّاها سهلة، وبعضهم كان اسمه أسود فسمَّاه أبيض(4)، والآخر كان يسمّى أكبر فسمَّاه بشر(5)، وولد لبعضهم طفل فأسموه الوليد، فقال (صلّى الله عليه وآله وسلَّم):
"سمَّيتموه باسم فراعنتكم!"(6) في إشارة إلى أحد خلفاء بني أُمّية.
أسماء الأنبياء
من الأسماء الحَسَنة التي يشجّع عليها الإسلام: أسماء الأنبياء والأئمة والأولياء، فقد ورد في الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم): "سمُّوا بأسماء الأنبياء"(7)، والتسمية بأسماء الأنبياء وإنْ لم تشكِّل دليلاً على عمق أو صدق العلاقة المطلوبة بهم، وإنّما هي مجرّد تعبير شكلي
عن هذه العلاقة، لكن رمزيّتها في كونها تمثِّل مظهراً من مظاهر حضور الأنبياء في الأُمّة، وهي مدّعاة للثناء عليهم واستذكارهم واستحضار مواقفهم ورسالتهم، كما أنّها قد تكون مدخلاً للتخلّق بأخلاقهم.
إنّك عندما تعطي ابنك اسم عظيم من العظماء فإنّ ذلك قد يحسّسه ويشجّعه على الاقتداء بسيرة ذاك العظيم والاهتداء بهديه واتّخاذه مثلاً أعلى في الحياة.
كما أنّ ذلك قد يشكِّل حافزاً لاحترام المسمّى باسم النبيّ أو الولي وترك الإساءة إليه أو شتمه، احتراماً لصاحب الاسم أعني النبيّ أو الولي، وقد ورد في بعض الروايات أنّ من سمّي ابنته فاطمة فليترك ضربها أو شتمها احتراماً للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)(8).
وعلى هذا فلا يصحّ القول: بأنّ الأَوْلى ترك التسمية بأسماء الأنبياء كي لا يجلب ذلك لهم اللعنة بسبب ما قد يرتكبه المسمّى بأسمائهم من أخطاء وإساءات بحقّ الآخرين، فإنَّ احترام الأنبياء يفرض الابتعاد عن سبّ مَنْ تسمّى بأسمائهم لا ترك التسمية بها، على أنّ السبّ والشتم ليس خُلُقاً إسلامياً،
وهو لا يطال مَنْ قُصد به بل ربّما عاد وزره على مطلقه.
وفي هذا المجال يروى أنّ الخليفة الثاني غيَّر أسماء مَن كان متسمِّياً باسم الأنبياء، فقد روي أنّ رجلاً اسمه إبراهيم "دخل عليه في ولايته حين أراد أن يغيّر اسم مَنْ تسمّى بأسماء الأنبياء، فغيَّر اسمه وسمَّاه عبد الرحمن"(9)، وكانت حجّته في ذلك ما تقدّم، حيث سمع شخصاً يشتم آخر اسمه
محمّد، فقال للأخير: "إدْنُ مني لا أرى محمّداً يُسبُّ بك! والله لا تُدعى محمّداً ما دمت حيّاً وسمّاه عبد الرحمن"(10)، بيد أنّ تصرّف الخليفة هذا لاقى اعتراضاً من المسلمين الذين احتجّوا عليه بأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) هو مَنْ سمّى أبناءهم باسم محمّد، فخلَّى عنهم".
الأسماء المستوردة
لا نجد مانعاً شرعياً في التنويع والتجديد في الأسماء وتجاوز المألوف والتقليدي منها، لكن شريطة أن لا تنطلق الرغبة في التجديد من عقدة نقص، كما هو الحال لدى البعض ممّن يخجلون بأسمائهم الإسلامية والعربية، أو الذين يستوردون الأسماء من خارج حضارتهم وبيئتهم الثقافية، وما أكثر
الأسماء الغربية والأجنبية التي غزتنا وحلَّت محلّ الأسماء الإسلامية والوطنية والقومية، مع أنّها في الغالب لا تحمل مضامين ذات مغزى سواء على الصعيد العلمي أو الروحي أو الفكري وحتى الجمالي بقدر ما تعكس انبهاراً بالآخر وخجلاً من الذات.
من كتاب "حقوق الطفل في الإسلام"
نُشر في الموقع 31-7-2015
(1) مستدرك الوسائل: 15/128، كنز العمّال: 16/417.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2/281.
(3) وسائل الشيعة: 21/399، الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5.
(4) كنز العمَّال: 16/591 ــ 269.
(6) كنز العمَّال: 16/592.