قراءة في الكتاب الجديد: الفقه الجنائي في الإسلام - الردة نموذجا
الشيخ حسين الخشن
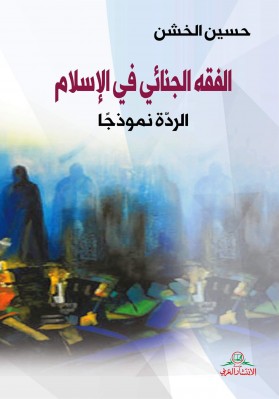
لا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه بعملية إعدام "نوعية"، تقوم بها الجماعات الإسلامية التكفيرية. ووصفها بالـ "نوعية" بلحاظ أنّه أصبح للإعدام فنون وأساليب، يُتباهى بها أمام وسائل الإعلام في العالم أجمع.
والذي يزيد الأمر حماسة، أنّ الحرق بالنار، والإغراق بالماء، والدوس بالأقدام، والقتل بالرصاص، وغيرها من فنون الإعدام، كله يحصل باسم الله الرحمن الرحيم! ولماذا الاستغراب؟ طالما أنّ الإسلام أمر بذلك، والرسول محمد (ص) ومن بعده من أئمة أهل البيت اعتمدوا هذه الوسائل لتطهير
الأرض من نجاسة المرتدين!!!
ألم يفتِ لنا فقهاء المسلمين، بحسب ما فهموا من النصوص، أنّ حكم المرتد هو القتل؟. ألم ينقل لنا العلماء أنّ الإمام علي (ع) أحرق بالنار، وأمر بالقتل دوسًا.. إذًا، لما الاستغراب!؟
والذي يفاقم الأزمة أكثر فأكثر، هو أن كبار مثقفي العالم الإسلامي يحاولون تبرير وتوجيه حكم إعدام المرتد بعدة أمور، منها: حماية المجتمع الإسلامي من أي حركة ردة تهز كيانه، فـ "إنّ عدم الوقوف الحاسم أمام حركة الردة والمرتدين قد يؤدي إلى ردات عامة ومتلاحقة، الأمر الذي يزعزع إيمان
المسلمين وعقيدتهم.."[1].
ولكن، للأسف! إنّ حكم الإعدام لم يحقق هدفه المنشود له، ولم يصل إلى الغاية التي تبرر تشريعه، بل على العكس، فهو قد ساهم في فتح باب الهجرة، أقصد الهجرة عن الإسلام، ليصبح الارتداد حلم كل شاب، يخجل من دين القتل، ويطمح إلى دين سلام ومحبة، أو – أقلّه – يطمع بمن يقيم الدليل
على براءة الإسلام من هذا الإجرام، وخاصة أنّ "قضيّة قتل المرتد قد تمّ تناولها من قبل الكثيرين بالتشكيك والاعتراض، ليس فقط من زاوية منافاتها مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان فحسب، بل ومن زاوية أنّها تمثل تعبيرًا واضحًا عن القسوة البالغة.."[2].
أما الخطباء والدعاة، وفي مقام الردّ على كل هذه الأفعال الوحشيّة، فإنّهم يستنكرون وينددون ويصرخون وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور ويبكون ويتأسفون، ولا أدري بعد ماذا يفعلون، وجمهور المسلمين ينظر إليهم نظرة الأسف والحزن..!
نعم، نظرة الأسف والحزن، والخيبة أيضًا، لماذا؟ لأنّ الناس وبكل بساطة، لم تعد تقتنع بالكلام المعسول، "وقد آن الأوان لنخرج من طوباوية الكلمات، ولغة الشعارات، والتعميمات التي تكتفي بالاستشهاد ببعض النصوص الدينية العامة الممتدحة للحرية، أو التي تتحدث عن خلق الناس
أحرارًا.."[3].
إنّ الناس ملّت من الكلام الفارغ من أي مضمونٍ علمي، وبات "المطلوب هو بذل جهود فكرية اجتهادية تأصيلية لقضايا الحرية على المستوى العقدي والفكري والتشريعي والسياسي؛ وذلك بغية تقديم إجابات مقنعة على تلك الإشكاليات والأسئلة المتلاحقة.."[4].
ومن هنا، تبرز أهميّة كتاب "الفقه الجنائي في الإسلام – الردة نموذجًا"، فهو "يطرح العديد من الأسئلة إزاء نظام العقوبات في الإسلام، ويناقش في بعض ما اعتبره الفقهاء مبادئ مسلمة في الفقه الجنائي الإسلامي.."[5]، لقد تناول سماحة الشيخ بحسٍ نقدي بارع قضيّة خطيرة أجمع عليها فقهاء
الإسلام وهي فتوى قتل المرتد، فوضعها على مشرحة البحث العلمي ناقداً ومفنداً. وهذا الأمر ليس جديدًا علينا!! فالعلامة الشيخ حسين الخشن قد عوّدنا على كتاباته الجريئة والواقعية، فها هو "العقل التكفيري" شاهد على ما نقول، وكذلك "الإسلام والعنف"، أما كتاب "هل الجنة للمسلمين وحدهم؟"
فهو صرخة علمية بوجه كل من يعطي التعصب لبوسًا دينيًا.
كتاب "الفقه الجنائي في الإسلام – الردة نموذجًا" صدر عن دار "الانتشار العربي"، بحجم A4، يصل عدد أوراقه ما يقارب 350 صفحة. وهو يتألف من سبعة فصول، كلٌ منها تحوي عناوين إشكالية مهمة وشيقة.
جولة في الكتاب..
ينطلق الكاتب من مقدمة، عنوانها "الإسلام والحرية.. علاقة جدلية"؛ ومباشرة وبكل جدية وحزم، يطلب من كل المعنيين بالدفاع عن الإسلام أن يتوقفوا عن "الحديث عن الحرية في الإسلام بلغة شاعرية أدبية تمتدح الحرية إلى حدّ التغزل، والتغني بها إلى درجة الاستهلاك، دون أن تلامس المشكلة
بعمق"[6]. ليذهب الكاتب إلى "فضاء الحرية" فيرسم حدود تطبيقها، ويضبط إيقاع حركتها "لأنّ ممارسة الحرية عندما تخرج عن القانون تغدو شغبًا وفوضى، ولا يمكن لأي نظام أو فكر أو دين أن يلتزم الفوضى أو يقرّها"[7]. أما الحاجة إلى البحث في قضية الردة، فلأنها "لا تزال
قضية حارة، وتثير لغطًا واسعًا وجدلًا كبيرًا في مختلف الأوساط العالمية، الشعبية والنخبوية والقانونية والإعلامية والسياسية.."[8]، وهكذا تنتهي المقدمة، ويشعر القارئ بأنه مع الكاتب، في الخندق نفسه، يحملان الهمّ سويًا، همّ الإسلام الأصيل، همّ الإسلام الإنساني البريء من كل الإجرام
والوحشية التي تُرتكب باسمه.
ثم يأتي الفصل الأول، وفيه يتناول الكاتب بنظرة نقديّة التبريرات التي ساقها كبار المثقفين، ودافعوا بها عن حكم قتل المرتد. صحيح، أنّ الكاتب قَبِلَ البعض منهاة وهو التبرير الذي يخرج الردة عن معناها المشهور، ويعطيها تفسير آخر فيجعلها مساوية للحرابة، أما أغلب التبريرات التي ساقها جمع
من المفكرين فقد رفضها؛ وردّ عليهم بتبرير معاكس، هو أنّه "قد يُقال إن قتل المرتد يغذي ويعزز الاتجاه النفاقي الذي يُظهر أصحابه الإسلام، ويبطنون الكفر، باعتبار أن السماح للمرتد بالإعلان عن نفسه سوف يكشفه أمام جمهور المسلمين، فيأخذون حذرهم منه.."[9]. وأيضًا إن قتل المرتد
"يشي بأنّ الإسلام يريد تركيز قواعده الفكرية التوحيدية على أساس القمع والإرهاب؛ وكأنه دين لا يستقيم إلا في ظلال السيوف وتحت وطأة الأسنة"[10].
ولذا، يحسم الكاتب موقفه من التبريرات بأنّها "لا تخلو من تكلّف وضعف، مع احترامنا الكامل لأصحابها"[11].
أما في الفصل الثاني، فيبدأ الكاتب بالتعمق أكثر فأكثر، ليصل إلى الحجر الأساس، إلى التعريف!. نعم، لا بد من إعادة البحث حتى في تعريف المرتد لأنّ "تحديد مفهوم المرتد أمر في غاية الأهمية، إذ في ضوء هذا التحديد سيتم رفع الكثير من الالتباس الحاصل"[12]. فكلنا نعلم أن أغلب
الخلافات والنقاشات التي تقع، سببُها عدم الاتفاق على حدود وتعريف المشكلة.
لذا، يطرح الكاتب أسئلة عديدة، منها: "من هو المرتد؟ وكيف يتحقق الارتداد؟.. وهل ينحصر الارتداد بإنكار الأصول فقط أم يشمل إنكار الضروري أيضًا؟ وما هي تلك الأصول، وما فرقها عن الضروريات؟"[13]، وغيرها من الأسئلة التي تبحث في جذور وأسس البناء الفكري الذي اعتمد
عليه حكم قتل المرتد.
ولا يكتفي الكاتب بهذا العمق في البحث، بل يذهب إلى النية!، ليبحث ويسأل "هل يتوقف الارتداد على إظهار الكفر بقول أو فعل، أو يكفي فيه مجرد الإنكار القلبي ولو لم يجسده بفعل أو يظهره بقول؟"[14]، وأكثر من ذلك، يسأل الكاتب عن الإسلام ومستلزماته، وأنه "هل يجب على الإنسان
أن يُشهر إسلامه، أم يجوز له البقاء متكتمًا على إسلامه، بحيث لا يعرف أحد ذلك منه؟"[15].
ثم يصل البحث إلى أوجه، فيجد القارئ نفسه أمام سؤال، غريب بعض الشيء، إنسانيٌ بامتياز، وهو عن الطفل؛ ماذا عن الطفل الذي تولد من أبوين مسلمين، ثم عاش الطفل أجواء غير إسلامية، فاختار دينًا آخر قُبيل بلوغه وشب عليه؟ هل يحكم بارتداده ويُقتل كما يرى جمعا من الفقهاء؟!.
والجواب يأتي حاسمًا، يشمل الطفل وغيره ممن ارتد عن الإسلام، فمن "لا يعرف عن الإسلام شيئًا في أصوله ومبادئه الرئيسية، بحيثُ لو سُئل: هل أنت مسلم؟ ربما أجاب بالإيجاب، ولكن لو سُئل عن أبسط الأصول والعقائد الإسلامية لتلجلج في الإجابة، أو سُئل عن كيفية اختياره الإسلام لأجاب
بأنه ورثه عن أبويه دون أن يكون له اختيار في ذلك أو قناعة. فهذا وأمثاله، يصعب صدق المرتد عليه، فيكون المرجع – والحال هذه – هو مبدأ عصمة الدماء..."[16].
ثم يتطرق الكاتب إلى الشك ودوره في صدق الارتداد، جازمًا بأن الشك في مقام البحث عن الحقيقة أمر طبيعي، "فإنّ الكثير من المسلمين قد تعتريهم وتواجههم حالة الشك المذكورة، ولا سيما في بناء العقيدة، ومع ذلك لم يُنقل لنا أنّ النبي (ص) أو الأئمة (ع) قد تعاملوا معهم معاملة
الكَفَرة.."[17].
في الفصل الثالث، يسلط الكاتب الضوء على الحدّ نفسه، ليبحث في طبيعة الحد وماهيته، ليسأل ثلاثة أسئلة:
1- هل حد الردة حكم مولوي تشريعي أم حكم تدبيري؟، فالحكم المولوي التشريعي يستمر إلى ما شاء الله، أم الحكم التدبيري فهو حكم مؤقت وظرفي؟ استدعى من النبي (ص) أو الإمام (ع) هذا التدبير بقتل المرتد؟
2- بناء على كون الحد الردة حكمًا تشريعيًا مولويًا، فهل هو حدٌ أو تعزير؟
3- هل الردة التي توجب القتل – على فرض كون عقوبة المرتد هي القتل – هي الردة التي تنطلق من عدم الاقتناع ببعض الأصول الاعتقادية، أو هي الردة على النظام العام..؟
وفي الإجابة عن السؤال الأول، ينتصر الكاتب لتدبيريّة حكم قتل المرتد، لأسباب عديدة، منها: "أن أصالة المولوية غير واضحة، فإن الرسول (ص) كما أنه مبلغ عن الله تعالى، فهو الحاكم وبيده السلطة وإدارة شؤون المجتمع، وهذا يقتضي أن يصدر عنه في كثير من الأحيان أحكام تدبيرية
سلطانية تُعنى بتنظيم شؤون المجتمع.."[18].
أما في سياق الجواب عن السؤال الثاني، فإنا نجد الكاتب وبالرغم من أنّه يناقش باحثاً معاصرًا يقول بـ تعزيرية حكم قتل المرتد. ولكنه يلتقي معه في النتيجة، فالمشكلة تكمن في المنهج الاستدلالي والشواهد المعتمدة لصاحب الرأي المذكور؛ فكاتبنا لا يتبنى لا ينتصر لرأيه بدليل غير قوي بنظره.
لكنه يخلص إلى النتيجة عينها وهي "أن مسألة القتل هي من التدبيرات المنوطة بيد الحاكم، وعليه: فلا فرق بين أن تقول عقوبة قتل المرتد هي تدبير أو تعزير منوط برأي الحاكم، فإن التعزير بهذا المعنى هو نوع من التدبير.."[19].
أمّا بالنسبة للسؤال الثالث، فإنّ الكاتب يرجّح أنّ الردة التي توجب العقوبة الدنيوية هي الردة على النظام العام وليس مجرد الردة عن الإسلام، وشواهده على ذلك عديدة، فمن حديث "التارك لدينه مفارق للجماعة" والقرائن التاريخية، مرورًا بـ الفرق في الحد بين المرتد والمرتدة، وعدم قتل المنافق،
ووصولًا إلى حركة الزنادقة وكيفية تعامل الإئمة (ع) معهم، إلى عقلائية نظام العقوبات الذي يحصر العقوبات بخصوص التجاوزات العملية، كل هذا استدعى من الكاتب "موقف حاسم بشأن طبيعة الردة التي تستوجب عقوبة إنزال القتل بالمرتد، وهي الردة على النظام الإسلامي وليس مجرد الردة
الفكرية.."[20].
الفصل الرابع "دور الزمان والمكان في ثبوت حد الردة أو سقوطه"، ويستهلّ الكاتب هذا الفصل بسؤال "عن دور الزمان والمكان في عمليّة استنباط الحكم الشرعي، وهل أنّ لهما تأثيرًا على الحكم الشرعي نفسه أو على موضوعه ومتعلقه؟"[21]؛ لينقسم الفصل إلى قسمين أساسيين، هما:
1- دور الزمان والمكان في إسقاط نظام العقوبات.
2- دخالة دور الزمان والمكان في موضوع العقوبة الشرعية.
والجواب على السؤال الأول يأتي بالنفي، "لأن فلسفة العقوبة تقتضي أن تكون إقامة الحدود وتطبيق النظام الجنائي غير منحصر بزمان دون آخر، ولا متوقفة على وجود المعصوم"[22]، ولكن مع الالتفات إلى ضرورة وجود سلطة شرعية تنفذ هذه العقوبات، لأن "إيكال أمرها إلى عامة
الناس قد يؤدي إلى الهرج والمرج واختلال النظام، والحال أن الحدود شُرعت لحفظ النظام"[23]. ثم يبحث الكاتب عن السلطة الشرعية، وهل يمكن الاكتفاء بالفقيه؟ ومن هو الإمام المذكور في الروايات؟
وأما السؤال الثاني، "وهو الأكثر أهمية في هذا المقام، فهو ملاحظة ما إذا كان لتغيّر الزمان وتبدل المكان دور في تغير الحكم الشرعي، القاضي بإقامة الحد على المرتد، من خلال تأثيره على موضوع الحكم"[24]، فهنا نجد الكاتب يميل إلى ترجيح القول بدخالة الزمان والمكان في طبيعة
العقوبة ومقدارها، وذلك بعد أن يبين لنا أنّ المقصود من الزمان ليس المقاطع الزمانية من ليل ونهار، و"إنما المقصود هو ما يصاحب تغير الزمان والمكان من تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. ومن تغير في منظومة المعرفة الإنسانية رقيًا أو تخلفًا، الأمر الذي قد تُدعى
دخالته في الموضوع، وينعكس على نظام العقوبات."[25].
وهذا الكلام قد لا يلتفت القارئ إلى أهمية هذا الكلام، وقد لا ينتبه إلى أنه "إذا تم تبنيه فإنه سيشكل انعطافة جوهرية في تاريخ الاجتهاد الفقهي.."[26].
ويبدأ الكاتب بعرض بعض النماذج الفقهية التي سوف تتتأثر نتيجتها في حال تبني الرأي المذكور، كـ تملك غنائم الحرب مثلا: فهل يمكن للقارئ أن يتصور أنّ قيادة جيش دولة ما، إذا انتصرت في الحرب، توزع الذخائر والصواريخ والدبابات على الجند، باعتبارها غنائم حرب!!، كما نصت الشريعة
الإسلامية عليها. وكذلك الحيازة بالوسائل الحديثة فهي لا تقل عن سابقتها أهمية وخطورة، إذا يمكن لثلاثة من أصحاب الأموال الطائلة، أن يحوزوا كل غابات الكرة الأرضية، فهل تصبح ملكهم، كما نصت بعض الروايات على تملك كل من يحيي أرضًا. وغيرها من الأمثلة التي تطرق لها الكاتب.
ثم ينهي الكاتب هذا الفصل في الكلام عن الردة في زمن الشبهة، في محاولة لمقارنة حكم المرتد بحكم السارق في زمن المجاعة. واستشهد بالفقيهين "الكلبيكاني والصدر" الذين استشكلا في تنفيذ حكم قتل المرتد في هذا الزمن المليء بالشبهات، بل ذهب السيد الصدر إلى اعتباره أساسًا من أسس
الحكومة الإسلامية قائلًا: "كما ينبغي أن يُعلم، أن المرتد عن الإسلام سواء كان مليًا أو فطريًا، إذا تاب وأناب، فإن الدولة تقبل إسلامه ظاهرًا وتعامله كبقية المسلمين.."[27]، ثم ذكر الكاتب قصة نقاش السيد الصدر مع السيد الخوئي (رحمة الله عليهم).
وبغض النظر عمّا سبق، ولأنَّ لزماننا هذا خصوصيته، لذا "فلو شخّص الإمام والحاكم الشرعي وجود مصلحة بتجميد تطبيق الحد، بلحاظ بعض العناوين الثانوية والطارئة، كما لو فرض أنّ تنفيذه يستدعي تأليب الناس ضد الإسلام وتشويه صورته.. أفلا يمكن والحال هذه أن يُصار إلى تجميد الحد
مؤقتًا ريثما يتم تثقيف الأمة وتهيئتها..؟"[28].
أما الفصل الخامس، فهو أكبر فصول الكتاب، وفيه يناقش الكاتب كل الأدلة التي اعتمدها الفقهاء في الاستدلال على حكم قتل المرتد. وسيلاحظ القارئ قوة المنهجية في البحث؛ فالكاتب بدأ أولا بالقواعد العامة في مسألة الدماء، لماذا؟ لأنّه عند الشك في استنباط الحكم، أو إذا لم تكن النتيجة واضحة
من الأدلة، يرجع الفقيه إلى الأصل والقواعد العامة.
يتناول الكاتب ثلاث قواعد:
1- قاعدة أصالة الصحة في المعتقدات – 2- قاعدة عصمة الدماء أو أصالة الاحتياط في الدماء – 3- قاعدة درء الحدود بالشبهات. ويدخل الكاتب في كل واحدة منها بالتفصيل والمناقشة، مع حشد الأدلة على كل منها.
وبعد القواعد العامة ينتقل الكاتب إلى عالم الأدلة الخاصة بقتل المرتد، وبدورها يقسمها الكاتب إلى قسمين: الأدلة المرجعية، المتمثلة بالقرآن الكريم والعقل؛ والأدلة غير المرجعية، المتمثلة بالإجماع والروايات.
وبداية مع القرآن، ومع جولة واسعة وشاملة يستنطق بها الكاتب القرآن الكريم، ليستوحي الجو القرآني من مسألة قتل المرتد، ثم يسجل ملاحظة ذات دلالة وهي خلو القرآن من الحكم بقتل المرتد، والأهم من ذلك أنّ الكاتب حاول الاستدلال بالقرآن على نفي قتل المرتد، مسلطًا الضوء على ما
يقارب من ست آيات، ليصل إلى آية "لا إكراه في الدين" ويتوقف عندها وقفة طويلة، ومن هنا ينطلق الكاتب مناقشًا الآراء، وخاصة السيد الخوئي (ره)، وطارحًا ما يدّعيه البعض من دعوى النسخ والتقييد في الآية، ليخلص إلى نتيجة حاسمة مفادها "إن الفتوى بقتل المرتد لا مستند إليها في القرآن
الكريم، بل إنّ القرآن لا يخلو من دلالة معاكسة، أعني على نفي عقوبة قتل المرتد"[29].
أما العقل، فهو أيضًا "لا دلالة له على الحكم بقتل المرتد كما لا يخفى، بل ربما تُدَّعى دلالة العقل على قبح قتل المرتد، وذلك بأحد التقريبين:..."[30]، ثم يذكر الكاتب التقريبين مع مناقشتهما.
أما الأدلة غير المرجعية، فيبدأ الكاتب بمناقشة دعوى أن حكم القتل ضرورة فقهية، ويثنّي بمناقشة الإجماع؛ ثم ليحطّ رحاله في ساحة الروايات. ولكن قبل عرض الروايات ومناقشتها، لا بد من ضوابط عامة تضبط حركة الفكر الفقهي ضمن سياق عقلائي في فهم النصوص.
لذلك استعرض الكاتب أربع نقاط وضوابط تحكم الروايات، هي: 1- الوثوق بالأخبار – 2- موافقة القرآن الكريم – 3- النظرة الشمولية – 4- انتفاء احتمال التدبيرية والتاريخية.
وسيجد القارئ أنَّ للكاتب في كل نقطة رأيَه الخاص، ففي النقطة الأولى يذهب الكاتب إلى الدعوة إلى اعتماد مبنى الوثوق في الأخبار، وليس مبنى خبر الثقة، مستدلا بعدة شواهد كـ الطرق العقلائية، وطبيعة الخبر وحجم انتشاره. أما نسخ القرآن وتخصيصه بخبر الواحد، فيتوقف عنده مليًا؛ لأنّ
"من وظيفة المعصوم إبلاغ شرع الله وإيصاله إلى الناس بما يحقق قيام الحجة عليهم دون لبس أو تغرير، ومن الواضح أنه عندما يصدر العام ويتم إيصاله إلى الناس بطرق شتى ويعمل بموجبه الكثيرون لمدة من الزمن، فإنه لو أُريد تخصيصه فلا يكتفي المشرّع الذي يملك أمر التخصيص بإصدار
الخاص في مجلس خاص أو في إجابة على سؤال سائل دخل عليه بشكل عرضي..."[31].
أما موافقة القرآن الكريم،( النقطة الثانية) فلا يكتفي الكاتب بعرض الروايات المتعارضة على القرآن، للأخذ بما يوافق الكتاب، بل لا بد من عرض كل الروايات على القرآن الكريم، وليس فقط لضمان موافقة المؤدى، بل المطلوب هو "الموافقة الروحية مع القرآن، بمعنى الانسجام مع المبادئ العامة
التي أرساها القرآن الكريم أو صحيح السنة، وإلا لأمكن الاعتراض على ذلك بأن المؤدى بما أنه وارد في القرآن الكريم فيكون هو الحجة، ولا حاجة بنا لتصحيح الخبر الذي ورد فيه."[32].
في النقطة الثالثة، فالنظرة المطلوبة والصحيحة في الاستنباط هي النظرة الشمولية المطلوبة، دون النظرة التجزيئية التي تعيق الباحث عن رؤية المسار العام للروايات. وفي النقطة الرابعة يرى الكاتب أنّ على الباحث أيضًا أن يبحث في احتمال تدبيرية الحكم الوارد في الروايات الناصة على قتل
المرتد، "لأنّ ظرف الارتداد إبان صدور تلك الروايات كان يصاحبه عنصر هام نفتقده اليوم، وهذا العنصر هو أن الردة كانت تترافق مع تحول المرتد إلى الصف المعادي.. ولم يكن الارتداد مجرد حالة فكرية تنطلق من عدم الاقتناع ببعض المفاهيم الدينية المقومة للاعتقاد الإسلامي."[33].
وبعد ذلك كله، يصل الكاتب إلى عالم الروايات، ويستعرض ما يقرب من عشرين رواية!، من طرق الفريقين، السنة والشيعة. وسيجد القارئ نقاشًا موضوعياً مستوعبًا لكل الروايات، فالكاتب يناقش في السند وفي المضمون، ويطرح كل الاحتمالات الواردة على فهم النص. ولا يكتفي الكاتب بعرض
ومناقشة الروايات التي يُستفاد منها حكم قتل المرتد، بل يستعرض أيضًا الروايات المعارضة، والتي تصلح لمعارضة روايات قتل المرتد.
ولقد أعرضتُ عن ذكر الروايات لأنها كثيرة، وأُحيل القارئ إلى الفهرس، فهرس الكتاب التفصيلي، ويمكن من خلاله معرفة عناوين الروايات المطروحة من قبل الكاتب.
أما الفصلين الأخيرين، الفصل السادس والسابع، فهما يمثلان تكملة لاستيفاء البحث. ففي السادس، يتكلم الكاتب عن حركة الزندقة في التاريخ الإسلامي، مع شيء من التفصيل عن الزنادقة وأسمائهم وكيفية تعامل الأئمة(ع) معهم.
أما الفصل الأخير، فيأخذنا الكاتب فيه في جولة تاريخية إلى الردة الأولى في الإسلام، وهي التي حصلت في زمن الخليفة أبي بكر، ليتكلم عنها، مبيناً حجمها الطبيعي، وما جرى تضخيمه فيها، ولينهي هذا الفصل بـتأكيد مشاركة الإمام علي (ع) مع أبي بكر في حرب الردة.
هذا الكتاب، يمكن وصفه بـ السهل الممتنع؛ لأنّ قلم الكاتب يتمتع بعذوبة، تسمح للكلمات أن تنساق بكل سهولة إلى ذهن القارئ. ولكن بالمقابل، في الكتاب مضمون متين وعميق، ومبانٍ فقهية ومناهج فكرية شيدها الكاتب وأخرى ناقشها.
الشيخ نبيل يونس
نُشر على الموقع في 21-8-2015
[9] الفصل الأول، ص 35-36.
[19] الفصل الثالث، ص 105.
[20] الفصل الثالث، ص 116.
[21] الفصل الرابع، ص 119.
[22] الفصل الرابع، ص 121.
[23] الفصل الرابع، ص 121.
[24] الفصل الرابع، ص 129.
[25] الفصل الرابع، ص 129.
[26] الفصل الرابع، ص 130.
[27] الفصل الرابع، ص 138.
[28] الفصل الرابع، ص 143.
[29] الفصل الخامس، ص 193.
[30] الفصل الخامس، ص 193.
[31] الفصل الخامس، ص 205.
[32] الفصل الخامس، ص 209.
[33] الفصل الخامس، ص 212.