قراءة في كتاب العقل التكفيري، خالد غزال
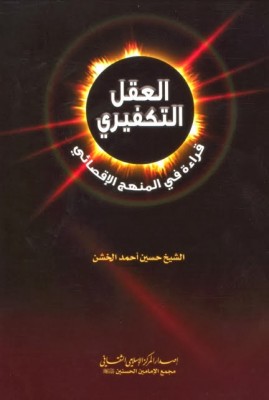
الشيخ حسين الخشن لبناني المولد، عضو هيئة أمناء مؤسسات المرجع الراحل محمد حسين فضل لله، الذي كان من القلائل في المؤسسة الدينية الذين قدموا اجتهادات في النص الديني والشريعة تتناقض مع الكثير من السائد في صفوف هذه المؤسسات، إضافة إلى معارضته لنظرية ولاية
الفقيه[1] الإيرانية، مما أثار عليه حنق رجال الدين والاحزاب التابعين لها، فاتهم بالكفر والارتداد والانحراف عن الخط السياسي للأحزاب والمذاهب الشيعية. كانت باكورة كتابات الشيخ الخشن كتابه :“الإسلام والعنف.. قراءة في ظاهرة التكفير” الذي صدر منذ حوالي عشر سنوات. يتابع في
كتابه الجديد “العقل التكفيري : قراءة في المنهج الإقصائي” مناقشة هذه المسألة في الإسلام تحديدًا، ويقاربها من زاوية النصوص الدينية والأحاديث النبوية من جهة، ومن خلال المنهج العقلي وكل ما يتصل بحقوق الإنسان من جهة أخرى
.
ينطلق الشيخ الخشن من القول بأن التكفير ليس حالة جديدة أو مقتصرة على الإسلام، فهو ظاهرة إنسانية عامة وعابرة للطوائف عرفتها جميع الأديان التوحيدية من دون استثناء، كما مارستها الأيديولوجيات غير الدينية ذات الطابع الشمولي. وإذا كانت الظاهرة تبدو بادية على السطح بقوة في ما
يخص الدين الإسلامي من خلال أحزابه وتنظيماته السلفية والجهادية المتطرفة، إلا أن التاريخ المسيحي، قبل عدة قرون، كان أشد وحشية في التزام ظاهرة التكفير والقتل استنادًا إليها، ولم ينج منها مؤمنون وعلماء وأدباء وفلاسفة. من موقعه كرجل دين، يحاول الشيخ استقراء المنهج الإسلامي
القرآني والنبوي في إدارة الاختلاف بين المسلمين أنفسهم وبين غيرهم من أبناء الطوائف الأخرى. إسلامياً، لا يرى أن “ثقافة” جز الرقاب وقطع الأعناق وليدة عصرنا الراهن، بل هي تمتد إلى العصور الإسلامية الأولى، وتحديدًا إلى ما بعد معركة صفين ونشوء فرقة الخوارج التي استباحت دماء
المسلمين من أنصار الإمام علي ومعاوية على السواء. تتركز مقارباته في قسم أول على النصوص الدينية ومحاولة تطويعها لجعلها بعيدة عن تهمة التكفير. وعلى رغم أن الشيخ ينتمي الى المؤسسة الشيعية، إلا أنه يحاول أن تطال مقارباته مجمل الإسلام بمذاهبه المختلفة
.
يرى الشيخ أن أحد شروط خروج الأمة الإسلامية من نفق التكفير والتكفير المضاد وتداعياته، لن يكون ممكناً إلا بعد الإتفاق على ضوابط الإسلام والكفر ورسم الحدود الفاصلة بينهما. يقول :“إن التأمل الدقيق في الكتاب والسنة يقودنا إلى القول : أركان الإسلام التي يلزم الاعتقاد بها هي على
نوعين: اــ الأركان التي يقوم بها الإسلام ويكون للإيمان بها موضوعية تامة في انتساب الإنسان إلى الإسلام، وإنكارها، أو إنكار واحدة منها هو في نفسه موجب للكفر (الإيمان بالله ووحدانيته، الإيمان بنبوة محمد، الإيمان بالمعاد). 2ــ الأركان التي يلزم الأيمان بها أو العمل بمضمونها دون أن
يكون إنكارها مستلزما للكفر (كل ما يعرف بضرورات الدين العقدية :العصمة عند النبي، الإمامة عند الشيعة..)” . إذا كان النوع الأول يوجب التكفير، فإن النوع الثاني وما تبعه خصوصا من اجتهادات وضعت في مراحل زمنية مختلفة خصوصاً في القرون الأخيرة لا تحتم الكفر، وإن كان بعض
رجال الدين قد خلطوا بين الأصول في الدين وبين ما يعرف بالفروع، فبات كل من يعارض فتاواهم يرمى بالكفر
.
يطرح الشيخ سؤالاً جوهرياً يتصل بمفهوم إسلامي سائد حول أن كل من ليس مسلماً فهو بكافر، وهو قول لم يأت اجتهادًا فقهياً، لأن النص القرآني يقول بصريح العبارة “إن الدين عند الله الإسلام”، فيحاول إيجاد مخارج لهذه الآية، فيعتبر أن الكفر ليس مجرد إنكار الأصول الأساسية للإيمان أو
التشكيك بها ، بل هو الجحود بتلك الأصول، فيما لا يرمى الباحث المتشكك في العقيدة بالكفر “لأن الشك ليس جحودًا”. ينتقد المسارعة في التكفير، في ظل موجة سائدة اليوم من التكفير والتكفير المضاد من دون ضوابط أو قيود. يشير إلى أن الأمة“ابتليت بجماعة من إنصاف المتفقهين الذين
يتعجلون في الإفتاء بارتداد من يخالفهم الرأي في بعض المسائل العقائدية أو حتى الفقهية والتاريخية”. أما الضوابط فيراها خمسة : التثبت من الكفر، العلم بالمكفرات، العمد أو القصد، الاختيار، إنتفاء الشبهة" .
في نقاشه للضوابط الشرعية والأخلاقية، يتطرق الشيخ إلى عدد من المسائل التي تحاول الحد من غلو التكفير والمكفرين في الإسلام. يتساءل :“هل الأصل في الإنسان أن يكون محترم النفس والعرض والمال بصرف النظر عن معتقده ودينه وعرقه، أم أن الأصل هو عدم الإحترام إلا من أخرجه
الدليل وهو المسلم أو من كان بينه وبين المسلمين عقد معين يمنحه الإحترام؟”. إذا كان بعض الفقهاء يرفضون إعطاء حرمة واحترام لغير المسلم ، فإن الشيخ يرفض هذه التوجهات معطياً الأولوية للإنسان بشكل مطلق بصرف النظر عن دينه، لأن الإنسان هو خليفة الله على الأرض وهو في
موضع التكريم الإلهي، والتكريم هو “لابن آدم وليس لجماعة دينية أو عرقية أو قومية بعينها”. وإن الشريعة الإسلامية، على غرار كل الشرائع السماوية هدفت إلى تحقيق العدل في الأرض، والرسل أتوا لتحقيق هذه الغاية. كما أن الإسلام، وفق ما يراه الشيخ، لم يلزم غير المسلمين بالعبادات
والطقوس الإسلامية، بل منح أهل الكتاب منهم حرية دينية كاملة. كما أن القاعدة الأساسية في الإسلام هي محقونية الدماء وعصمتها بغض النظر عن هوية أصحابها المذهبية والدينية. كما يشيرالشيخ إلى أن الإسلام لا يدعو إلى القطيعة مع الآخر، بل يدعو إلى الانفتاح على الآخر مع اشتراط
الحفاظ على الهوية، لكن المشكلة تكمن في فتاوى الفقهاء التي تدعو إلى الانفصال والقطيعة مع غير المسلم، بما يؤسس للحقد والكراهية واستخدام العنف .
يناقش الشيخ الخشن دوافع التكفير وعوامل نشوئه وآثاره السلبية، يعتبر أن الظروف الاجتماعية القاسية وما يستتبعها من قهر وظلم واستبداد سياسي تشكل تربة خصبة لنشوء ظاهرة التكفير، وتساعد العوامل السياسية في تسعير الظاهرة. يعدد جملة عناصر ساهمت ولا تزال في تكريس التكفير،
منها العقل العربي في تقديس التراث الإسلامي، الذي يشكل أحد عناصر التكفير الأساسية. يحتاج هذا التراث إلى نقد وغربلة وإخضاعه للمقاييس التاريخية المتصلة بزمانه ومكانه. لعل أهم ما يستدعي في نقد التراث هو الأحاديث النبوية وأحاديث الصحابة والأئمة، التي يجب أن تخضع للتحليل
العقلي والمقاييس العلمية، وذلك لما يحيط بها من شكوك، بالنظر إلى ارتباط توسعها بالصراعات الاجتماعية والسياسية في عصور الإسلام، واختراع كل فرقة أو طرف لجملة أحاديث تصب في خدمة مشروعه السياسي في السلطة. ويعتبر الشيخ أن النموذج الأبرز لأحاديث التكفير تلك المتعلقة
بالفرقة الناجية، حيث ترى كل فرقة أو مذهب أو طائفة أنها الفرقة الناجية فيما الآخرون على ضلال ومصيرهم جهنم وبئس المصير.
ومن عوامل نشوء التكفير تلك النظرة السطحية إلى تعاليم الدين وقيمه الإنسانية والأخلاقية والروحية، وهي نظرة تصدر عن جهل وتسبب الانغلاق وبالتالي الصدام. تتمثل هذه الظاهرة برجال دين نبتوا كالفطر في العقود الأخيرة، يحملون في تعاليمهم وإرشاداتهم القليل من الدين والكثير من
التحريض الطائفي والمذهبي، سواء تجاه المسلم أم غير المسلم. ترتبط بهذه الظاهرة المبالغة في التشدد الديني، ليس الجوهري منه بمقدار الشكلي والسطحي، بحيث وصل الأمر ببعضهم إلى درجة المزايدة على الأنبياء والأولياء.
يخصص الشيخ الخشن فصلا من كتابه في توصيف الشخصية التكفيرية، فيرى أنها محكومة بالاستعلاء والغرور وادعاء امتلاكه الجنة، إضافة إلى الحقيقة المطلقة التي وحده ينطق بها. هذه الشخصية تتلهى بالصغائر والشكليات وتتجاهل أساسيات الدين، لجهل بها أحياناً كثيرة. ولعل أبرز ميزات
هذه الشخصية اعتماد العنف والقسوة في مواجهة الآخر، وعدم الاعتراف برأي مخالف لرأيه. وتتسم هذه الشخصية أيضاً بالانكباب الأعمى والشكلي على العبادات، وتهتم بجعل الجباه سوداء من كثرة السجود، وللهج دائماً بذكر الله إظهارًا لتدينهم، ناهيك عن إطالة اللحى واللباس الخاص تدليلاً
على هويته وطبيعته. وهذه الشخصية تتسم بالانغلاق وتبدو معلبة في إطار محدد، وتشدد على إحلال الثقافة التعبدية محل الثقافة العقلانية النقدية. وهي إلى جانب ذلك مصابة بالتسليم الأعمى للسلطة سواء أكانت سياسية أم دينية، والتنظير للطاعة والاستسلام.
من موقعه كرجل دين، يقدم الشيخ الخشن بعض التوجهات التي تضع حدًا للعقل التكفيري أو تحد من غلوائه، فيرى ضرورة لوضع حد للفوضوية الشاملة في شأن التكلم عن الدين ووضع حد لهؤلاء الذين يسرحون ويمرحون في التحليل والتحريم. وفي موضع التراث، يرفض الدعوة إلى القطيعة
معه بمقدار رفض تقديسه، وهو ما يستوجب التدقيق بما لا يزال متناسباً مع العصر، واعتبار نصوصه متصلة بزمن وضعها ومكان صدورها. ويرفض حصر النصوص الإسلامية بالمصطلحات الموروثة من التراث، بل واجب المسلمين الانفتاح على المفاهيم السياسية والاجتماعية، لأن الالفاظ
والمفاهيم ليست مقدسة، وعلى سبيل المثال لا داعي للإعراض عن كلمة الديمقراطية تحت حجة أن هناك مفهوم الشورى الكافي للتعبير عن هذا المفهوم السياسي. ويدعو أخيرًا إلى خطاب إسلامي متوازن بما يراعي حاجات العقل والقلب على السواء.
مما لا شك فيه أن مقاربة الشيخ الخشن للعقل التكفيري، وقبله لظاهرة العنف في الإسلام، تعتبر خطوات متقدمة من أحد أركان المؤسسة الدينية، وهي مقاربة نادرة لدى رجال الدين المسلمين لأي طائفة أو مذهب انتموا. لكن النقاش مع الشيخ والمؤسسة الدينية يجب أن ينطلق من كون الاتهام
بالتكفير هو هرطقة بحد ذاتها. نظرياً، يرتبط التكفير بالاعتقاد الديني أو عدمه وبالارتداد عن الدين. إن وقائع التاريخ تظهر كم أن مسألة الإيمان بالله أو اللإيمان لم يكونا يشكلان سوى القشرة التي تختفي وراءها نزعة الصراعات السياسية والاجتماعية والهيمنة على السلطة من قبل الطوائف
والمذاهب والفرق، سواء أكان ذلك في المسيحية أم في الإسلام. وبالنظر إلى أن ظاهرة التكفير تشكل اليوم سمة إسلامية غالبة، يصبح من الضروري نقاشها من جوانب متعددة في وصفها هرطقة بكل معنى الكلمة ولا تنتسب إلى الدين الحق وجوهره بأي صلة.
إن مسألة الإيمان بالله وفق المعتقدات اللاهوتية مسألة جوانية تتصل بداخلية الإنسان في علاقته بربه. لا أحد يستطيع أن يدخل إلى قلب إنسان ليعرف ما إذا كان مؤمناً أم غير مؤمن. الله وحده يعلم ما في القلوب، كلام تردده الأديان جميعها، مما يعني أن لا احد يمكنه الجزم في إيمان إنسان أو عدم
إيمانه. إذا كان الرأي الشائع لدى المؤسسات الدينية أن مقاييس الإيمان والالتزام بالدين هي ممارسة الطقوس والشعائر والإكثار من الذهاب إلى الكنائس والجوامع، فهذه حجة لا تقدم ولا تؤخر في صدقية الإيمان أم عدمه. تفتح هذه النقطة على الجوهري في الرسالة الدينية، وهي القائمة على
الأخلاق والمعاملة الحسنة للناس ومحبة المرء للآخرين كما يحب لنفسه والتفاني في خدمة المظلومين، والتسامح والمغفرة لمن أساء إليك، والرحمة اللامتناهية كما يفتتح القرآن سوره بالآية “بسم الله الرحمن الرحيم”.. أي أن الدين هو الأخلاق والمعاملة، وهذه عمليا تشكل مقياس الإيمان بالله
ورسالته السماوية، وليس الإكثار من السجود والتراتيل والأناشيد وغيرها.
إذا كانت تلك مقاييس الالتزام بالأديان، فكيف يحق لرجل الدين هذا أو ذاك أو لأي مؤسسة أن ترمي المرء بالكفر استنادًا إلى شكليات الممارسة الدينية وليس إلى جوهر هذه الممارسة؟ ومن يضمن لنا أن رجل الدين هذا، كبر شأنه أم صغر هو مؤمن فعليا؟ هل دخل أحدإالى قلبه ليحسم في إيمانه؟
وهل تصنيفه أنه رجل دين يعني آلياً ذروة الإيمان والحق في الحكم على البشر؟ وهل أعطاه الله سلطة تصنيف البشر أم أن هذه السلطة هي بشرية بامتياز ولا يحق له اعتبارها إلهية ينوب فيها عن الله في التصنيف أن هذا الإنسان كافر أو مؤمن؟. لذا لا يحق لرجل الدين مهما كان شأنه الدخول
في تصنيف الناس وفق النوايا أو بحسب ما يرغب استنادًا الى عدم التوافق مع رأي هذه المؤسسة الدينية أو تلك.
منذ قيام الأديان وتحولها مؤسسات كهنوتية، لم ينقطع الصراع حول حق المرء في أن يلتزم هذا الدين أم لا يلتزمه. في الإسلام نفسه ترد نصوص تقول بحرية المرء في اختيار الدين أو عدم الاختيار. “لا إكراه في الدين”، آية تمثل ذروة حرية الإنسان في الإيمان بالله ورسله، أو بالالتزام بغير الدين
الإسلامي وبحرية البشر في اختيار الدين الذي يرغبون فيه، أو حتى في رفض الالتزام بأي دين. المقياس يظل كيف يمارس الإنسان في الحياة العملية وكيف يطبق جوهر الرسالة الدينية بما هي الأخلاق والتسامي الروحي والعلاقات الإنسانية الحسنة. تغض المؤسسات الدينية النظر عن آيات
الحرية في الالتزام الواردة في النص القرآني المقدس، وتذهب إلى إظهار آيات التكفير لمن لا يؤمن بالله ورسوله.
لا أحد ينكر أن القرآن يحوي آيات تندد بالكافرين وتدعو إلى قتلهم أحيانا، بما يبدو مناقضاً كلياً للآيات التي تشدد على حرية المرء في اختيار دينه. انجدلت آيات التكفير بآيات العنف في القرآن، وهي نزلت في مرحلة نشر الدعوة الإسلامية وما واجهها من تحديات ومعاداة لها وللرسول. هذه الآيات
لها ظروفها التاريخية التي لم تعد نفسها اليوم. المشكلة المركزية التي يعاني منها الإسلام خصوصاً في مرحلته الراهنة تتصل بكيفية التعاطي مع النص المقدس وقراءته. عندما يتم الفصل في النص على ما هو جوهري في الرسالة المحمدية وهو الدعوة إلى الإيمان بالله وتطبيق مباديء الأخلاق
والمحبة بين البشر، وهي مباديء تتجاوز الزمان والمكان، وبين آيات نزلت لأسباب محددة تتصل بظروف تاريخية كانت سائدة، وانتهت مفاعيلها مع انتهاء تلك المرحلة التاريخية وظروفها التي استددعت نزولها، عندها فقط يستعيد النص الديني جوهر الأهداف والقيم التي يدعو إليها في الأصل. هذا
التمييز ينزع عن الإسلام أنه دين العنف، ويجرد تنظيمات الإسلام السياسي من خطف الإسلام واعتبار ما ورد في آيات العنف والتكفير هي الإسلام وحده. في أي حال، لا يحتاج الأمر إلى تفكير ليرى أن عدم التمييز في آيات النص المقدس جعلت من التنظيمات المتطرفة تدعي أنها تطبق الإسلام
ودليلها على ذلك الآيات الواردة في القرآن. هكذا نجد أن سوق التكفير رائج على كل الجبهات، بحيث نشهد عليه يومياً بتكفير هذا الطرف لذاك ورميه بارتداد ثم ممارسة التنكيل والقتل بحق أبنائه، كله تطبيقا لكلام الله ورسوله.
لم تعد حرية الاعتقاد مسألة دينية في العصر الحديث، بل باتت جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العامة، وتمثل جوهر التقدم البشري ومدى تجاوز موروثات التخلف. لم يعد الدين، أي دين، مرجعاً في ما يحق للإنسان أو ما لايحق، بل باتت شرعة حقوق الإنسان والمواطن هي المقياس لحرية
الإنسان والخروج من العبودية والحق في التعبير والالتزام والاعتقاد. تختصر هذه الفقرات حقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي بات المرجع الأساسي في هذه المسائل :“يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميرًا،
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرًا أم جهرًا، منفردًا أم مع الجماعة... لكل شخص الحق في
حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
نُشر على الموقع الرسمي للشيخ حسين الخشن في 12-5-2016
الرابط للمقال على الصفحة الإلكترونية "الأوان" http://alawan.org/article15083.html
[1] إنّ هذه النسبة حول الموقف السلبي لسماحة السيد فضل الله من ولاية الفقيه تحتاج إلى تدقيق (الموقع الرسمي للشيخ حسين الخشن)