تأملات في نصوص الردة(4)
الشيخ حسين الخشن
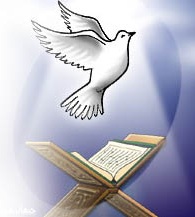
لا زلنا نستعرض الروايات الواردة في حد الردة الواردة من طريق الأئمة من أهل البيت(ع) مع ما يرد عليه من ملاحظات وتأملات.
حديث الوطء بالأقدام:
الحديث الثاني هو ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله(ع): أن رجلاً من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين(ع) فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره، ثم قال: "طئوا يا عباد الله فوطئ(فوطؤوه) حتى مات" (الكافي 3/152. التهذيب 10/137، الفقيه 3/152).
ولنا مع هذه الرواية وقفتان: الأولى: مع السند، والثانية: مع الدلالة والمضمون.
أما الوقفة الأولى:
فإن السند غير نقي. قال المجلسي في مرآة العقول23/397 :" ضعيف على المشهور" وصرّح بضعفه أيضاً بعض الفقهاء (كتاب الطهارة للسيد الكلبيكاني ج1/354) والظاهر أن الخدشة في السند لدى هؤلاء العلماء هي بسبب اشتماله على موسى بن بكر الذي وقع الخلاف في وثاقته، وقد اعتمد السيد الخوئي في توثيقه على شهادة صفوان بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا (معجم رجال الحديث:20/33).
أما الوقفة الثانية:
فإن الحديث ـ دلالة ومضموناً ـ موضع تأمل من جهتين:
الأولى: أنه مع كون الحديث وارداً بحسب الظاهر في المرتد الفطري، كما اعترف به بعض الفقهاء (كتاب الطهارة للسيد الكلبيكاني ج1/354) فقد حكم باستتابته، فيكون معارضاً لما دلّ على عدم استتابته، اللهم إلاّ أن يقال: إن الحديث ـ لا سيّما مع كونه ينقل قضية بعينها ـ لا يأبى الحمل على المرتد الملي.
الثانية: إن المعروف في القتل قصاصاً أوحداً هو القتل بالسيف إلاّ في موارد محددة كالرجم، وهو المصرح به من بعض الفقهاء في حدّ الردة (تحرير الأحكام للعلامة الحلي 5/294 وروضة الطالبين للنووي7/310)، أما القتل بطريقة الوطء بالأقدام فهو غير معهود في إقامة الحدود، ولم نجد من أفتى به، بل إن هذه الطريقة لا تخلو من غرابة تماماً كطريقة الرجم، ما يثير الاهتمام بشأنها ويحرك حفيظة الرواة لنقلها بشكل متزايد، مع أننا لم نعثر ـ وخلافاً لقضية الرجم مثلاًـ على أي ذكرٍ لها في مصادر المسلمين، باستثناء خبر واحد وهو الخبر المتقدم، الأمر الذي يثير الريبة في الرواية ويزيدها شذوذاً، ويحدّ من إمكانية الاعتماد عليها في قضايا القتل وسفك الدماء.
على أن لنا أن نتأمل في طريقة القتل هذه أعني طريقة الوطء بالأقدام من جهة أخرى وهي إن هذا الأسلوب لا ينسجم مع روح الإسلام وتعاليم النبي(ص) التي أمرت وأوصت بمراعاة جانب الرحمة واجتناب القسوة عند تطبيق الحدود أو الاقتصاص من الآخرين، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "إن الله كتب (يحب) الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"(صحيح مسلم 6/72)، واستناداً إلى هذا الحديث أفتى الفقهاء بأنه لا بدّ من "التفحص عن حال السيف ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذِّب(المسالك 15/234)، وقد منع الإسلام أيضاً من التجاوز في تطبيق الحدود معتبراً أن ذلك ظلم واعتداء يستحق فاعله القصاص، ففي الحديث عن أبي عبدالله(ع): إن لكل شيء حداً ومن تعدى ذلك الحد كان له حد"، وفي رواية أخرى عن أبي جعفر(ع) قال: إن أمير المؤمنين(ع) أمر قنبراً أن يضرب رجلاً حداً، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي(ع) من قنبر بثلاثة أسواط"(الوسائل 28/17 الباب3 من أبواب الحدود والتعزيرات).
وهكذا فقد جاء في وصايا الأئمة من أهل البيت(ع) النهي عن ضرب المحدود في أوقات الحر أو البرد الشديدين، وإنما يؤخر في الصيف إلى الساعة التي تبرد فيها حرارة الطقس، ويؤخر في الشتاء إلى الساعة التي ترتفع فيها درجة الحرارة. (راجع الوسائل28/21).
هذا في الحدود، والأمر عينه نجده في القصاص فلا يجوز لولي الدم أن يسرف في القتل كما نصّت الآية الشريف {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً} وقد أفتى الفقهاء بضرورة استخدام السيف في القصاص دون غيره من طرق القتل حتى لو كانت الجناية بالتغريق أو التحريق أو نحوهما (المسالك15/235، الجواهر42/296)، والوجه فيه ما ورد في الصحيح عن الإمام الصادق(ع): عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أَيُدْفَعُ إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:" نعم، ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف"(الوسائل29/126)، وغير ذلك من النصوص المانعة من قتله بغير السيف أو الإسراف في قتله أو التمثيل به (المصدر نفسه، وجامع أحاديث الشيعة الباب 53 من كتاب القصاص والديات) وهذه الأحكام وإن كانت واردة في القصاص لكن يمكن تعديتها إلى الحدود، إما بدعوى الأولوية باعتبار أنه إذا كان التجاوز في حدود الناس ممنوعاً فبالأولى في حقوق الله، لأنها مبنية على التخفيف، وإمّا لأن التعليل الوارد في هذه النصوص بالإسراف والعبث والمثلة هو أشبه بالمفاهيم الآبية عن التقييد والتخصيص.
بملاحظة ما تقدم فإن أسلوب الوطء بالإقدام في إقامة الحد يستوقف الإنسان لجهة عدم انسجامه مع روح النصوص والتعاليم الأنفة.
وفي ضوء هذه الروح فقد استشكلنا في بعض المقالات السابقة في قضية التحريق المنسوبة إلى أمير المؤمنين(ع) وأما قضية الرجم وقساوته فهي لولا تسالم المسلمين وتواتر نصوصهم وكونها معروفة في الشرائع السماوية السابقة على الإسلام لكانت محلاً للتأمل.
حديث نفي التوبة:
ومن أشهر الأحاديث الواردة في قتل المرتد عن طريق أهل البيت(ع) صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد؟ فقال: "من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويُقسَّم ما ترك على ولده"(الوسائل الباب1 من أبواب حد المرتد الحديث2).
أقول: لا غبار على الرواية من جهة السند خلافاً للمقدس الاردبيلي (مجمع الفائدة13/320) حيث اعترض على سندها وعبّر عنها بالحسنة، والوجه في ذلك اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم وهو ممن لم تثبت وثاقته بنظر جمع من الإعلام، إلاّ أن الصحيح وثاقته كما حقق في محله فلا غبار على الرواية سنداً، أجل تبقى خبراً واحداً وقد عرفت إشكالية الاعتماد في قضايا الحدود وأمثالها على خبر الواحد، ومع صرف النظر عن ذلك فإن الرواية لا تخلو من إشعار بعدم بداهة الحكم بقتل المرتد في زمن الإمام الباقر(ع) كما يشهد بذلك وقوع القضية مورداً للسؤال من قبل الفقيه المعروف محمد بن مسلم وهو من أصحاب الإجماع الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام(معجم رجال الحديث:18/260).
إلى ذلك فقد أثير في وجه هذه الرواية وسواها من الروايات التي نفت قبول توبة المرتد ملاحظة وهي: إن ظاهرها عدم قبول توبته مطلقاً ظاهراً وباطناً، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، "أمّا باطناً فيمكن دعوى القطع به لعموم رحمته تعالى وفضله على العباد" واستحالة أن يرد الله أو يغلق بابه في وجه من آمن وتاب إليه فضلاً عن أن يعذبه عذاب الكفار، بل لعل ذلك مخالف لأصول العدلية كما يرى الإمام الخميني رحمه الله (كتاب الطهارة 3/632) إن النصوص القرآنية والحديثية المستفيضة بل المتواترة الواردة في توبة الكافر والفاسق آبية عن التقييد، قال تعالى:{ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً إلاّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً}(الفرقان68-69)، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: "من كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر، ثم تاب بعد كفره، كُتِبَ له وحُسب كل شيء كان عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره"(الوسائل الباب99 من جهاد النفس) وهكذا لا يمكن الالتزام بعدم قبول توبته ظاهراً، لأن المرتد ملياً كان أو فطرياً بعد توبته وقبل إقامة الحد عليه مكلف بالصلاة والصيام والزكاة والحج ويجوز له الزواج بالمسلمة ودخول المساجد إلى غير ذلك من أحكام المسلمين ولا يمكن التفوه بإنكار ذلك، ما يعني أنه لا يمكن الحكم بنفي قبول توبته ظاهراً لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، لأنّ عدم قبول توبته والحكم بكفره يعني عدم صحة الصلاة أو الصيام منه ولا يسمح له بدخول المسجد الحرام للحج، فكيف يُكلف بالصلاة والصيام والحج مع عدم صحتها منه! وهل هذا إلا تكليف بما لها يطاق (الروضة البهية 9/337، والمسالك13/34، والتفتيح للخوئي3/228، والغنائم5/371).
وحاصل الملاحظة التي نريد تسجيلها في المقام: إنّ الحكم بنفي قبول توبة المرتد ـ في الرواية ـ لا يمكن القبول به على إطلاقه، أما توجيه ذلك بأنّ الإطلاق المذكور في نفي التوبة قابل للتقييد والتخصيص بخصوص الأحكام الثلاثة المذكورة في الرواية وهي: الحكم بقتله، وبينونة زوجته، وتقسيم تركته، فنفي التوبة محمول على خصوص الأحكام المذكورة لا مطلقاً، إن هذا التوجيه خلاف الظاهر وإن صار إليه والتزم به معظم الفقهاء المتأخرين وحاولوا توجيهه ببعض القرائن التي لا تخلو من تأمل(راجع مستمسك العروة2/118)، الأمر الذي يوهن الرواية ويحول دون حصول الوثوق بها.