المذهب الربوبي: مفهومه ودوافع اعتناقه
الشيخ حسين الخشن
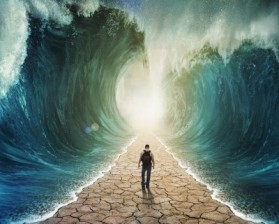
أولاً: ما هي الربوبية؟ -
ثانياً: الربوبيون بين الماضي والحاضر -
ثالثاً: الدوافع نحو الربوبية -
نحاول في هذا المقال أن نطلَّ إطلالةً للتعريف بالربوبيّة وأهم أفكارها وشيءٍ من تاريخها ورموزها، ثمّ نعرّج على بيان ومعرفة أهم الدوافع التي تقف خلف انتشار هذا الفكر، وسوف نعتمد في التعريف بالربوبية ومتبنياتها الفكرية على ما ينشره الربوبيون على المواقع
الإلكترونية الرسميّة والتي تتحدث باسمهم.
أولاً: ما هي الربوبية؟
الربوبية هي تعريب للكلمة الإنكليزية Deism ، وبحسب تعريف الأستاذ في جامعة تكساس روبرت س. سولمون Robert C. Solomon ، فإنّ الربوبية هي «الاعتقاد بضرورة وجود إله خلق العالم بكل قوانينه، ولهذا يقبل مذهب الربوبية، عادة، بصورة من صور الدليل
الكوني ولكنه يؤكد، مع ذلك، على عدم وجود تبرير عقلي للاعتقاد بأن الله يولي اهتماماً خاصاً بالإنسان والعدالة الإنسانية، ويرفض أي صفات تشبيهية نضفيها على الذات الإلهية، كذلك الاعتقاد بالقصص التوراتية حول الإله".
وقال آخرون في تعريفها أنّها: «مذهب فكري لا ديني و فلسفة تؤمن وجود خالق عظيم خلق الكون، وبأنّ هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين. فقوام هذا المذهب هو الاعتقاد بالدين "الطبيعي natural
religion" أي الذي لا يعتمد على الوحي. ومعظم الربوبيين يميلون إلى رفض فكرة التدخل الإلهي في الشؤون الإنسانية. والربوبية تختلف في إيمانها بالإله عن المسيحيّة و اليهودية و الإسلام وباقي الديانات التي تستند على المعجزات والوحي، حيث يرفض الربوبيون فكرة أنّ
الإله كشف نفسه للإنسانية عن طريق كتب مقدسة. ويرى الربوبيون أنّه لا بدّ من وجود خالقٍ للكون والإنسان، فيختلفون بذلك عن الملحدين أو اللاربوبيين بينما يتفقون معهم في اللادينيّة ".
وعرف عن الربوبيين أنّهم «يرفضون معظم الأحداث الخارقة كالنبوءات و المعجزات و يميلون إلى التأكيد على أنّ الله (أو « الإله» أو « المهندس العظيم الذي بنى الكون» ) لديه خطة لهذا الكون، وهي لا تتغيّر، سواء بتدخله في شؤون الحياة البشريّة أو من خلال تعليق
القوانين الطبيعية للكون. ما تراه الأديان على أنه وحي إلهي وكتب مقدسة ، يراه معظم الربوبيين على أنه تفسيرات صادرة عن البشر".
وعن منشأ هذه الفكرة وزمان انطلاقها يقول روبرت س. سولمون: «والربوبية بوصفها تنويعاً على الديانة اليهودية - المسيحية كانت منتشرة على نطاق واسع بين العلماء المتدينين في القرن الثامن عشر الميلادي".
وتذكر مصادر أخرى أنّ الربوبية «برزت في القرن السابع و القرن الثامن عشر خصوصاً خلال عصر التنوير ، لا سيما في ما يعرف الآن بالمملكة المتحدة و فرنسا و الولايات المتحدة وأيرلندا . ومعظم الربوبيين في ذلك الوقت كانوا قد ولدوا مسيحيين ولكن تركوا المسيحية
بسبب عدة قضايا مثيرة للجدل، ووجدوا أنّهم لا يمكنهم الإيمان بالثالوث أو ألوهية السيّد المسيح أو المعجزات ثم انتشروا في العالم. والربوبية لم تشكل أي تجمعات في البداية ولكن مع الوقت أثرت على الجماعات الدينية الأخرى بشكل قوي كالمجموعة التوحيدية والمجموعة
الكونية اللتين تطورتا من الربوبية. لا تزال الربوبية حتى يومنا موجودة في أشكال الربوبية الكلاسيكية والربوبية الحديثة".
وتعقيباً على هذه الكلمات أسجّل بعض النقاط التوضيحية:
النقطة الأولى : الظاهر أنّ مصطلح «الربوبية» الذي اختاره أتباع هذا المذهب اسماً وعلماً لخطّهم الفكري انطلق من اقتصارهم في الإيمان على الاعتقاد بالربّ فقط، ورفض مبدأ النبوّة. بيد أنّ لنا ملاحظتين نسجلها في المقام:
أ -إنّ هذه التسميّة بما تعنيه من الانتساب إلى الرب لا تميّزهم عن سواهم، لأنّ الاعتقاد بالرب هو مما يشتركون فيه مع أتباع الديانات السماوية وغيرها.
ب -إنّ التسمية المذكورة لا تنسجم مع حقيقة معتقد الربوبيين في شأن الله تعالى، فقد مرّت الإشارة إلى أنّ الربوبية ترفض فكرة التدخل الإلهي في الشؤون الإنسانية بل وفي الكون برمته. وعليه، فإنّ إلهاً لا دور له أبداً - بعد الخلق والإيجاد - في إدارة شؤون خلقه وتدبير
أمورهم، لا يصلح لأن يسمى ربّاً، لأنّ الرب ليس هو الصانع الذي يوجد ثمّ ينقطع عن إدارة المصنوع، وإنّما هو المدبر والقيّم والمدير الدائم التدبير ولذا فالأحرى بهم أن يختاروا اسماً آخر يميّزهم عما سواهم ويكون منسجماً مع حقيقة معتقدهم.
ولكننا لا نريد الوقوف كثيراً عند هاتين الملاحظتين، إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم.
النقطة الثانية : إن مصطلح الربوبي بما يختزنه من اعتقاد يختلف عن الرباني أو الربّي الوارد ذكرها في القرآن الكريم، قال تعالى: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَدْرُسُونَ (سورة آل عمران-79)، ونحوه آيات أخرى وقال تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (سورة آل عمران-146). فالرباني والرِّبي هو المنسوب إلى الرب، وهذا التشابه اللفظي هو
نقطة الالتقاء بينهما وبين الربوبي، لكنهما يختلفان في مضمون الاعتقاد، ففي حين ينكر الربوبي مبدأ النبوة، فإنّ الرباني - وكذا الربي - هو من يطيع الرب عزّ وجل في قوله وفعله مع كونه سائراً على هدي الأنبياء (ع) كما لا يخفى على المتأمل في الآيتين الآنفتين.
النقطة الثالثة : للربوبية قاموس مصطلحات خاص بهم، ويتحاشون استخدام المصطلحات الدينية الشائعة بين أتباع الديانات السماويّة.
فهم يسمّون دينهم بــــ «الدين الطبيعي»، في إشارة إلى أنهم لا يؤمنون بدين يستند إلى الوحي، والله تعالى عندهم هو «المصمم الأعظم» أو «قوّة كونية هي مصدر الخلق».
يتحاشون - طبقاً لبعض كلماتهم - استخدام كلمة إيمان، لأنّه قد «أسيء استخدام هذه الكلمة بشكل رهيب من قبل الديانات السماويّة»، ويستبدلونها بكلمة ثقة . غير ذلك من المصطلحات التي سنلاحظها في دراستنا هذه.
وفي دراستنا النقديّة هذه للربوبية وأفكارها سوف نكتشف الكثير من التخبط والضعف الذي ينتاب هذا الفكر، وسنلاحظ أيضاً وجود غموض كبير يلفّ هذه الفكرة في العديد من جوانبها، ما يجعلها غير متماسكة وعاجزة عن الصمود في معترك البحث العلمي.
وفي الحديث عن المصطلحات لا بأس بالإشارة إلى أننا قد نجاري الربوبي أحياناً في استخدام مصطلح «الأديان» الذي يكثر ترداده على لسانه، وهو مصطلح شائع ويستخدمه الكثيرون بمن فيهم المتدينون، مع أننا لا نحبذ استخدامه من حيث المبدأ، لأنّ القرآن الكريم قد تحاشى
استخدام هذا اللفظ، وإّنما ورد فيه لفظ الدين مفرداً، وفي سياق يؤكد على وحدة الدين عند الله، وإن تعددت الرسالات والشرائع، قال تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (سورة الشورى-13)، فروح الرسالات السماوية وجوهرها واحد، وأهدافها واحدة، وهي تلتقي في المبدأ والمنتهى، وإنّما الذي يقع فيه الاختلاف أو التطوّر من نبوّة إلى أخرى، هو الشرائع الناظمة لحياة
الإنسان، قال تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (سورة المائدة-48)، ولنا عودة إلى نقاط الاشتراك بين الرسالات، وهي نقاط تبرر القول: إنّ الدين في مبادئه وجوهره واحد.
ثانياً: الربوبيون بين الماضي والحاضر
لا يخفى أنّ الفكرة الأساسيّة التي يقوم عليه الفكر الربوبي وهي إنكار مبدأ النبوّة ليست جديدة في مضمونها، بل هي فكرة معروفة منذ زمن قديم، فقد نسب علماء الكلام المسلمون إلى البراهمة الهنود أنّهم أنكروا النبوات . الشهرستاني: «البراهمة: من الناس من يظن أنّهم سُمّوا
براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم (ع) وذلك خطأ، فإنّ هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلاً ورأساً، فكيف يقولون بإبراهيم (ع) والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم(ع) من أهل الهند فهم الثنوية منهم القائلون بالنور والظلمة على رأس أصحاب الاثنين، وقد ذكرنا مذاهبهم.
وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهم، وقد مهد لهم نفى النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول» . واحتجوا على ذلك بأنّ الرسول إمّا أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإنْ جاء بما يوافق العقول لم تكن إليه حاجة ولا فائدة، وإنْ جاء بما يخالف
العقول وجب ردّ قوله، وسيأتي تفنيد هذه الحجة لاحقاً.
ويُنقل عن البراهمة آراء أخرى، ومنها أنّهم قوم نباتيون لا يأكلون من لحوم الحيوانات شيئاً .
هذا ولكن نسبة إنكار النبوات إلى البراهمة لا تخلو من تأمل وإشكال، بلحاظ ما نُقل عن النوبختي في كتابه «الآراء والديانات» من أنّ البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار، وزعموا أنّ رسولهم ملك أتاهم في صورة البشر . وقد رفع عبد الرحمان بدوي من وتيرة
التشكيك هذه حيث إنه وبعد بحثٍ وتقصٍ ومتابعة لكلمات وأقوال العلماء المسلمين حول معتقدات البراهمة رأى «أنّ الروايات التي نجدها لدى المؤلفين الإسلاميين عن البراهمة بحسبانهم منكري النبوّة إنما ترجع إلى كتاب «الزمرد» لابن الراوندي» جازماً بأنّ «ابن الراوندي
حينما يَدَعُ البراهمة يطعنون في الأديان المنزلة إنما يخفي تحت هذا القناع عقيدته الخاصة». ومحتملاً أن سرّ اختياره لمدرسة هندية وهي مدرسة البراهمة لينسب إليها تلك الأقوال، هو أنّه «تَبِعَ سنّة قديمة تضع على لسان حكماء الهند أقوالاً مثل هاتيك".
والراوندي المذكور هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي (205هــــ 245هــــ) وقد اتهم بالإلحاد والزندقة، وعدّه بعض الباحثين الغربيين من «أشهر ملاحدة القرن الثالث الهجري» وقد ألّف كتباً كثيرة في الإلحاد وذكروا أنّه نقضها بكتب أخرى وشكك البعض في
إلحاده، واعتذر له السيد المرتضى في تأليف هذه الكتب بأنه إنما ألّفها معارضة للمعتزلة وتحدياً لهم، فقد كان في بادئ الأمر منهم، فأساؤوا عشرته وأهانوه فتركهم ونقض عقائدهم. على أنّ كل الكتب التي ألّفها في الإلحاد قد نقضها بنفسه، وكان يتبرأ منها تبرأً ظاهراً، وقد خطّأه
السيد المرتضى «بتأليفها، سواء اعتقدها أو لم يعتقدها» .
وقد نُسِب إلى أبي العلاء المعري تبني مذهب البراهمة ولذا عدّه بعض الربوبيين من أنصار فكرتهم، بالنظر إلى ما ورد في بعض الأشعار المنسوبة إليه . ويرى البعض أنّ الأقوال المنقولة عنه متهافتة وشعره يصلح لإثبات كل مذهب . والاقناع عن أكل لحوم الحيوانات هو
رأي جرى المعري على العمل به، وأخذ به جمع من الناس ممن يسمون أنفسهم بالنباتيين في زماننا.
وكيف كان وبغض النظر عن صحة النسبة المذكورة إلى البراهمة أو عدمها، فقد أورد علماء الكلام بعض الحجج المنسوبة إليهم وناقشوها، وأُلِّفت بعض الرسائل والكتب الخاصة في تفنيد مذهبهم ونقد آرائهم وأفكارهم .
هذا فيما يتصل بالبلدان الشرقية، وأمّا بلاد الغرب فيبدو أنّها المنبت الأساس للفكر الربوبي المعروف في العصور المتأخرة، وثمة أسماء عديدة من فلاسفة عصر التنوير تبنت الاعتقاد بالربوبية، منهم الشاعر والفيلسوف الفرنسي فولتير توفي (1778م)، ومن العلماء المعاصرين
يبرز أمامنا اسم أنطوني جيرارد نيوتن فلو (1923م - 2010م) وهو الشخص الذي كان من المنظرين ولعقود طويلة للإلحاد، ثم في أخريات حياته تحوّل إلى الاعتقاد بالربوبية، ونُسب هذا الاعتقاد أيضاً إلى بعض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا عن ماضي الربوبيين، أما اليوم فإنّ الجماعة آخذون بالانتشار، مستعينين بما يروجونه من سهولة فكرتهم وبساطتها واعتضادها بالعقل وتقديرها للعلم، ومستغلّين الضعف الذي ينتاب الفكر الديني على أكثر من صعيد، حيث يسود التشدد والتعصب الدينيين وتنتشر الخرافة
والاعتقادات البالية، ناهيك عن احتراب الجماعات الدينية وتقاتلها، وشهرها للسيف في وجه كل من لا يتفق معها في الرأي وارتكابها الجرائم باسم الدين. ويبدو من بعض المؤشرات والدلائل أنّ الفكر الربوبي آخذ بالتبلور كمذهب له تشكيلاته وأطره التنظيمية، فثمّة اتحادٌ عالمي
للربوبيين، ولديهم مركز في العاصمة الأمريكيّة واشنطن . وثمة من يقول ويروّج بأن الربوبية هي من أكثر المذاهب انتشاراً في أوروبا.
ثالثاً: الدوافع نحو الربوبية
إنّ اعتناق الإنسان لفكرة معينة لا يأتي اعتباطاً ودون سبب، بل يكون لذلك دوافع ومنطلقات معينة إمّا فطرية وجدانية، أو نفسية، أو عقلية، أو اجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب والدوافع، وعليه فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي يدفع الإنسان نحو تبني المذهب الربوبي؟
من الطبيعي أنّ تبنّي الربوبيين لفكرة الإيمان بالله تعالى لا ينفكُّ عن المنطلقات العامة التي تدفع الإنسان إلى الاعتقاد بالخالق والإيمان به، وهي منطلقات تمليها الفطرة البشريّة، ويقود إليها البرهان العقلي، ويقود إليها التأمل في هذا الكون العظيم في صنعه ونظامه والمبدع في
آيات جماله وجلاله، وقد يكون هناك دوافع أخرى لدى بعض الناس.
وأمّا إنكارهم لوجود رسلٍ بين الله تعالى وبين خلقه، فهو أمر يصعب جداً ادعاء كونه مما تمليه الفطرة والوجدان أو يقود إليه العقل والبرهان، ولذا فهو يحتاج إلى سؤال المنطلقات، فهل هي منطلقات فكريّة بحتة أم أنّ ثمة دواعٍ ودوافع أخرى؟
ربما يسهل على الربوبيين ادعاء أنّ دافعهم ومنطلقهم في تبني الفكر الربوبي مردّه - في الحد الأدنى - إلى عدم نهوض دليل مقنع على صحة ما يزعمه المتدينون حول أنّ الأنبياء (ع) هم رسل الله إلى الخلق. ولكنّ هذا الادعاء لا يمكننا الموافقة عليه، لأنه لا يمتلك رصيداً مقنعاً،
كما سيتبدى في ثنايا هذا البحث.
والذي يمكننا ترجيحه بعد التأمل، أنّ ثمّة دوافع أخرى عديدة ساعدت وتساعد على تبني هذا الفكر الرافض للرسالات والشرائع السماوية، ويمكن إرجاع هذه الدوافع إلى ما يلي:
أولاً : عجز أتباع الأديان والشرائع عن تقديم تصوّر موحد ومتماسك إزاء بعض القضايا المحورية والجوهريّة التي تواجه الإنسان، سواءً ما يتصل منها بقضايا المبدأ والمعاد أو ما يتصل بشؤون المعاش والحياة. وقد يتراءى للكثيرين وجود تخبط داخل الفكر الديني واختلاف
كبير في الأساسيات، ربما وصل إلى حدِّ التناقض. ومن الطبيعي أن يشكّل ذلك سبباً أو دافعاً نحو الهروب والتسرب من الدين وتبني الفكرة الربوبية، أو غيرها من الأفكار اللادينية، والحال أنّ ثمّة تعامياً أو غفلة عن أنّ هذا الاختلاف بين الأديان مرده إلى أحد عاملين:
أ -إمّا إلى تطور في الشرائع نفسها والذي فرضه تغيّر حاجيات الإنسان، وهو الأمر الذي استدعى بروز ظاهرة النسخ بين الشرائع السماوية بل وحتى داخل الشريعة الواحدة.
ب -وإمّا إلى التحريف الذي تعرّضت له تلك الشرائع ورسالاتها السماويّة بفعل عبث العابثين وذوي الأغراض والمصالح الخاصة.
ومن الواضح أنّ هذين العاملين لا يشكلان ثغرة قوية في الفكر الديني ذاته، أمّا العامل الأول فهو يعد نقطة قوّة في هذا الفكر ومؤشراً على مراعاته لاختلاف الزمان والمكان. وأمّا العامل الثاني فلا يلام عليه الدين نفسه بل الملامة تتوجه إلى الإنسان ولا سيما المتدين الذي لم
يبذل الجهد بما فيه الكفاية لمواجهة التحريف ووضع حدٍ للمتلاعبين بالدين والمتاجرين به.
ثانياً : ظاهرة التشدد الديني العابرة للأديان والمذاهب، والتي أفرزت جماعات متطرفة تمارس العنف والقتل والإجرام باسم الأديان، فهذه الظاهرة عكست صورة بشعة عن الدين وشوّهت رسالته، ودفعت الكثيرين - بالأخص ممن لا يسعهم التفكيك والتمييز بين نصوص الدين
وممارسات المتدينين - إلى أحضان الإلحاد أو إلى اعتناق المذهب الربوبي والذي يُصوّره أتباعه باعتباره خشبة الخلاص للإنسانية، وأنّه المنجي من تبعات الأديان وأعبائها.
إنّنا وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى ضرورة الفصل بين نصوص الدين وبين ممارسات أتباعه، إلّا أنّنا ندرك صعوبة هذا الفصل، إذ سوف يقال لنا: لو كان في هذا الدين خيرٌ لانعكس على حياة أتباعه وعلى سلوكهم وأخلاقهم. ومن هنا سيكون لزاماً على أهل الوعي والبصيرة
من المسلمين، في سبيل انتشال دينهم من كل هذا الوحل الذي لطّخه البعض به، أن يسعوا جاهدين إلى تقديم تجربة حضارية حيّة تستقي من هذا الدين وتستلهم من روحيّة نصوصه ما فيه الخير للإنسانية جمعاء.
إنّني وانطلاقاً من قناعاتي الدينية المعتمدة على الحجة والمنطق، لا ألوم الربوبي على رفضه «لأنبياء القتل» ونفوره من «رسل الذبح». فأنا شخصياً لا أؤمن بأنبياء أو رسل كهؤلاء، ولا أعتقد أساساً أنّه يوجد رسلٌ مبعوثون من الله يحملون هذه الدعوة، وكل ما ينسب إلى
الأنبياء (ع) على هذا الصعيد هو كذب وتزوير وتشويه لحقيقة دعوة الأنبياء وتحريف لرسالتهم.
ثالثاً: إنّ ولادة الفكر الربوبي في الغرب، يدفع على الاعتقاد أنّه كان ردّة فعل على بعض ممارسات الكنيسة التي اتسمت بالشدة ليس اتجاه معارضيها فحسب، بل واتجاه سائر العلماء الطبيعيين، وهكذا هو ردة فعل على بعض طروحات اللاهوتية غير المقنعة، وقد عرف عن
الربوبيين إنكارهم لعقيدة الثالوث المسيحية، ونظرهم إلى المسيح على أنه فيلسوف وعالم.
رابعاً: إنّ الجمود الكلامي الذي أظهر عجز الفكر الديني عن الإجابة على بعض الأسئلة المصيرية المقلقة، أو تقديم الحلول الناجعة للكثير من المشكلات على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية، إنّ ذلك قد شكّل دافعاً لدى البعض للشك في صدقيّة الأديان
وصحّة انتسابها إلى الله تعالى، كما أنّ الانكماش والتحجر الفقهي ولّدا شعوراً لدى بعض الناس بعدم قدرة التشريع الإسلامي على مواكبة الحياة، وأوحى بعجزه عن تقديم حلولٍ لمشكلات العصر. وهذا كله (أعني الجمود الكلامي والتحجر الفقهي) قد ساهم في فتح الباب أمام
تسرّب الفكر الربوبي إلى الفضاء الإسلامي. وقد أشرنا إلى أنّ الأفكار أو التصورات غير المقنعة التي قدّمتها المسيحيّة فيما يتصل بالثالوث، والقوانين والتشريعات الصارمة التي اعتمدتها مع معارضيها شكّلت دوافع لتبني الفكرة الربوبية في الغرب.
ولذا لا نبالغ في القول: إنّ من أولى أولويات العقل الإسلامي في هذه المرحلة:
أ -بذل الجهد الفكري في سبيل تقديم رؤية دينيّة عقائدية متماسكة فيما يتصل بالله وصفاته وهدفه من خلق الإنسان وخلق النار والجنة، وكذلك فيما يتصل بالنبوات ودورها في الحياة، ما يجعل الإيمان بالله وبرسله حاجة ملحة للإنسان ومصدر أمن واطمئنان له، وليس مصدر
خوف وقلق ورعب.
ب - بذل الجهد الفقهي في سبيل التحرر من جملة من المقولات الفقهية البعيدة عن سماحة الإسلام في تشددها والمعيقة لحركة الإنسان في تحجرها وتزمتها.
ج -إعادة قراءة الموروث التاريخي والحديثي قراءة نقدية، بغية تمييز سقيمه من صحيحه وغثه من سمينه ومتحركه من ثابته، وهذه مهمة جليلة وعظيمة.
إنّ الأجدى وبدل أن ينكبَّ البعض على تخوين الربوبيين وتكفيرهم، أن يسعى ويعمل للإجابة على أسئلتهم وهواجسهم، وهي هواجس تنتاب حتى بعض المتدينين الذين قد لا يفصحون عنها لسبب أو لآخر.
خامساً: وربما كان ميل الإنسان إلى الراحة والدعة هو من جملة الدوافع نحو تبني هذا المذهب؛ لأنّ الشخص بتبنيه للمذهب الربوبي يريح نفسه من تبعات دراسة العقائد المختلفة والرسالات المتعددة بغية الوصول إلى الحقيقة، كما أنّه يخفف بذلك على نفسه من مصاعب الالتزام
بمقتضيات الشرائع السماوية في منظومتها الشعائرية والطقوسيّة وغيرها من القيود التي يفرضها التشريع عليه. أمّا الإيمان بالله تعالى دون الإيمان بالرسل فهو أمر سهل المؤنة ولا يكلّف صاحبه كثيراً، ولذا يجد الربوبي لنفسه متسعاً من التحرر وربما التفلت، فهو ليس محكوماً
لشريعة ذات تعاليم صارمة من وجهة نظره، وربما يحاول بذلك أن لا يعيش قلق الحساب الأخروي وما يفرضه من التزامات دنيوية، كما يرى المتدينون انطلاقاً من أنّ الدنيا مزرعة الآخرة، وأنّ مصير الإنسان الأخروي مرهون باستقامته في الدنيا.
لكنّ الحقيقة أنّه لا يمكن للإنسان العاقل أن يخلد إلى الراحة بهذه البساطة وربّما السذاجة، ويغضّ الطرف عن أسئلة المصير التي تفرض نفسها عليه وتقتحم عليه خلواته، ومن أهمّها سؤال من أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟ وهل يمكن للعاقل أن يرتاح وهو يسدُّ أذنيه عن نداء آلاف
الأنبياء (ع) الذين خرجوا على الناس عبر هذا التاريخ الطويل معلنين: أنّهم رسل الله إلى البشريّة، وأن لا خلاص لأحدٍ من الناس إلا باتباعهم والسير على نهجهم؟!
من كتاب "عالم دون أنبياء! دراسة نقدية في الفكر الربوبي"
نُشر المقال على الموقع في 13-5-2018