المراهقة: مفهومها، خصائصها، متطلباتها
الشيخ حسين الخشن
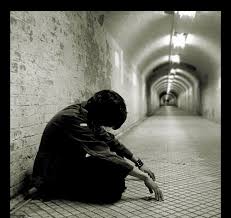
كيف نتعامل مع أبنائنا وبناتنا في مرحلة المراهقة؟ سؤال يقلق الآباء والأمهات الذين بلغ أحد أبنائهم هذه المرحلة وأخذ يفاجئهم بتصرفاته غير المعهودة، وقد لا يحسن الكثيرون منهم التعامل معه أو تفهّم تصرفاته، فيصطدمون به ويرتكبون الأخطاء التربوية، وإذا كان لعلماء النفس والتربية تفسيرهم ورؤيتهم لكيفية التعامل مع المراهق، فإن للدين أيضاً رؤيته ووصاياه وإرشاداته في هذا الصدد، وهذا ما نحاول تسليط الضوء عليه فيما يأتي.
المفهوم والمميزات:
يرى علماء النفس أنه بعد مرور الطفل بمرحلة الكمون(من السادسة إلى الحادية عشرة) التي تتسم بالاتزان الانفعالي، تبدأ مرحلة جديدة اصطلح على تسميتها بالمراهقة، والمعنى اللغوي للكلمة مأخوذ من فِعْل راهق بمعنى قارب، يقال راهق الغلام إذا شارف على الاحتلام، ومفهوم المراهقة مختلف عن مفهوم البلوغ، فالبلوغ عبارة عن نضوج الغدد التناسلية، بينما المرهقة هي عبارة عن مجمل التغيرات الجسدية والانفعالية والعقلية التي تطرأ على الشخصية الإنسانية (راجع بهذا الصدد: المعلم والتربية للدكتور محمد رضا فضل الله، ص:478).
وقد ورد هذا المصطلح في النصوص الدينية بمعناه اللغوي المشار إليه، ففي الحديث عن علي بن الحسين(ع):".. وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي ـ إذا راهق ـ بالصوم تأديباً وليس بفرض"(تهذيب الأحكام:4/296).
وتمتاز المراهقة بأنها مرحلة حساسة ينتقل معها الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة والخصوبة أو النضج الجنسي، وهي تترافق عادة مع شعور بالحاجة إلى الاستقلال وإثبات الذات، ويحاول المراهق أن يكون حراً، مسؤولاً ومنفصلاً عن الصغار، كما ويشعر بالحاجة إلى العقيدة الفكرية فيأخذ بالنقاش والاعتراض، فتراه ناقداً معترضاً.
التعرف على المراهقة ومتطلباتها:
وفي الإجابة على سؤال: كيف نتعامل مع المراهق؟ لا بدّ لنا أولاً أن نفهم هذه المرحلة وخصائصها وما يرافقها من تغيرات جسدية ونفسية وعقلية لدى المراهق، وما تفرضه من متطلبات تربوية تتناسب معها، ولعل المشكلة الأساس في التعامل مع المراهق تكمن في جهل الآباء والأمهات لحساسية المراهقة وأهميتها، وكذلك عدم تفهمهم لمقتضياتها التربوية وغير التربوية، ومن هنا فإننا ندعو إلى ضرورة امتلاكهم ـ أعني الآبـاء والأمهـات ـ ثقافة التعامل مع المراهق، اعتماداً على ذوي الخبرة والاختصاص.
التوجيه، الصداقة، المواكبة:
وعلى العموم يمكننا القول: أنه وإزاء النمو العقلي والجسدي للمراهق وبداية تفتح غرائزه، وما يرافق ذلك من صراع بين الغريزة والعقل، وإزاء الخشية الكبيرة من انسياقه مع غرائزه بحسب حالته الانفعالية وضعف تجربته ورشده، وأمام شعوره بالاستقلال وميله إلى التمرد، أمام ذلك كله يكون الدور الأساس للتربية التي تعمل على تنمية الإحساس بالمسؤولية لديه وتوجيهه وترشيده وتبصيره بعواقب الأعمال المتسرعة أو الخطوات الارتجالية غير المدروسة، وربما كان الأسلوب التربوي الأنجع في هذا المجال هو التعامل معه ـ من قبل الأهل والمربين ـ على أساس الصداقة والابتعاد عن منطق الآمر والمأمور والسيّد والعبد، فالمراهق ـ على الأقل من وجهة نظره ـ لم يعد طفلاً صغيراً يتلقى الأوامر، ولذا فإن علينا تقديره واحترام شخصيته والإصغاء إليه والاستماع إلى وجهة نظره ولو لم نوافقه عليها، وعلينا أيضاً التعرف على همومه ومشاركته في إيجاد الحلول لها بإبداء النصيحة والمشورة، وقد أرشد الحديث النبوي الشريف إلى ضرورة التعامل مع الأبناء بعد سن الرابعة عشرة على أساس المصادقة والمصاحبة قال (ص) فيما روي عنه:" الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين"، وفي رواية أخرى تلتقي مع الرواية السابقة في المضمون: "دع ابنك يلعب سبع سنين، ويُؤدَّب سبع سنين، وألزمْه نفسك سبع سنين"(وسائل الشيعة:21/475).
مضافاً إلى مهمة الإرشاد وأسلوب المصادقة فإنّ المطلوب أيضاً مواكبة المراهق مواكبةٍ تامة في أفكاره وعلاقاته وصدقاته سواءً في المدرسة أو في الشارع، فإن للأصدقاء والأصحاب دوراً كبيراً في تكوّن قناعات المراهق ونزعاته وميوله وما يكتسبه من عادات سيئة أو حسنة، وإنّ الغفلة عن مواكبته ومتابعته قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى السلوكي أو الفكري، وقد كان الأئمة من أهل البيت(ع) يحذّرون أصحابهم من خطورة فرقة المرجئة وأفكارها على أبنائهم، لأن من رأي المرجئة أن مركز الإيمان هو القلب ولا قيمة للعمل، وهذا المفهوم يجد له صدى كبيراً عند عنصر الشباب والمراهقين، لأنه ينسجم مع رغباتهم وشهواتهم، ويقدّم لهم تبريراً شرعياً لكل انحرافاتهم، ففي الحديث عن الإمام الصادق(ع): "علّموا صبيانكم ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها"(الخصال:614). وأعتقد أن في عصرنا من الأفكار الهدامة ما يفوق بكثير خطر المرجئة وأفكارها.
التربية الجنسية:
بالانتقال من الخطوط العريضة إلى التفاصيل، فلربما كان أخطر ما يواجهنا ويواجه المراهق هو مسألة تفتح الغرائز عنده قبل بلوغه مرحلة الرشد الكامل، وإنّما كان ذلك أمراً خطيراً مع أنه علامة صحية ومرحلة طبيعية يمر بها كل إنسان، باعتبار نتائج ذلك السلبية على مستقبل المراهق إذا لم يتم توجيهه وإرشاده واحتضانه وتحذيره من الانزلاق والتمادي مع فوران الغريزة وما ينجم عنها ـ في ظل انعدام الضوابط الأخلاقية والشرعية ـ من انحراف سلوكي أو وقوع في فخ الاستغلال أو الشذوذ الجنسي، إن الموضوع الجنسي لدى المراهق لا يواجه باللامبالاة أو وفق منطق العيب والعار وما يفرضه ذلك من سكوت أو تكتم إزاء القضايا الجنسية، بل لا بدّ من مصارحة المراهق بهذه الأمور وإرشاده إلى وظائف الأعضاء الجنسية، وتحصينه بالضوابط الأخلاقية والحدود الشرعية التي تحكم العملية الجنسية، ولا بدّ أن يترافق الإرشاد والتوجيه مع اتخاذ كافة الإجراءات العملية الكفيلة بتحصين الأسرة برمتها من مخاطر الانحراف، ولعل واحدة من هذه الإجراءات مسألة الفصل بين الجنسين في المنام ابتداءً من سن العاشرة كما جاء في الوصايا الإسلامية.
مداراته لا مجاراته:
المشكلة الأخرى التي تواجهنا في التعامل مع المراهق هي ميله إلى التمرد على والديه، ومعارضتهما في الرأي، ويتساءل الكثيرون: ماذا علينا أن نفعل إزاء ذلك؟ هل علينا مجاراته في ميوله ومتطلباته؟
والجواب: ليس المفروض بنا مجاراته ولكن علينا مداراته، واعتماد أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، وليس أسلوب الفرض والقمع كما يفعل الكثير من الآباء والأمهات، وقد انعكس هذا المعنى في أدبياتنا الشعبية حيث يقال للولد ذكراً أو أنثى حتى لو كان مراهقاً أو شاباً: "ليس لك كلمة مع كلمة أبيك" وكذلك يقال للفتاة. وهذا مفهوم خاطئ تربوياً ومرفوض شرعاً أيضاً، فالإسلام يرفض سحق شخصية الطفل وقمعه ولو تحت لافتة إطاعة الوالدين، وبالمناسبة فإن إطاعة الوالدين ليست ثابتة شرعاً، وغاية ما تدل عليه النصوص هو ضرورة الإحسان إليهما واحترامهما {وبالوالدين إحساناً}.
المراهق والتقليد:
وثمة مشكلة أخرى نلحظها في شخصية المراهق في زماننا، وهي نزوعه إلى تقليد ومحاكاة بعض الرموز أو الشخصيات الرياضية أو "الفنية " أو غيرها، ويتمظهر ذلك في أخذه بآخر صيحات الموضة في اللباس وتسريحات الشعر وما إلى ذلك، ويجدر بنا التعامل مع هذه النزعة بحكمة ورويّة ووفق منطق الإرشاد والنصيحة، بعيداً عن المبالغة في تصويرها وكأنها تشكل انحرافاً خطيراً لا بدّ من التصدي له واستئصاله كما قد يُخيَّل للبعض، فإن هذه المظاهر تدخل في الغالب في نطاق الوسائل المتحركة ولا تمس الجوهر والمبادئ الثابتة، نعم إن السلبية الكبيرة في هذه النزعة تكمن في أنها قد تعبر عن انهزام نفسي وانسحاق داخلي أمام الآخر، وهذا ما علينا مواجهته بالتربية المتواصلة والعمل على تأصيل مفهوم الذات وتأكيد الثقة بالنفس، وتعزيز فكرة الهوية والانتماء لدى المراهقين وكل أبناء أمتنا صغاراً وكباراً، شيباً وشباباً.