الموقف العام من زوجات الأنبياء (ع)
الشيخ حسين الخشن
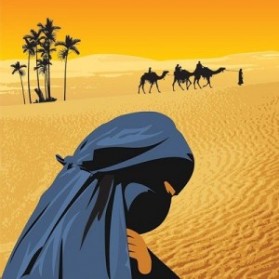
المحور الأول: الموقف العام من زوجات الأنبياء(ع)
ما هو الموقف من زوجات الأنبياء (ع) بشكلٍ عام، وزوجات نبيّنا محمد (ص) بشكل خاص؟ وهذا الموقف سوف نوضحه من خلال النقاط التالية:
-
الاحترام لا العصمة.
-
الاحترام لا يمنع من النقد الموضوعي.
-
النقد لا يعني التجريح والشتم.
-
عصمة النبي(ص) لا تسري إلى زوجاته
إنّ عصمة الأنبياء(ع) بشكل عام ونبينا محمد(ص) بشكل خاص ونزاهتهم عن الذنوب والمعاصي وعن كلّ ما يشين هي من القضايا العقدية المتفق عليها بين علماء المسلمين قاطبة، فالنبي(ع) منزّه عن كلّ عيب، ومبرّأٌ من كلّ دنس، فهو الطهر كلُّه في عقله وقلبه وسلوكه وخُلقه، فعقله لا ينبض إلاّ بالحق، وقلبه لا يخفق إلاّ بالطهر، وسلوكه لا يتحرك إلاّ بما تقتضيه مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، أجل قد تختلف الآراء في بعض تفاصيل العصمة، من قبيل قضية العصمة عن الذنوب قبل البعثة، حيث تذهب بعض الفرق الإسلامية إلى أنّ الأنبياء(ع) يجوز عليهم ارتكاب الذنوب الصغيرة قبل البعثة وبعدها، وتذهب فرق أخرى )ومنهم الشيعة الإمامية( إلى أنّ العصمة لا تتجزأ، فلا يجوز
على الأنبياء(ع) فعل قبيح وارتكاب ذنب صغير أو كبير، قبل النبوّة وبعدها. ومن موارد الخلاف في موضوع العصمة ما يتصل بنسب النبي(ع)، حيث وقع الكلام بينهم أنّه هل يلزم أن يكون آباء النبي(ع) وأجداده وصولاً إلى آدم(ع) موحِّدين أم لا؟ فبينما ذهب الكثيرون إلى ضرورة طهارتهم(ع) من الشرك، فإنّ بعض الأعلام قد شكّك في ضرورة ذلك لعدم الدليل بنظره على ذلك، بيد أنّ ثمة نقطة إجماعية في هذا المقام، أو قدراً متيقناً وموضع إجماع لدى كافة العلماء، وهي ضرورة طهارة آباء النبي(ع) من الزنا، كما سيأتي توضيحه في المحور الثامن.
هذا ما يتصل بشخصيّة النبي(ص) ونسبه، وأمّا زوجات الأنبياء(ع)، فهل يمكن أن يرتكبن الفاحشة سواءً كُنّ في حبال النبي(ص) وعصمته الزوجية أم لم يكنّ كذلك، كما لو توفي عنهنّ النبي(ص) وهن باقيات على عصمة الزوجية إلى حين وفاته؟ وهذا ما نخصص له هذه الدراسة.
أجل فيما عدا مسألة نزاهتهن عن الزنا فإنّ ثمة إجماعاً إسلامياً على أنّ نساء النبي(ص) لسنا معصومات عن الذنب، فمن الممكن أن يصدر عنهن ما يصدر عن غيرهن من النساء أو الرجال من تجاوزات شرعية، فقد يعصين الله ورسوله ويتجاوزن التعاليم الشرعية، وهذا الرأي لا ينطلق من أنّه لا دليل على عصمتهن فحسب، بل لأنّ الدليل القاطع على عدم عصمتهن موجود، والدليل هو الآيات
القرآنية التالية الواردة في شأن زوجَتَي نوح ولوط، قال تعالى: {رَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}[التحريم: 10]، على أنّ الواقع التاريخي هو خير دليل على ذلك.
ويبقى في المقام سؤال وهو: ما السِّر في استثناء الزنا عن سائر المعاصي؟ فإذا كان بالإمكان لزوجة النبي(ع) أن ترتكب المعاصي الأخرى والتي قد تصل إلى حدّ التمرّد والعصيان وعداوة النبي(ع)، بل والكفر برسالته، كما هو الحال في زوجتي نوح ولوط(ع)، فما الذي يمنع من ارتكابهن لفاحشة الزنا،
وهي ليست أشدّ قبحاً من الكفر؟
والجواب: إنّ المفروض أو المدّعى أنّ ارتكاب زوجة النبي(ع) الفاحشة فيه مسّ كبير بزوجها وهو النبي(ص) وتأثير سلبي على دعوته، مما قد لا تستوجبه سائر الذنوب، الأمر الذي يفرض تحصين زوجته من هاتيك المعصية، تحصيناً للنبي(ع) نفسه، باعتبار أنّ ذلك مما تقتضيه عصمة النب(ص) التي لا تكتمل إلاّ بذلك، فامتناع الزنا عليهن مردّه إلى أنّ ذلك يؤدي إلى المسّ بالنبي(ع) نفسه، فهل يتم دليل ذلك؟ هذا ما يتكفل البحث الآتي ببيانه.
بين الإمكان والوقوع
وتجدر الإشارة إلى أنّ البحث في هذه المسألة يقع على صعيدين: وهما الإمكان والوقوع.
الأول: صعيد الإمكان، فهل يمكن صدور هذه المعصية من زوجة النبي(ع)، أو أنّ ذلك مستحيل، كاستحالة صدور المعصية من النبي(ع) نفسه؟ والاستحالة هنا تعني أنّ الله تعالى بلطفه وحكمته يتدخل لمنع وقوع زوجات الأنبياء(ع) في هذا الفعل الشنيع، تحصيناً لأنبيائه(ع) وحماية لدورهم الرسالي.
الثاني: صعيد الوقوع، فهل وقع ذلك من بعض زوجات الأنبياء(ع) أم لا؟ ومن الواضح أنّ البحث على الصعيد الثاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحث على الصعيد الأول، والنتيجة في أحدهما تؤثر على النتيجة في الآخر، فلو ثبت بالدليل القاطع وقوع إحدى زوجات الأنبياء(ع) لا سمح الله بهذا العمل القبيح فهو بنفسه سوف يشكّل دليلاً حاسماً على الإمكان وعدم الاستحالة، باعتبار أنّ خير دليل على الإمكان هو الوقوع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ البحث على المستوى الأول قد لا ينتهي
إلى الاستحالة استحالة صدور الزنا من زوجة النبي(ع) لكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال إقراراً بصدور ذلك من زوجة النبي(ع)، لأنّ الوقوع يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، كما سنلاحظ.
ولهذا فإننا حتى لو لم نجد دليلاً عقلياً على استحالة صدور الزنا من زوجة النبي(ع)، ولم نجد دليلاً نقلياً أو نحوه على نفي وقوع ذلك، فإنّه يكفينا عدم وجود دليل موثوق به على الوقوع، فعدم الدليل على الوقوع كاف لمنع اتهام أية امرأة ولا سيما زوجة النبي(ع) بذلك العمل القبيح، ويحتّم الكفّ عن الخوض فيه، فأعراض الناس جميعاً لها حرمتها، فكيف بعرض النبي(ع)!
خلاصة القول: إنّ دخول المرأة في علاقة زوجية مع النبي(ع) لا تمنح هذه المرأة عصمة ولا عدالة، ولا تحصّنها من المساءلة والمؤاخذة يوم القيامة، فهاتان زوجتان لنبيَّين من أنبياء الله(ع) يصرّح القرآن الكريم بانحرافهما عن خط ذينك النبيَّين(ع)، وبدخولهما النار مع الداخلين، ولكن ذلك أعني زوجيتها للنبي(ع) قد يكون كفيلاً في تحصينها من ارتكاب الفاحشة، لا لخصوصية في ذات المرأة، بل لخصوصية النبوة التي يربطها بها رباط الزوجية.
زوجات النبي(ص)
والأمر عينه ينطبق على زوجات رسول الله محمد(ص) فإنّه يجري عليهن ما جرى على سائر زوجات الأنبياء(ع)، ولا دليل في نظرنا على عصمتهن ولا على ضرورة عدالتهن، وهذا ما يؤكّده القرآن الكريم، ونصّت عليه كتب السيرة والأحاديث المختلفة، إن لجهة ما فعلنه مع رسول الله(ص) في حياته، من خلال ما صدر من بعضهن من تصرفات أدّت إلى إيذاء رسول الله(ص)، حتى
أنّه اعتزلهنّ وحرّم بعضهن عليه، وقد عكست لنا سورة التحريم فصلاً جلياً عما صدر من اثنتين منهن، مما أوجب توجيه تهديد إلهي لهنّ بأنهما إن لم يتوبا إلى الله تعالى فإنّ الله سيبدله(ص) خيراً منهن، قال تعالى:{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ * إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ * عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التحريم: 3-5] ، أو لجهة ما صدر من إحداهن وهي عائشة بعد وفاة النبي(ص) من قيادة الجيش في وجه الخليفة الشرعي الإمام علي(ع) في معركة طاحنة ذهب ضحيتها آلاف المسلمين، كما هو معروف ومشهور.
ومن هنا فإنّه حتى لو قيل بتوبتهن بعد ذلك فليس ثمة ما يمنع من قراءة هذه الأحداث وتوصيف ما جرى فيها وبيان الموقف منها، بل إنّ هذه القراءة قد تكون ضرورية ومهمة لاستخلاص الدروس والعبر منها، طبقاً للمنهج القرآني القائل:{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف: 111].
-
وجوب التعظيم والاحترام
إنّ ما قلناه من أنّ زواج امرأة من النبي(ع) لا يمنحها عصمة أو حصانة من ارتكاب الأخطاء أو المخالفات الشرعية، إنّ ذلك لا ينافي إطلاقاً لزوم التعامل مع نساء النبي(ص) بكل احترام وتقدير، وذلك احتراماً لصلتهن برسول الله(ص) وإكراماً لجنابه ورعاية لحقه وحفظاً لحرمته(ص)، وهذا أمر فضلاً عن كونه عقلائياً يدل عليه عدة وجوه أهمها:
أولاً: قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ..} [الأحزاب: 6].
يقول السيد المرتضى: "وفسّر ذلك بتفسيرين:
أحدهما: أنّه تعالى أراد أنّهن يَحْرُمن علينا كتحريم الأمهات.
والآخر: أنّه يجب علينا في تعظيمهن وتوقيرهن مثلما يجب علينا في أمهاتنا، ويجوز أن يراد الأمران عاً فلا تنافي بينهما." ويقول الشيخ الطوسي في تفسير قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}: "والمعنى
أنّهن كالأمهات في الحرمة وتحريم العقد عليهن." وقال العلامة الحلي ":وليست الأمومة هنا حقيقية، بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن، لا أنّه يحل النظر إليهن ولا الخلوة بهن.."
ولك أن تتساءل باستغراب: أين احترام الأم عندما يتهمها ابنها بارتكاب الفاحشة؟!
ثانياً: قال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53]
وإذا كان الحديث عن الزواج بنساء النبي(ص) بعد وفاته يؤذيه فما بالك بالحديث عن
ارتكابهن أو بعضهن للفاحشة !
سيرة الإمام علي(ع)
ولنا في سيرة أمير المؤمنين عليّ(ع) وتعامله مع زوجات رسول الله(ص) خير شاهد ودليل على ضرورة احترامهن ورعاية مكانتهن من رسول الله(ص)، وإنّ ما فعله أمير المؤمنين(ع) مع أم المؤمنين عائشة بالخصوص بعد انتهائه من معركة الجمل يكشف عن سلوك أخلاقي رفيع، فهو قد عضّ على الجراح، وتغاضى عن الآلام، وتعامل معها بغاية الاحترام والتقدير، رعاية منه لحق رسول الله(ص)، فبالرغم من فداحة الخطب وهول الكارثة وعظيم الجرأة في الخروج عليه وانتهاك
حرمته وهو الحاكم الشرعي العادل الذي بايعه عامة المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم قادة الحرب في الجمل، وبالرغم مما ترتّب على تلك الحرب الضروس من إرباك حركته(ع) ومشروعه الإسلامي، وما وقع من شرخ كبير في جسم الأمة، فإنّ أمير المؤمنين(ع) لم يفقد توازنه، ولم يدفعه كل ذلك ليتصرّف بطريقة انتقامية تعتمد أسلوب التشفي والانتقام أو الشماتة مع خصومه وأهل حربه، كلا وحاشا! فهذه ليست أخلاق علي(ع) ولا شيمه، ولهذا فقد تجاوز وصفح وتصرّف بنبل لا نظير له، مجسِّداً أخلاق الإسلام الحنيف، وسنّ في أهل الجمل سنةً غدت مصدراً للشرعية لدى فقهاء المسلمين قاطبة في حالة الاقتتال الداخلي بين فريقين مسلمين، هذا ما فعله مع عامة أهل الجمل.
وأمّا ما فعله(ع) مع السيدة عائشة بالخصوص، وهي التي أضفت بخروجها إلى تلك الحرب الضروس ووقوفها طرفاً فيها نوعاً من "المشروعية" عليها وساهمت في تعبئة النفوس بما أدمى قلب علي(ع) وقلب كل غيور على الأمة وحريص على عزتها وتماسكها، لأنّه لم يكن هناك مبرر لهذه الحرب التي حصدت أرواح آلاف المسلمين، إنّ ما فعله(ع) معها هو أنّه:
أولاً: أعادها إلى المدينة المنوّرة معززة محترمة، فقد "أنفذ معها أربعين امرأة ألبسهن العمائم والقلانس وقلّدهن السيوف وأمرهنّ أن يحفظنها ويكنّ عن يمينها وشمالها ومن ورائها، فجعلت عائشة تقول في الطريق: اللهم افعل بعلي بن أبي طالب ما فعل بي، بعث معي الرجال ولم يحفظ بي حرمة رسول الله(ص)! فلما قدمن المدينة معها ألقين العمائم والسيوف ودخلن معها، فلما رأتهن ندمت على ما فرّطت بذم أمير المؤمنين(ع) وسبّه! وقالت: جزى الله ابن أبي طالب خيراً فقد حفظ فيّ حرمة رسول الله(ص)".
فانظر إلى هذا السلوك الأخلاقي الرفيع والذي يكشف لك ويُنبئك عن غاية النبل والسمو والشهامة لدى صاحبه، فعلي(ع) وهو المنتصر في حرب الجمل لم تأخذه نشوة النصر، فيمارس الانتقام مع خصومه وأهل حربه، وقد أبت عليه غيرته أن يعيد زوجة النبي(ص) إلى بيتها مهانة ذليلة، وإنّما أمر بإعادتها على هذه الكيفية التي ملؤها الاحترام والتوقير، ولم يرض بأن يرسل معها أحداً من الرجال باستثناء أخيها محمد بن أبي بكر)))، غيرةً منه عليها، بل أرسل معها النسوة المقنعات وأمرهنّ بأن يحفظنها ويُحطن بها من كل الجوانب رعاية لسترها وحجابها!
ثانياً: رفض رفضاً قاطعاً أن تمسّ بسوء، ولمّا طلب بعض جنوده منه أن يقسّم عليهم غنائم معسكر أهل الجمل قال زاجراً لهم:"وأيكم يأخذ أمّكم عائشة في سهمه؟! قالوا: نستغفر الله، فقال: وأنا أستغفر الله".
وقال(ع) في حقها كلمة ذات دلالة: "وأمّا فلانة فأدركها رأي النساء وضغنٌ غلا في صدرها.. ولها بَعْدُ حرمتُها الأُولى والحساب على الله".
وقال مندداً بما فعله طلحة والزبير من إخراجها )عائشة( إلى الحرب:"..فاتخذاها)أي عائشة) دريئة يقاتلان بها، فأي خطيئة أعظم مما أتيا! أخرجا أمّهما زوجة رسول الله(ص) وكشفا عنها حجاباً ستره الله جلّ اسمه عليها وصانا حلائلهما، ما أنصفا الله ولا رسوله(ص).."،فلاحظ كيف يعتبر أمير المؤمنين(ع) إخراجهما لأم المؤمنين في هذه الحرب هتكاً لحجابها وخيانة لله ولرسوله(ص)، وهذا كلام لا يفوه به إلاّ الحريص على عرض رسول الله والغيور على كرامته، لأنّ عرض رسول الله(ص) هو عرض كل مسلم أبيّ، وكرامته هي عنوان كرامة الأمة بأجمعها.
ثالثاً: وتنقل بعض المصادر التاريخية أنّه(ع) أدّب بعض صحابته ممن تعرّضوا لها بالسوء وأغلظوا لها بالقول، وذلك عقيب الانتهاء من معركة البصرة، وكانت عقوبتهما هي أنّه(ع) أمر بجلدهم. يقول ابن كثير في"البداية والنهاية": "ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة، فاستأذن ودخل، فسلّم عليها ورحبت به، وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قتل منهم: عبد الله وعثمان ابنا خلف، فعبد الله قتل مع عائشة، وعثمان قتل مع عليٍّ، فلمّا دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله، أم
طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي!
فلم يرد عليها عليٌّ شيئاً، فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت!
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟!
فقال: ويحك! إنّا أُمرنا أن نكفّ عن النساء وهنّ مشركات، أفلا نكف عنهن
وهن مسلمات؟!
فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إنّ على الباب رجلين ينالان من عائشة، فأمر عليٌّ القعقاعَ "بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن يخرجهما من ثيابهما!".
وثمة رواية أخرى لهذه الحادثة تختلف عنها في بعض التفاصيل، ونحن نذكرها لأهميتها، ولاشتمالها على بعض المضامين العالية والجميلة في كيفية تعامل الإمام أمير المؤمنين(ع) مع السيدة عائشة وسائر النساء وهي ما رواه الطبري في تاريخه قال:
ثم دخل البصرة فأتاه الناس، ثم راح إلى عائشة على بغلته، فلما انتهى إلى دار عبد الله بن خلف، وهي أعظم دار بالبصرة وجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني خلف مع عائشة، وصفية ابنة الحارث مختمرة تبكي، فلما رأته قالت: يا علي يا قاتل الأحبة يا مفرّق الجمع أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه!
فلم يرد عليها شيئاً، ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة، فسلّم عليها وقعد عندها، وقال لها: جبهتنا صفية، أما إنّي لم أرها منذ كانت جارية حتى اليوم. فلما خرج عليٌّ أقبلت عليه، فأعادت عليه الكلام، فكفّ بغلته، وقال: أما لَهَمَمْتُ وأشار إلى الأبواب من الدار أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه، ثم هذا فأقتل من فيه، ثم هذا فأقتل من فيه، وكان أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة، فأُخبر عليٌّ بمكانهم عندها فتغافل عنهم، فسكتت، فخرج علي. فقال رجل من الأزد: والله لا تفلتنا هذه المرأة، فغضب عليٌ(ع)، وقال:
صه لا تهتكنّ ستراً، ولا تدخلنّ داراً، ولا تهيجنّ امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم وسفّهن أمراءكم وصلحاءكم، فإنّهنّ ضعاف، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنّهن لمشركات، وإنّ الرجل ليكافئ المرأة ويتناولها بالضرب فيعيّر بها عقبه من بعده، فلا يبلغني عن أحد عَرَضَ لامرأة، فأنكّل به شرار الناس.
ومضى علي، فلحق به رجل فقال: يا أمير المؤمنين قام رجلان ممن لقيت على الباب فتناولا من هو أمضّ لك شتيمة من صفيّة.
قال: ويحك لعلها عائشة، قال: نعم، قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما: جزيت عنا أمّنا عقوقاً، وقال الآخر: يا أمنا توبي فقد خطئت. فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب، فأقبل بمن كان عليه، فأحالوا على رجلين، فقال: أضرب أعناقهما، ثم قال: لأنهكنهما عقوبة، فضربهما مائة مائة وأخرجهما
من ثيابهما".
وينبغي أن يكون واضحاً أنّ موقف أمير المؤمنين(ع) المشار إليه وسلوكه الرفيع هذا ما كان ليتغير قيد أنملة لو كانت الخارجة عليه زوجة أخرى من زوجات رسول الله(ص)، فإنّ غيرته على رسول الله(ص) واحدة لا تتغير ولا تتجزأ.
ويستوقفنا في المقام أمرٌ، وهو أنّ ما قاله الرجلان في مواجهة عائشة لا يستوجب الحدّ ليجلد كل واحد منهما مائة جلدة، والجلد تعزيراً وتأديباً يفترض أن لا يبلغ مقدار الحد كما هو معروف لدى الفقهاء!
ولذا قد لا نجد تفسيراً لذلك سوى أنّ ثمّة خصوصية في المقام استوجبت ذلك، وهي أنّ التي تناولاها بالكلام الجارح وغير المؤدب هي زوجة النبي(ص) ما استدعى بلوغ العقوبة مستوى الحد، رعاية لرسول الله(ص) واحتراماً لعرضه وكرامته.
-
الاحترام لا يلغي النقد
واحترام زوجات النبي(ص) إنّما يمنع من توجيه أية إهانة أو إساءة لهن، أو أي تعرّض أو انتهاك لكرامتهن، لكنّه لا يمنع من دراسة مواقفهن التاريخية دراسة نقدية موضوعية، تهدف إلى التعرّف على حقائق التاريخ ومجرياته ومحطاته المختلفة، ومن الطبيعي أنّ علينا أن نفرّق بين النقد والتجريح، فإنّ النقد لا يعني إطلاقاً انتهاك حرمة الآخر والتعرّض له بالسبّ والطعن أو النيل من كرامته، وإذا لم نعمل على التفكيك بين الأمرين واعتبرنا أنّ كل نقد هو تجريح، فإنّ ذلك سيعني تجميد عملية البحث التاريخي، ليس فيما يتصل بزوجات النبي(ص) وسيرتهن معه(ص) أو مع غيره
فحسب، بل وفيما يتصل بعموم سيرة أصحابه أيضاً، وهذا الأمر غير مقبول ولا يستند إلى منطق أو حجة، وله تداعيات سلبية كثيرة:
أولاً: هو سوف يضيّع علينا الكثير من حقائق التاريخ ومجرياته، مع ما تتضمنه من دروس وعبر لنا، فطيّ صفحات التاريخ وإهمال أحداثه هو أمر يرفضه العقل السليم، كما يأباه المنطق القرآني الذي أكثر من الحديث عن الأمم الماضية وشؤونها وشجونها، وإخفاقاتها ونجاحاتها، ودعانا لاكتشاف السنن الحاكمة على حركة التاريخ، ووجّهنا إلى قراءته قراءة من لا يرمي إلى السكون فيه، بل
قراءة من يريد استلهام العبر والدروس منه، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف: 111].
ثانياً: إنّ إسباغ هالة من القداسة على الأشخاص غير المعصومين، أو على مرحلة زمنية معينة من تاريخنا هو أمر غير مفهوم ولا مبرر له على الإطلاق،والأمر المخيف أنّ ذهنية التقديس هذه انسحبت على العصور الإسلامية الأولى عامة، وربما امتدّت إلى ما هو أبعد من تلك المرحلة أيضاً، فغدونا نقدس غير المقدّس ونمنح العصمة لغير أهلها، الأمر الذي شكّل عائقاً جدياً أمام إعادة قراءة تلك المرحلة المهمة من تاريخنا الإسلامي.
معوّقات القراءة النقدية لتاريخنا
وقد حاول البعض إعطاء ذلك التقديس بُعداً شرعياً دينياً من خلال التمسك ببعض الأحاديث والروايات، من قبيل ما روي عنه(ص): "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته".
ولكن هذا الحديث إنّما يشير إلى حالة التردي التي ستصيب الأمة شيئاً فشيئاً، وهذا لا يعني أنّه بصدد إعطاء نوع من العصمة لقرنه أو لأهل قرنه، بحيث يمنع ذلك من دراسة هذا العصر وأحداثه ومجرياته وتقييم الأدوار التي قام بها رموزه وشخصياته، لأنّ الخيريّة للقرون الأولى إن ثبتت، فهي خيرية لتلك المرحلة على نحو الإجمال، باعتبار أنّها كانت أقرب إلى الخير، وليس معنى ذلك إضفاء شرعية على كلِّ ما جرى في ذلك الزمان، أو إعطاء عصمة لكل أفراد ذلك المجتمع، أو تفضيلهم فرداً فرداً على غيرهم، فهذا ما لا دلالة للحديث عليه، ولا الواقع الخارجي يصدّقه.
ولهذا فإنّي أعتقد أنّ ثمة موانع مصطنعة تحول دون قراءة تاريخنا الإسلامي قراءة موضوعية تتحرى الحقائق وتستهدي السنن وتأخذ الدروس والعبر، وأهم هذا الموانع هو نظرية "تقديس العصر الأول" بكلِّ شخصياته ورموزه، استناداً إلى نظرية "خير القرون" الواردة في الحديث المشار إليه، أو استناداً إلى نظرية "عدالة الصحابة" والتي تمنح كل صحابي رأى رسول الله(ص) ولو مرة، أو جالسه ولو سويعة من الزمن نوعاً من القداسة، والحال أنّها نظرية لا تدعمها حجة ولا ينهض بإثباتها الدليل، ولهذا فنحن لا نوافق على إسدال ستار من التعتيم على مجريات العصر الإسلامي الأول وأحداثه بأمثال هذه الحجج الواهية، بل إنّ من الضروري دراسة تلك المرحلة من تاريخنا بحلوها ومرّها، بظاهرها وباطنها، بما لها وما عليها، وذلك بهدف:
-
استخلاص الدروس والعبر من أحداثه التاريخ ومجرياته، واستلهام رموزه وعطاءاته، وهذا لا يمكن أن يحصل إلاّ في ظل قراءة نقدية موضوعية محايدة لا تتخذ موقفاً مسبقاً من الأحداث والرموز، ولا ترمي إلى التجمّد في الماضي، ولا التنازع باسم التاريخ ورجالاته، ولا تنطلق من خلفية انتقامية معبّأة بالعواطف والأحقاد ضد هذا التاريخ أو صانعيه على خلفيّة ما فعلوه من جرائم وجنايات، وبغير هذه القراءة فإني أعتقد أنّه لن يتسنّى لنا أخذ صورة صحيحة قريبة من الواقع عن هذا التاريخ، وبالتالي لن يتسنّى لنا الإفادة من فتح صفحاته وإعادة قراءته، بل سيتحوّل هذا التاريخ إلى مشكلة إضافية نتصارع عليها، وتضاف إلى مشاكلنا ومشاغلنا الكثيرة.
-
التعرّف على ديننا، فقهاً وعقيدةً، فإنّه أي الدين إنّما يؤخذ عن هؤلاء الصحابة والتابعين فيما رووه عن رسول الله(ص)، ومن المعلوم أنّ دراسة أحوال هؤلاء الصحابة ومعرفة الكاذب منهم من الصادق والثقة الضابط من غيره سوف ينعكس على التعامل مع روايات هؤلاء.
فلدراسة تلك المرحلة الحساسة من تاريخنا الإسلامي أكثر من فائدة مرجوة، فبالإضافة إلى التعرّف على السنن الحاكمة على التاريخ، هناك فائدة فقهية، وأخرى عقدية .
رفض المجاملات
وأعتقد أنّ علينا أن نبتعد عن المجاملة في هذه القضايا، لأنه لا مجاملة في قضايا الدين والاعتقاد، ومن هنا ففي الوقت الذي ندين فيه الإساءة إلى عفّة زوجات النبي(ص) بأجمعهن ونرفض إلقاء التهم جزافاً، أو اللجوء إلى أساليب السبّ والشتم، فإنّنا نرفض إقفال البحث في هذه القضايا تحت أي ذريعة أو حجة، وندعو إلى قراءة هذا التاريخ بعين البصيرة سعياً للتعرّف على حقائقه.
وفي ضوء ذلك، فإننا وفيما يتصل بالموقف من السيدة عائشة لا نستطيع أن نغضّ الطرف عما جرى في معركة الجمل، فيوم البصرة لم يكن يوماً عادياً في تاريخ الإسلام، أو قضية عابرة، أو حادثة بسيطة، فما جرى طبقاً للموازين الشرعية المتسالم عليها عند كافة المسلمين هو خروج جلي وموصوف على الإمام الشرعي والخليفة العادل، وما كان لعائشة أن تقع فريسة ذلك، وتقود
أو يقاد باسمها حرباً ضروساً ذهب ضحيتها آلاف المسلمين من الطرفين، مع أنها مأمورة بنص الكتاب أن تقرّ في بيتها، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ} [الأحزاب: 32]، كما أنّها كغيرها من المسلمين والمسلمات ملزمة باتباع الخليفة الشرعي وهو الإمام أمير المؤمنين(ع) والذي بايعته جماهير الأمة وأهل الحل والعقد منهم، ولا يجوز لأحد الخروج على الحاكم العادل أياً كان أو نقض بيعته، ما دام سائراً على هدي الكتاب والسنة، فكيف إذا كان هذا الخليفة هو الإمام علي بن أبي طالب(ع) المعروف بعدالته ونزاهته وسابقته في الإسلام والجهاد والتضحية والإيثار.
ولا يكاد يخفى على أحد أنّ يوم الجمل كان يوماً ثقيلاً ومراً في تاريخ المسلمين، وقد حفر جرحاً عميقاً وبليغاً في وجدان الأمة وفي جسمها، مؤسساً لما بعده من أحداث أليمة وحالات تمرّد وانشقاق على الخليفة الشرعي الإمام علي(ع)، ومن أبرزها ما حدث في يوم صفين وما تلاه من فتنة الخوارج في النهروان، إلى غير ذلك من الأحداث الأليمة. إنّ موقف السيدة عائشة في كل هذه الأحداث وسواها ليس فوق النقد، تماماً كما هو الحال في مواقف غيرها من زوجات النبي(ص) أو صحابته.
المحور الثاني: المسألة في ميزان العقل
والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في المقام وقد طرحه علماء الكلام قديماً: هل يمكن أن ترتكب زوجات الأنبياء(ع) ما ينافي العفة والشرف، أي الفاحشة الموصوفة؟
يظهر من مشهور العلماء أنّ صدور الفاحشة من زوجة النبي(ع) - أي نبي كان - هو أمر مستقبح عقلاً، وأنّ الله تعالى بمقتضى حكمته ولطفه يحول دون وقوع ذلك، حمايةً لنبيه(ع) وحفظاً لدوره في تبليغ الرسالة، فإنّ ارتكاب زوجة النبي(ع) لما ينافي العفة سيكون سبباً لنفور الناس من النبي(ع) وابتعادهم عنه وعدم الإصغاء إليه، وكيف ينقادون لرجل ترتكب زوجته أعمالاً تنافي الشرف والعفة؟!
يقول الشيخ محمد بن الحسن الطوسي)ت: 460 ه( في تفسير خيانة زوجتَي نوح ولوط(ع) الواردة في قوله تعالى: {رَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم: 10]: "قال ابن عباس: كانت امرأة نوح(ع) كافرة تقول للناس: إنّه مجنون، وكانت امرأة لوط(ع) تدلّ على أضيافه، فكان ذلك خيانتهما لهما، وما زنت امرأة نبيّ قط، لما في ذلك من التنفير عن رسول الله(ع) وإلحاق الوصمة به، فمن نسب أحداً من زوجات النبي(ع) إلى الزنا فقد أخطأ خطأً عظيماً، وليس ذلك قولاً لمحصِّل".
وقال الحافظ الكبير ابن كثير الدمشقي )ت: 774 ه( في تفسير الآية المذكورة: "أي خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه، وليس المراد أنّهما كانتا على فاحشة حاشا وكلا ولمّا، فإنّ الله لا يقدِّر على نبي أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف: "ما بغت امرأة نبيّ قط"، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأً كبيراً".
تحصين النبي من المنفِّرات
والسؤال: هل أنّ العقل يحكم فعلاً كما يقول هؤلاء الأعلام بأنّ الله تعالى لا يمكّن من حصول هذا الأمر بالنسبة لزوجات الأنبياء(ع)؟
والجواب: إنّ العقل يدرك مسألةً أساسية، وهي أنّ الله تعالى بمقتضى لطفه وحكمته لا بدّ أن يُحصّن رسوله(ع) من كل مثلبة أو منقصة في شخصه أو فعله أو نسبه أو فيما يخصّه من غير ذلك، إذا كانت هذه المثلبة تؤثّر بشكل سلبي كبير على دعوة النبي(ع) وتقف حجر عثرة أمام انتشارها وتحول دون
استماع الناس إلى النبي(ع) وإقبالهم عليه وانقيادهم له، شريطة أن لا يكون نفورهم منه منطلقاً من دوافع شخصية، أو فئوية عنصرية، أو من دوافع فرضتها أجواء التقليد أو العناد والتمرد، أو لأنّه يهدد مصالح طبقة معينة وما ألفوه من عادات وممارسات، بل لكون تلك المثلبة أو المنقصة تُعَدُّ عيباً حقيقياً أو عرفياًواجتماعياً، بحيث توجب اشمئزاز الناس عنه وانفضاضهم من حوله ونفورهم عنه، فإنّ إرسال نبي كهذا هو خلاف الحكمة، وهذا ما ذكره علماء الكلام.
يقول العلامة ابن ميثم البحراني (ت: 699 هـ): "ينبغي أن يكون منزَّهاً عن كل أمر ينفّر عن قبوله، إمّا في خُلُقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخلوالحسد والحرص ونحوها، أو في خَلْقِه كالجذام والبرص، أو في نَسَبِه كالزنا ودناءة الآباء، لأنّ جميع هذه الأمور صارف عن قبول قوله والنظر في معجزته، فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته واستمالة قلوبهم إليه".
والمستفاد من هذا الكلام وغيره أنّ النبي(ع) منزّه عن جميع المنفرات:
-
سواء كانت في شخصه الكريم.
-
أو كانت في بعض الدوائر المقربة منه، مما ينعكس عليه ويعاب به.
والأول، أعني ما كان من المنفرات في شخصه:
-
تارة تكون في خُلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها.
-
وأخرى تكون في جسده، كالأمراض المنفرة، من قبيل الجذام والبرص.
والثاني، أعني ما يكون منها في أهله والمقربين منه:
أ إمّا أن يكون في نسبه.
ب أو يكون في زوجته.
ونزاهة النبي(ع) عن كل المنفّرات هي من مقتضيات اللطف الإلهي في تقريب الناس نحو الكمال، ويشهد لهذا الحكم العقلي بعض النصوص:
أولاً: قوله تعالى: {وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ}، حيث يستفاد من هذه الآية الشريفة أنّ الأنبياء(ع) مبرّؤون من كل ما يوجب ارتياب المبطلين في نبوتهم، ولا شكّأنّ الانحراف الأخلاقي إذا وصل إلى بيت النبي(ع) فسيكون سبباً لارتياب المبطلين.
ثانياً: ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق(ع): "إنّ أيوب مع جميع ما ابتلي به لم ينتن له رائحة، ولا قبحت له صورة، ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح، ولا استقذره أحد رآه، ولا استوحش منه أحد شاهده، ولا يدوّد شيء من جسده، وهكذا يفعل الله تعالى بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه، وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه من
التأييد والفرج..".
ومع اتضاح ذلك نقول: إنّ زواج النبي(ع) مثلاً من امرأة خاطئة ترتكب فاحشة الزنا مع كونها في حباله هو أمر قبيح ومستهجن، ولذا فإنّ الله تعالى يمنع من حصوله، لما تقدّم من أنّه يوجب نفور الناس عن النبي(ع)، واشمئزازهم منه، كما يوجب ارتياب المبطلين في أمره، ولا سيّما أنّ للنبي(ع) مهمة إصلاحية وتغييرية، وذلك سيؤثّر سلباً على دعوته، فأنّى له أن يؤثر في إصلاح الناس وبيته فاسد! فالأولى به أن يصلح بيته قبل إصلاح الآخرين.
النبي لا يختار الخاطئة
على أنّ النبي(ص) بحسب كمالاته الروحيّة لا يختار امرأة زانية أو مشركة للزواج بها، كما يشير إليه قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3].
وهكذا قوله سبحانه وتعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [النور: 26]، وسيأتي البحث في دلالة هاتين الآيتين لاحقاً.
ولكن حيث عرفت أنّه ليس من الضروري أن تكون زوجات الأنبياء(ع) معصومات، لذا فقد ترتكب زوجة النبي(ع) ذنباً مما لا يشين ارتكابُه زوجَها، وهذا ليس بمستحيل عقلاً، فمن الممكن أن تسرق أو تغتاب أو تقتل أو تكذب.. ومن الطبيعي أنّها لو فعلت ذلك فإنّ على النبي(ع) إن كان مبسوط اليد أن يؤدبها بما تستحق، كما يؤدّب غيرها من الناس، لأنّه ليس هناك أحد فوق القانون. هذا هو الدليل العقلي على ضرورة تنزيه زوجات الأنبياء(ع) من ارتكاب الفاحشة.
ولكنّ هذا الدليل قد تواجهه العديد من الملاحظات:
المؤاخذة على ما ليس بالاختيار!
الملاحظة الأولى: إنّ عصمة النبي(ع) ونزاهته عن الخصال السيئة أو ارتكاب الأفعال القبيحة التي تدخل تحت اختياره هو أمر مفهوم ووجيه، وهو موضع اتفاق في الجملة بين المسلمين، وأما تنزيهه عمّا هو خارج عن إرادته مما يتصل بلونه أو نسبه أو ذريته أو ما تفعله زوجاته أو أبناؤه فهذا قد لا يبدو مفهوماً في بادىء النظر، لأنّ ذلك بحكم خروجه عن إرادته فهو ليس مما يدخل تحت مسؤوليته ولا يلام عليه، لأنّ قانون العدل الإلهي يقول: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38]، ويقول أيضاً: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [الأنعام: 164]، وعليه فلا معنى لاشتراط ذلك في النبوة.
والجواب: إنّ الكلام ليس في معذورية النبي(ع) أو عدمها، ليقال: إنّ ما هو خارج عن اختياره لا يلام عليه ولا يتصل بمسؤوليته، وإنّما الكلام هو في ضرورة إزالة المنفرّات العامة عن طريق الدعوة والمعوّقات العقلائية التي تؤثر سلباً في قبول الناس بها، وربما تعذّر أو احتج بها أهل اللجاج والعناد أو
غيرهم للتشويش على الرسالة، فتكون إزالتها تتميماً للحجة على الناس، كما قال تعالى: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ}، ولذلك فإنّ الله تعالى بمقتضى حكمته لا بدّ أن يحصّن الرسول(ص) من كل ما يوجب الشين أو المعرّة ونفور الناس عنه، فإنّ ذلك سوف يشكّل عائقاً عن انقياد الناس له دون فرق
بين أن يكون ذلك عيباً في خلقه أو نسبه أو شخصه أو زوجاته أو بناته وأولاده، فهل ترى أنّ الناس تنقاد لنبي من الأنبياء(ع) وهي ترى أنّ بناته مثلاً يقمن بأعمال تخلّ بالشرف وهنّ في عهدته وبيته؟! أو أنّ زوجته تمارس الزنا، وربما تلد له ولداً من الزنا ويُنسب الولد ظاهراً إلى النبي(ع)!؟
إنّ هذه الأفعال وإن كانت ممكنة الصدور من كلّ إنسان باستثناء المعصوم نفسه، بيد أنّ الله تعالى وحمايةً للدور الرسالي الذي يضطلع به المعصوم، فإنّه يحمي أسرته من أمثال هذه المنكرات والفواحش التي توجب الانفضاض عنه.
ارتكاب الفاحشة بعد موت النبي(ص)
الملاحظة الثانية: إنّ هذا الدليل لو سلّمنا به إنّما ينفع في تنزيه زوجة النبي(ع) عن ارتكاب الفاحشة الموصوفة ما دام زوجها (وهو النبي) حياً قائماً بالدعوة وهي في وثاق الزوجيّة، أمّا أن تفعل ذلك بعد موته وانتشار دعوته وثبوت صدقه وظهور حجته فلا يضر ذلك في مصداقية النبي(ع) ولا يثير مشكلة ذات أهمية.
ويمكن أن يجاب: إنّه لا فرق بين حدوث ذلك في حياته أو بعد موته، فإنّ قبح ذلك واستهجان العقل السويّ له موجود في الحالتين، كما أنّ تأثيره السلبي على شخصية النبي(ع) وصدقيّة رسالته هو أمر قد يحصل ولو كان ذلك بعد موته وانتقاله إلى العالم الآخر، لأنّ حصول ذلك مع زوجته الباقية على زوجيّته قد يثير الريبة لدى المبطلين ويبعث على الشك في النفوس، بأنه لو كان نبياً حقاً لما
انحرفت زوجته وما حدث ذلك مع أهله وأقرب الناس إليه خصوصاً إذا كانت رسالته ممتدة مع الزمن كما في رسالة نبينا محمد(ص) حيث يُطلب عدم التنفير عنها.
وقد تسأل: هل يمكن أن ترتكب الفاحشة قبل الزواج من النبي(ع) ثم تتوب إلى الله توبة نصوحاً فيتزوجها النبي(ع)؟
والجواب: إنّه التنفير من النبي(ع) ليس واضح التحقق في المقام، ولذا
قد يقال: إنّه لا مانع من الزواج منها، وهكذا قد يقال: إنّه لا محذور في ارتكابها لذلك إذا فارقها النبي(ع) بطلاق أو نحوه، ولم تعد في عهدته ولا تحت مسؤوليته الزوجية المباشرة.
لماذا لم يخبر النبي(ص) باستحالة ذلك؟
الملاحظة الثالثة: ما ذكره العلامة الخاجوئي من أنّه "لو لم يجز ذلك - أعني صدور فاحشة الزنا من زوجة النبي(ع) - لكان على رسول الله(ص) حين قُذفت زوجته (يقصد بذلك ما حصل في قصة الإفك الآتية) أن يخبر بأنّه لا يجوز عليها، ولكنّه بقي أياماً والناس يخوضون فيه إلى أن نزل الوحي ببراءتها، وكيف لا يجوز وقد قال الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} ولذلك لم يشترط أحد من العلماء عصمتهن عنه".
ويلاحظ عليه: بأنّ عدم تصدي النبي(ص) لبيان استحالة وقوع زوجته بالزنا قد لا يكون سببه هو عدم إدراك العقل لاستحالة ذلك، وإنّما كان ذلك انتظاراً منه للوحي، ليثبت لكل الناس ولا سيّما المشككين والمنافقين، من خلال هذا الطريق الواضح والغيبي نزاهة زوجته وبراءتها مما قذفت به.
وأمّا فيما يتصل باستشهاده بالآية المذكورة، فسوف يأتي التعليق عليه والمناقشة فيه لاحقاً.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ العلامة الخاجوئي هو من القائلين بأنّه لم تقع أية واحدة من زوجات الأنبياء(ع) بالفاحشة، وأنّ اللائق بمنصب النبوة نزاهتهنّ عنه وسلامتهن منه، وسنذكر نص كلامه لاحقاً، فهو في كلامه المتقدم إنّما يناقش في دعوى وجوب نزاهتهن عقلاً عن ارتكاب ما ينافي العفة، ولكنه يؤمن بالنزاهة ويعتقد بها لدليل آخر.
كيف تكون كافرة ولا تكون فاجرة؟!
الملاحظة الرابعة: "كيف جاز أن تكون امرأة النبي(ع) كافرة، كامرأتَي نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاجرة؟!"
وقد أجيب على ذلك: بأنّ ثمة فارقاً بين الكفر والزنا، فالكفر ليس من المنفّرات كما هو الحال في الزنا، وذلك لأنّ "الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم، فيجب أن لا يكون معهم (أي الأنبياء) ما ينفرهم )أي الكفار) عنهم، ولم يكن الكفر عندهم - أي عند الكفار - مما ينفر، وكون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم المنفرات".
النبوّة وتغيير العادات
الملاحظة الخامسة: إنّ المنفّرات التي لا تألفها الطباع قد تكون ناشئة من الأُلفة ومن التربية الخاطئة فلا ضرورة لتنزه الأنبياء(ع) أو زوجاتهم عنها، بل إنّ الرسالة قد تأتي بتغيير هذه العادات في كثير من الحالات.
ولكن يلاحظ عليه: أنّ هذا الكلام إنّما يكون وجيهاً في المنفرّات التي تنشأ من العادات الاجتماعية دون المنفرات التي يأنفها الإنسان بطبعه وفطرته أو تدرك العقول قبحها أو يأباها الذوق السليم، كما في ارتكاب الفواحش المعروفة، ومن الواضح أنّ ارتكاب زوجة النبي(ص) للزنا هو من القبائح والمنكرات الموجبة لسقوط هيبة النبي(ع) في نظر العقلاء ونفورهم عنه، وهذا ما تؤكّده الآيات
القرآنية الواردة في قصة الإفك الآتية.
الحسن والقبح عقليان أم شرعيان؟
الملاحظة السادسة: إنّ القول باستحالة وقوع زوجات الأنبياء(ع) بارتكاب ما ينافي العفة، أقصد ارتكاب الفاحشة الموصوفة ليس مجمعاً عليه عند كافة المذاهب الإسلامية، وإنما يتم عند القائلين بالحسن والقبح العقليين دون من ينكرون ذلك.
وقبل الإجابة على هذه الملاحظة يفترض بنا أن نقدّم مقدمة صغيرة نبيّن فيها المقصود بهذه المسألة، أعني كون الحسن والقبع عقليين، والمقدمة هي:
إنّ هناك اتجاهين مطروحين في علم الكلام في مسألة حسن الأشياء أو قبحها: فهناك الاتجاه الذي تبناه العدلية وهم الشيعة والمعتزلة، وهو يرى أنّ حسن الأشياء وقبحها عقليان، وليسا شرعيَّين، فالعدل مثلاً حسن في ذاته، لا لأنّ الشرع أمر به، بل إنّ حسن العدل الذاتي هو ما دفع المشرّع للأمر به، والظلم قبيح في نفسه لا لأنّ الشارع نهى عنه، بل إنّ قبحه الذاتي هو الذي دفع المشرِّع للنهي
عنه.
وفي المقابل، هناك الاتجاه الآخر الذي تبناه الأشاعرة، وهو يرى أنّ حسن الأشياء وقبحها شرعيان، وليسا عقليين، فالعدل حسن ومطلوب لأنّ الشرع أمر به، والظلم قبيح ومرفوض لأنّ المشرّع نهى عنه، ولولا أمر الشارع بالعدل لما كان حسناً، ولولا نهي الشارع عن الظلم لما كان قبيحاً، بل لو أنّ الشرع نهى عن العدل لصار قبيحاً، ولو أنه أمر بالظلم لغدا حسناً!
واستناداً إلى الاتجاه الثاني فليس مستنكراً في حكم العقل أن تكون زوجة النبي(ع) امرأة زانية، وعليه فلا يمكننا أن نُدخل الرافضين للحسن والقبح العقليين في دائرة من يقول بقبح ارتكاب زوجة النبي(ع) للفاحشة، لأن العقل وبغض النظر عن الشرع لا يقبُح ذلك بنظرهم.
وتعليقاً على ذلك أقول: إنّ هذه الملاحظة صحيحة من حيث المبدأ، فلا يمكن لمن لا يؤمن بأنّ حسن الأشياء وقبحها عقليان أن يُنكر إمكانية صدور الفاحشة من زوجة النبي(ع) أو أن تكون أمه غير عفيفة))). لكن وبناءً على ما أشرنا إليه فيما سبق فإن ذلك لا يعني التزام هؤلاء بإمكانية صدور الفاحشة من زوجات الأنبياء(ع)، فضلاً عن صدورها بالفعل، فربّما نهض لديهم دليل آخر من الشرع على عدم إمكان ارتكاب زوجة النبي(ع) للفاحشة، وهذا ما هو حاصل فعلاً، فقد نصّ بعض من ينكر حسن الأشياء وقبحها العقليين على عدم صدور الفاحشة من زوجات الأنبياء(ع)، ولهذا وجدنا أن ابن كثير قد نصّ في كلامه المتقدم على أنّ الله تعالى لا يُقدِر على ذلك، وهكذا غيره من الأعلام.
وخلاصة القول: إنّ العقل السليم يدرك أنّ الله تعالى إتماماً للحجة المتمثلة بإرسال الرسل لا بدّ أن يحصّن ساحة نبيه(ع) من كلّ عيب مشين يوجب نفور الناس عنه ويشكّل عائقاً حقيقياً أمام إقامة الحجة، حتى لو كان هذا العيب ليس في شخص النبي(ع) ولا يعد مسؤولاً عنه بشكل مباشر.
وهذا الكلام على مستوى القاعدة العامة أو الكبرى، كما يعبر المناطقة، لا غبار عليه، لكن على صعيد الصغرى وهي المفردة التي توجب نفور الناس عنه، فإنّها تبقى محل جدل وتأمل، وهي تخضع لثقافة الناس ورؤيتهم حول هذه الأمور، فربّ أمرٍ كان فيما مضى موجباً لانفضاض الناس عن النبي(ص) أو الإمام(ع) أو القائد الرسالي باعتباره مصداقاً للعيب الاجتماعي المشين، لم يعد كذلك في الزمن الحاضر، سواء كانت هذه الصفة في شخصه أو في نسبه أو زوجته، ما يعني أنّ القضية متحركة ومتغيرة، وقد كان علماء الكلام يذكرون في عداد المنفرات أن لا يكون النبي حائكاً ولا حجاماً. والظاهر أنّ النظرة إلى هذه الحِرَف أو المهن في زماننا لم تعد تحمل هذا المعنى السلبي الكبير الذي يستوجب عدّها ضمن المنفرات، التي لا بدّ أن يتنزه الأنبياء(ع) عنها.
نُشر في تاريخ 25-7-2019 م