قراءة في كتاب: هل ظلمنا الله؟!
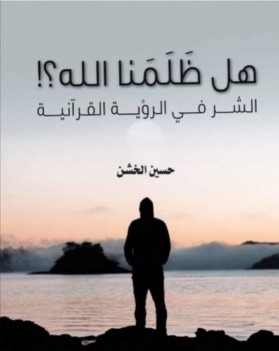
هل ظلمنا الله؟
قراءة في كتاب
صلاح مرسول العصار
يأتي هذا الاصدار من العلامة د. الشيخ حسين الخشن (دام عطاؤه)، ملامسًا هدفية إصدار سابق للمصنف تحت عنوان "عالم دون أنبياء - قراءة نقدية في الفكر الربوبي"، من حيث الاتجاه الذي يرمو إليه، من خلال معالجة إسلامية معاصرة، لإشكاليات عقدية وفكرية مستجدة، فما نحن بصدده "هل ظلمنا الله؟ الشر في الرؤية القرآنية" هو عبارة عن دك رأس الالحاد، وملاحقة جملة من التشكيكات التي قد يكون بعضها بريئًا والآخر ليس كذلك.
والكتاب في الأصل دروس ألقيت على جمع من طلبة الحوزة العلمية في بيروت وكنت ممن تشرف بحضورها، وهو درس متخصص في موضوعات القرآن الكريم، وقد صدر قبله كتاب "حاكمية القرآن" للمصنف نفسه هو أيضًا عبارة عن دروس ضمن عنوان الدرس نفسه، وما يميز أستاذنا -المصنف-، أنه لا يلقي دروسه بشكل ارتجالي، فقد اعتاد طلبته على دقة تحضيره وحسن بيانه وعمق موضوعه.
يرى المصنف أن السؤال الذي يُطرح من قبل أي إنسان لا يمكن أن نعتبره في الوهلة الأولى تشكيكًا، بل قد يكون بوابة علم واطمئنان قلب وفتح بصيرة، بل ربما نرتكب نحن الذين نتكلم باسم الدين خطأ عندما نلوم أو نكفر من يتوجه بالسؤال والعتاب إلى الله تعالى، فلابد من ايجاد عذر والبحث عن دوافع السؤال والعتاب، فهم بحاجة لمن يجيب على أسئلتهم ويروي عطشهم الفكري وظمأهم الروحي، بحاجة لعقل يتفهم هواجسهم وقلب يحتضنهم وخطاب يستوعبهم، بدلا من خطاب الجلد والرعب والتخويف.
وهنا نجد المصنف كما كان في نقاشه مع الربوبي، ذا نزعة أبوية احتوائية، يتفهم من صور له الإله بأنه المنتقم الذي يقف بالمرصاد، همه التصيد وملء السجل بالزلات حتى يحاسبهم!. ومن هذا المنطلق يدعو المصنف الموجوعين والمعذبين والخائفين والمحرومين، بأن لا يسمحوا لآلامهم وأوجاعهم أن تسقط أو تضعف إيمانهم وإرادتهم، ويدعوهم لتجربة جديدة، أن نتوجه إلى الله تعالى، نحدثه ونشكو إليه همومنا ونبث له أحزاننا وآلامنا، وباللجوء إلى الله والتفكر في صفاته وأفعاله، والطلب منه بالهداية؛ سنستشعر وجوده وقربه ورحمته لنا.
ومحور الكتاب هو إشكالية الشرور ومدى انسجامها مع عدل الله تعالى وحكمته، وتعتبر هذه الاشكالية متكأ من يدّعون الالحاد، حيث يرى البعض أن ما يشوب الحياة من نقص وعيوب وتشوهات وظلم ..، وخلود في النار وعذاب أليم، أين عدل ورحمة الله كما تدعون؟ والمصنف قد عالج مثل هذه الاشكالية في كتاب آخر تحت عنوان "هل الجنة للمسلمين وحدهم؟" ومال إلى عدم دائمية العقاب، وأدعو القارئ الكريم للرجوع لهذا الكتاب المهم أيضًا.
يبين المصنف على نحو واضح إشكالية الشرور وما يصحبها من عناوين مختلفة، ويحاول أن يقدم إجابات وافية مع بيان قواعد عامة ومفاهيم أساسية ترتبط بالاشكالية المطروحة، كما أنه يستعرض مقاربات ومعالجات قرآنية في هذا المقام، ولا يقبل بعضها بل يعتبرها غير موفقة ويقدم البديل عنها، ويتطرق لبعض الابتلاءات المعروفة التي تصيب كل إنسان، كالموت والمرض، كما أنه جعل ملحقا يستعرض فيه أجوبة على أسئلة تتصل بنفس الموضوع.
وما يميز المصنف في عرضة لهذا الكتاب، أنه يستوحي في مقاربته ومعالجته لإشكالية الشرور من وحي القرآن الكريم، حيث يستنطق القرآن ويجعله يجيب، وهذا النوع الرائع كان يطرحه على الدوام فيلسوف الأمة وشهيدها السيد محمد باقر الصدر (رض)، فاستنطاق القرآن الكريم وايجاد حلول لكل إشكالية هو الطريق الصحيح في تعاطينا مع كتاب الله العزيز.
وما يميز المصنف بشكل كبير أيضًا، هو المقاربة والتنظيم المحكم والتقديم الجميل بلغة قريبة إلى الوجدان، ممزوجة بالأدلة والبرهان، وكأنه يريد أن يقول: إن منهجية القرآن الكريم علمتنا أن نجمع بين البرهان والوجدان، وأن للقلب حقا كما أن للعقل حقا، ولا يمكنك الوصول إلى العقل إلا من خلال القلب، وذلك من خلال امتزاج العاطفة بالعقل، فالقلب بحاجة لشعور برودة الاطمئنان، والعقل بحاجة بساطع البرهان. والدافع الذي جعل المصنف أن يتبنى مثل هذا المنهج، إيمانه بحساسية الاشكالية، وعدم استطاعتنا معالجتها بالتنظير الفكري فقط، بل نحن بحاجة لملامسة الوجدان.
وقد عمل المصنف على بيان الجانب التاريخي لإشكالية الشرور، وأبعادها وآثارها ومعايير تقييمها، وآثارها على العقيدة والسلوك، من حيث ميزان حسن الاشياء وقبحها هل هو عقلي أم شرعي؟، وأين موقعية العدل الالهي وحرية الارادة، كما أنه تطرق لمفهوم الابتلاء قرانيا، وعمل على ايضاح ذلك ضمن الرؤية القرآنية للخير والشر، وما هي حقيقة الشر؟ ما مصدره؟ علاقته بالله؟ علاقته بالانسان؟ دور الشيطان فيه؟
كما أننا نجد أن المصنف يلاحق أسئلة هامة ترتبط بالوجود الإنساني وفلسفته، كما أنه عمل على مقاربة ذي أبعاد مختلفة لإشكالية الشرور، فهو يحاول أن يوضح المقاربة البرهانية تارة، والمقاربة الإيمانية تارة، والمقاربة التربوية تارة، والمقاربة الاجتماعية تارة، ويدفع ويثبت بعض الاطروحات المرتبطة بالثنوية والتناسخية والاشاعرة والشيخية وغير ذلك.
ويطرح المصنف سؤالا ربما يشغل ذهن الكثير من الناس، كيف نفهم الموت ونتعامل معه؟ لماذا الموت؟ لماذا نخاف من الموت؟ لماذا نكره الموت؟ هل الموت عدم؟ هل من الممكن أن يكون الموت نعمة وبداية حياة؟ كذلك المرض كيف نفهم وجوده، هل هو عقوبة أم ابتلاء؟ هل يثاب المريض على مرضه؟ هذا الكم الهائل من الاسئلة نجد المصنف يبحر حولها ويحاول أن يقدم إجابات شافية لها بطريقة سهلة ممتنعة.
ويختم المصنف الكتاب بمسألة الشذوذ الجنسي، يستعرض الإشكالية ويعمل على معالجتها، ويقف مع أصل التسمية من جهة، ومع الأسباب وسبل العلاج من جهة أخرى، وفلسفة تحريم هذا النوع من العلاقة، فهو يرى أننا معنيون للتعامل مع هذه الظاهرة بمسؤولية، على المستوى الفردي والمؤسسي المتخصص، فلا يكفي أن ندين وأن نستنكر دون أن نقدم العلاج وأن نحتضن هؤلاء ونخلصهم مما هم فيه.
أما ملحق الكتاب فهو يتعلق بموت ويتم وتشوه الاطفال، فهناك أسئلة بحاجة لوقفة وإجابة، فالملحدون ينطلقون في إثاراتهم حول وجود إله عادل رحيم قادر، بوجود هذه الامراض المزمنة، فما ذنب الطفل مثلا ليتألم طيلة عمره بمرض مزمن لا علاقة له به؟ وما ذنبه ليعيش اليتم بسبب وجود الموت التي حرمه من الابوة؟ فطالما أن الله يعلم كل شيء لماذا يختبرنا إذن؟
ويأتي الاصدار عن دار روافد، بيروت، ٢٠٢١م