العقل الفقهي بين الاستبداد بالرأي وفقه الافتراضات
الشيخ حسين الخشن
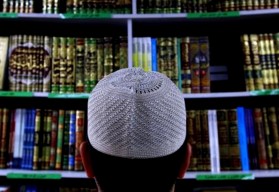
لعل من أهم مزايا البحث الفقهي الاستدلالي أنه بحث يعتمد آلية تفكير علمية وموضوعية، تتجلى في بعض مظاهرها في اعتماد طريقة منهجية تعمل على تشريح القضية المطروحة على بساط البحث وطرح كافة الاحتمالات المتصورة، ومن ثم دراستها وغربلتها، كما أنه يتم استعراض الأدلة المختلفة والأقوال المتنوعة بنفس الطريقة دون استهانة بالرأي أو بصاحبه.
بعيداً عن لغة الجزم:
وهذه الطريقة كان لها الأثر البالغ في تطوير البحث الفقهي وإثرائه، وخدمة الحقيقة الفقهية، وساهمت في ديمومة أو استمرارية الحراك الفقهي، وحالت دون إصابة علم الفقه بالتكلس والجمود أو الشلل الكلي.
ومن الإيجابيات المفترضة لهذا المنهج الفقهي الاستدلالي أن تأتي النتائج الفقهية انعكاساً له ومنسجمة معه كامل الانسجام، فلا تطرح الفتاوى كقطعيات أو مسلمات وإنما كاستظهارات يستقربها الفقيه حسب اجتهاده، بعيداً عن لغة الجزم والاستبداد بالرأي، ولذا ترى أن الفقهاء الماهرين المطلعين على واقع المسائل وتشعبها وتعدد الوجوه والأدلة فيها يبتعدون في مقام الإفتاء عن استخدام عبارات الجزم والتعيين، وإنما يستخدمون عبارات الترجيح والتقريب من قبيل «الأقرب حرمة كذا» أو «الأرجح وجوب كذا..» أو «الأظهر» ونحوها من أفعال التفضيل التي لا تلغي الاحتمال المخالف، خلافاً لما يرد على لسان بعض الأغرار أو مراهقي الفقاهة الذين يكثرون من استخدام أفعال الجزم في الموارد الخلافية أو المتعددة الوجوه، فتأتي عباراتهم من قبيل «يحرم» أو «يجب» أو «الصحيح كذا» ونحوها من التعبيرات التي يُخيّل إليك لدى قراءتها أنهم يمتلكون ناصية الحقيقة أو أنّ الوحي قد أنزل عليهم. إن الفارق كبير بين قول الفقيه مثلاً «يحرم حلق اللحية» وقوله :«الأقرب حرمة حلق اللحية»، فإن الفقيه في الحالين وإن كان يختار الحرمة، لكن العبارة الأولى تلغي أو لا تعكس وجود احتمال مخالف، بخلاف العبارة الثانية فإنها تعطي إيحاءً واضحاً بوجود الاحتمال المخالف في المسألة.
التماس العذر للآخر:
ومن إيجابيات المنهج الفقهي المذكور أيضاً أنه يؤسس لذهنية تتربى على احترام التنوع الفكري والاجتهادي ولا تضيق بالاختلاف في الرأي، وإنما تحترم الآخر حتى وهي في موقع النقد له، تناقش الرأي دون أن تطعن في صاحبه أو تعمل على إسقاطه أو تخوينه أو تضليله، إنّ التسرع في طعن الآخر ورميه بالانحراف والشذوذ لا ينم عن جهل بواقع المسائل النظرية وتعدد الوجوه فيها فحسب وإنما ينم عن خلل في التربية الدينية، خلافاً لما كان عليه السلف الصالح من فقهائنا من احترام الآخر والابتعاد عن كل أشكال الطعن فيه، يقول الشيخ الطوسي رحمه الله وهو يشير إلى اختلاف علماء الشيعة في الأحكام الشرعية: «فإني وجدتها أي الطائفة مختلفة المذاهب يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبوب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديّات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض... ثم يعدد بعض النماذج من اختلافاتهم، ويضيف: وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلاّ وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينتهِ إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته» (عدة الأصول 138 136/1).
إن هذه السيرة تعكس رحابة علمية وذهنية موضوعية وتربية دينية تحتم على الباحث المنصف المتورع الابتعاد عن منطق الطعن بالآخر وإسقاطه، وما أحوجنا وأحرانا في هذه المرحلة التي عمّت فيها لغة التخوين والتضليل والتكفير إلى الاقتداء بسيرة هؤلاء السلف في مجال البحث العلمي، وقد وجدنا أن الكثير من الفقهاء لا يحاول التماس العذر للآخر فحسب، بل يعمل على التماس دليل له حتى لو كان رأيه مخالفاً للإجماع ولما جرى عليه المشهور، ونلاحظ ذلك جلياً في بحوث الشيخ الانصاري رحمه الله فانه ليس فقط لا يطعن في مخالفه بالرأي بل يحاول توجيه كلامه مهما كان ضعيفاً وواهياً.
إن منطق الاحتمال الواحد والفهم الواحد والرأي الواحد له تداعيات سلبية كثيرة وخطيرة ليس فقط على المستوى الاجتماعي والتربوي بسبب ما ينتجه من حملات التضليل والتضليل المضاد، بل على المستوى العلمي أيضاً، لأنه بالتأكيد سيحد من حيوية البحث الفقهي ويعيقه عن النمو والإبداع وقد يصيب العقل الفقهي بالتحجر بل العقم.
فقه الافتراضات:
بازاء ما تقدم من إيجابيات لمنهج البحث الفقهي المشار إليه، فإنه قد أفرز مجموعة من السلبيات، سببها انحراف طريقة البحث عن الجادة المستقيمة وخروجها عن المألوف من خلال تكثير الاحتمالات والافتراضات إن على مستوى ظواهر النصوص ومحاولة استنطاقها، بما يؤدي إلى تشتيت الذهن وضياع الحقيقة في غمرة الافتراضات المتناقضة أحياناً والبعيدة كل البعد عن الظهور، أو على مستوى الفروع الفقهية الافتراضية التي لا واقع لها إلاّ المخيلة الخصبة كما في الحديث عن زواج الأنس بالجن وأمثاله، أو على مستوى موضوعات الأحكام، مما لا تفسير للتردد فيها في كثير من الأحيان الا غربة الباحث عن الواقع وعدم إلمامه بالموضوع، مع أن حركة الفقه الإسلامي معنية بمواكبة المستجدات في شتى الميادين والحقول العلمية، لما لها من تأثير مباشر على النتائج الفقهية، لذا فمن غير المنطقي تذرع الفقيه بالجهل بالموضوع، أو أن معرفة الموضوعات ليست من شأنه، ولا من وظيفته، لأن هذا المنطق قد أسهم في انتاج ما قد نسميه بفقه الافتراضات، أو الفقه التجريدي الذي يغوص في تكثير الاحتمالات، وطرح الافتراضات، ما يوقع المكلفين في حيرة وارتبارك، بسبب الفتاوى المعلقة والافتراضية، كما هو الحال في الفتوى الشائعة حول التدخين القائلة: «إن ثبت ضرره البالغ يحرم»، أو غيرها من الفتاوى، أجل إذا كانت حدود الموضوع غائمة، وغير واضحة، ولا تزال تخضع لجدل علمي عند أهل الخبرة، فمن الطبيعي أن تأتي الفتوى معلقة، أما الموضوعات المحسومة علمياً فلا معنى لتعليق الفتوى فيها كما في فتوى التدخين أو الفتوى القائلة: «إذا كان قول الفلكي مفيداً لليقين جاز الاعتماد عليه»، فإنّ إفادته أعني قول الفلكي لليقين في التولد الفلكي على الأقل باتت من المسلمات العلمية، فلا معنى للتعليق فيها.
احترام التخصصات:
إن ما تقدم لا يشكل دعوة إلى تجاوز الفقيه لتخصصه ليكون مُلماً بكل العلوم، فهذا ليس منطقياً، ولا متيسراً، لا سيما في ظل تشعب العلوم، وتنوعها، وتعدد وظائفها، بحيث تفرع عن العلم الواحد عدة تخصصات، كما هو الحال في علم الطب وغيره، وإنما هو دعوة إلى امتلاك الفقيه ثقافة في موضوعات الأحكام ذات الطابع العلمي، من خلال الرجوع إلى أهل الخبرة، والاعتماد على آرائهم، لأن الجهل بالموضوع سيؤدي إلى استنتاجات خاطئة، ومجتزئة.
إذا كان المطلوب من غير المتخصص في الشؤون الفقهية الرجوع إلى الفقيه، وتقليده في المجال الشرعي، فإن المطلوب من الفقيه الرجوع إلى المتخصص في الميادين العلمية، وتقليده فيها.
بقلم الشيخ حسين الخشن
كُتب هذا المقال في عام 2010