أهم الاتجاهات التفسيريّة ذات العلاقة بالرواية -3
الشيخ حسين الخشن
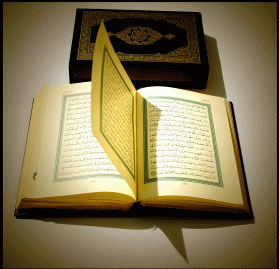
الاتجاه الثالث: تفسير القرآن بالرأي
وفي مقابل الاتجاه السابق ( التفسير بالمأثور )، وربما في مقابل الاتجاه الأسبق وهو ( تفسير القرآن بالقرآن )، فإنّ ثمة اتجاهاً ثالثاً برز في المقام وقد أعمتد في التفسير على الرأي والاجتهاد. لكن ثمّة محذور اعترض هذا الاتجاه، وهو أنّ مجموعة من الأخبار نهت عن التفسير بالرأي، وهي مرويّة من طرق الفريقين، وقد التزم بمضمونها كثير من الأعلام، بل إنّ المنع من التفسير بالرأي هو المعروف والمشهور عند علماء الفريقين، والذي يظهر من كلام بعض المفسرين ( ومنهم الشيخ المفيد كما سيأتي) أنّ النهي عن التفسير بالرأي يعني ضرورة اعتماد التفسير بالمأثور[1]، فتكون هذه المجموعة من الأخبار ( الناهية عن تفسير القرآن بالرأي) هي مستند إضافي للقائلين بانحصار التفسير بالمأثور.
وهذا ما نحتاج إلى أن نقيّمه بشكل موضوعي، من خلال النقاط التالية:
-
أقوال علماء الفريقين في التفسير بالرأي
قال الشيخ المفيد:" إنّ تفسير القرآن لا يؤخذ بالرأي، ولا يُحمل على اعتقادات الرجال والأهواء"[2].
وقال الشيخ الطوسي: " أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام ، الذين قولهم حجة كقول النبي صلى الله عليه وآله ، وإنّ القول فيه بالرأي لا يجوز . وروى العامة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق ، فقد أخطأ"، وكره جماعة من التابعين وفقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي، كسعيد بن المسيب، وعبيدة السلماني ، ونافع ، ومحمد بن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم. وروي عن عائشة أنها قالت : لم يكن النبي (ص) يفسر القرآن إلا بعد أن يأتي به جبرائيل ( ع )"[3].
وقال المفسر والعالم الشهير محمد بن جرير الطبري ( 310 هـ) بعد أن نقل بعض الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي: "وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا : من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو بنصبه الدلالة عليه ، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه ، لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق ، وإنما هو إصابة خارص وظان ، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لم يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده ، فقال: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }[الأعراف: 33]، فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي جعل الله إليه بيانه ، قائل بما لا يعلم ، وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه ، لان القائل فيه بغير علم ، قائل على الله ما لا علم له به"[4].
إلى غير ذلك من كلمات.
-
الروايات الناهية عن التفسير بالرأي
وعلينا أن نستعرض بعض هذه الأخبار الواردة في ذلك، ثمّ نقيّم الموقف:
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ معقده من النار "[5].
وروى الشيخ الصدوق بالإسناد إلى رسول الله (ص): " .. ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب.."[6].
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه"[7].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المعنى والتي عدّها بعضهم متواترة[8].
-
ما المراد من تفسير القرآن بالرأي؟
وهذه النقطة هي الأهم في المقام، وقد ذكرت عدة وجوه في بيان المراد بالرأي المنهي عنه في التفسير، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة[9]، وأنهاها السيد الطباطبائي إلى عشرة[10]، وربما أمكن إرجاع بعض هذه الوجوه إلى البعض الآخر، وإليك من أهمّ هذه الوجوه:
الوجه الأول: ما تبناه السيد الطباطبائي، من أنّ المنهيَ عنه هو التفسير بالرأي في مقابل رأي القرآن، فتكون هذه الأخبار داعية إلى تفسير القرآن بالقرآن، يقول رحمه الله: "والمحصّل أنّ المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة إمّا هو الكتاب أو السنة، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن"[11]. ويستشهد الطباطبائي لرأيه بأنّ " الإضافة في قوله: "برأيه"، تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال، بأنْ يستقلَّ المفسرُ في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإنّ قطعة من الكلام، من أي متكلّم، إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نُعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك أنه أراد كذا، كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما، كل ذلك لكون بياننا مبنياً على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصاديق الكلمات حقيقة ومجازاً. والبيان القرآني غير جار هذا المجرى .. بل هو كلام موصول بعضها ببعض، في عين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، كما قاله عليٌ عليه السلام، فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في انكشاف المعنى المراد منها، دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها"[12].
وربما يلاحظ على كلامه: بأنّ افتراض كون الغير الذي يجدر أو لا يجدر بالمفسر استمداد علوم القرآن منه، دائراً بين أن يكون هو القرآن أو السنة على نحو مانعة الجمع لا وجه له، إذ يمكن أن يكون الغير هو مجموع الكتاب والسنة، ولو على نحو طولي، وعندها فلا يستفاد من تلك الأخبار ما رامه. على أنّ لازم كلامه أنّ لا حجية للسنة في التفسير، وهذا ما لا نستطيع موافقته عليه، بل إنه لم يجر عليه في تفسيره.
الوجه الثاني: أنّ المراد بالتفسير بالرأي: الاعتماد على الوجوه الظنيّة الاستحسانية التي لا تراعي قواعد التفسير وضوابط قراء النص وفهم الكلام، ويشهد له ما جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار"[13].
باختصار: إنّ النظر في الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هو إلى ما كان شائعاً لدى مدرسة إسلامية من الأخذ والعمل بالاستحسان في دين الله، أي أنّ " كلمة الرأي منصرفة - على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص ، وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع - إلى الحدس والاستحسان فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة"[14].
الوجه الثالث[15]: أنّ المراد بالتفسير بالرأي[16]المنهي عنه: الاستقلال بالرأي دون الرجوع إلى النبي (ص) وأهل بيته (ع)، مع أنّهم عدلاءُ الكتاب، وقد أناط الله تعالى بنبيه (ص) مهمة بيان آيات الكتاب، ويدخل في هذا الوجه: الأخذ بالعمومات أو المطلقات أو المتشبهات أو المجملات دون الرجوع إلى المخصصات والمقيدات أو المحكمات أو المبينات. وإضافة الرأي إلى الشخص "برأيه" هو شاهد على هذا الوجه، فإن الحديث لم ينه عن القول بالرأي بقول مطلق، وإنّما عن أن يقول المفسر برأيه، ورأيُه هو في مقابل رأي غيره، والغير ليس سوى المعصوم، ويؤيده الحديث عن الإمام الصادق (ع): " .. وإنّما هلك الناس في المتشابه، لأنهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وراء ظهورهم"[17].
ربما يقال: إنّ الغير لا ينحصر بالمعصوم، فلربما كان هو إجماع الأمة، فيكون المنهي عنه هو استبداد المفسر وانفراده برأيه في تفسير الآيات.
ولكننا نقول: ليس ثمة ما يمنع أن يكون الغير هو الإجماع فيما لو ثبتت حجيته بدليل خاص، بمعنى أن يكون الرأي التفسيري المجمع عليه حجة وهذا مما لا دليل عليه أبداً.
وكيف كان، فالتفسير بالرأي بهذا النحو أو بسابقه، بصرف النظر عمّا إذا كانت الأخبار المتقدمة قد وردت في منعه هو مرفوض أما الأخير فلأن استبداد المفسر برأيه دون الرجوع إلى ما صح عن النبي (ص) أو الأئمة (ع) فيه تجاوز بيّن لما دل على حجية قولهم في التفسير مما تقدمت الإشارة إليه، وأما سابقه وهو الوجه الثاني، فرفضه منطلق من رفض العمل بالظن، لما دلّ على عدم حجيته.
الوجه الرابع: أنْ يراد بالرأي ما يهواه الإنسان ويميل إليه ويخدم أهواءه ومصالحه الخاصة، أكانت شخصيّة أم فئوية أم مذهبية، أو بما يدعم مسبقاته الفكرية التي يفرضها على النص، بما يجعله يعمد إلى ليّ عنق الآيات القرآنية بتأويلها وصرفها عن ظاهره، بما يلائم أهواءه، وهذا ما نبّه الإمام علي (ع) من خطورته في قوله من خطبة يومئ فيها إلى ذكر الملاحم والحديث عن صفة المهدي الموعود (ع) كما أشار شراح النهج[18]: "يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى، إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، ويَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ، إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ"[19].
وهذا الوجه قريب، وثمة احتمال غير بعيد في أنّ تكون الوجوه الثلاثة الأخيرة مشمولة للنهي عن التفسير بالرأي.
-
رفض ثنائية التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور
قد اتضح أنّ النهي في الأخبار ليس عن مبدأ التفسير، بل عن التفسير بالرأي، فكأنّها تقرّ مشروعيّة التفسير، ولكنّها ترفض صنفاً معيناً منه، وهو التفسير بالرأي، ونحن لا نعتقد بانحصار مشروعيّة التفسير بخصوص التفسير بالمأثور..
إنّ هذه الثنائية المدعاة بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور غير سديدة على إطلاقها، إذ نستطيع التأكيد أنّ التفسير بالرأي الصحيح لا يجوز أن يبتعد عن الأخذ بالأثر الصحيح، كما أن الأخذ بالأثر لا ينفك عن إعمال الاجتهاد الصحيح، لأنّ الأثر الذي يفسّر الآية هو نفسه يحتاج في كثير من الأحيان إلى التدبر فيه ومعرفة ما إذا كان يشكّل تفسيراً بالمصداق أو تفسيراً بيانياً، كما أنّ الآثار الواردة في تفسير الآية قد تتعارض فيما بينها ويحتاج الأمر إلى إعمال الرأي والاجتهاد في كيفية الجمع والمواءمة بينها إن أمكن ذلك.
باختصار: إنّ الرأي الاجتهادي ليس مرفوضاً على إطلاقه في التفسير، بل لا غنى عن التدبر وإعمال الفكر وإعطاء الرأي في التفسير، لأنّه حتى لو اقتصرنا في التفسير على تفسير القرآن بالقرآن، فإنّ الأمر يحتاج إلى نوع اجتهاد وإعمال التدبر في ربط آية بأخرى وتفسيرها بها، وكذلك تفسير القرآن بالمأثور يحتاج إلى اجتهاد كما قلنا.
يقول العلامة الطباطبائي: " لما ورد قوله: "برأيه" مع الإضافة إلى الضمير علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حتى يكون بالملازمة أمرا بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم على ما يراه أهل الحديث على أنه ينافي الآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربيا مبينا والآمرة بالتدبر فيه وكذا ينافي الروايات الكثيرة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الاخبار عليه"[20].
وقصارى القول:
قد اتضح أنّ التفسير بالرأي على نوعين:
الأول: التفسير الذي يعتمد الأهواء والاستحسانات الظنية وهو من التقوّل على الله بغير علم وهو مرفوض دون شك.
الثاني: الاجتهاد في تفسير الآية، اعتماداً على ما جاء في الكتاب نفسه، أو ما ورد في الأثر الصحيح، أو الأخذ بالظاهر العرفي الذي يفهمه الإنسان العارف باللسان.
-
فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ!
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأخبار المتقدمة قد تضمنت تخطئة من فسر القرآن برأيه حتى لو أصاب، ففي خبر جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"[21]. قال الترمذي: "هذا حديث غريب"[22].
وقد تسأل: كيف يُخَطّئ من أصاب؟!
ويمكن الجواب على ذلك بأن المقصود بالخطأ هنا هو الخطأ في المنهج الذي اعتمده المفسر وسار عليه، فهو حتى لو أصاب برأيه لكنه أخطأ عندما اعتمد منهجاً خاطئاً وهو التفسير بالرأي، وهذا نظير ما روي عن أمير المؤمنين (ع): "العجول مخطئ وإن ملك، المتأني مصيب وإن هلك"[23]. فإنّه يشير إلى خطأ العجلة كمنهج في العمل ولو أصاب العجول اتفاقاً. ونظيره أيضاً ما ورد في شأن القضاة، مما يتضمن تخطئة القاضي بغير علم ولو أصاب، ففي الخبر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ: "الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ، ووَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، ورَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، ورَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، ورَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ"[24]. ونظيره ما قيل: " كذبوا المنجمون ولو صدقوا"، فإنه كلام صحيح، فإن التنجيم منهج خاطئ ولو أصاب المنجم في بعض الحالات.
د- أجتهد رأيي!
وفي ضوء ذلك، فإننا نرسم علامة استفهام حول الحديث المروي عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، أنّه قال لِمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي.
قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ"[25].
فهذا الحديث لا يسعنا الأخذ به، وذلك:
أولاً: إنّ الرأي الذي يكون لا يكون في كتاب الله وسنة نبيّه (ص) - كما يقتضيه ظاهر التنزل في الحديث - هو عبارة أخرى عن القضاء بغير الكتاب والسنة، وكيف يقرّه النبي (ص) على ذلك وهو الذي حذّر من القول بغير علم؟! ثمّ إننا نتساءل: هل يوجد شيء لا تكون قواعده أو أصوله العامة موجودة في الكتاب والسنة ّ! إنّ هذا لا ينسجم مع المبنى المشهور والقائل بشمول الشريعة بنصوصها وقواعدها لكل وقائع الحياة. أجل، لو كان المراد بالرأي هو الحكم على ضوء الاجتهاد في تفسير الكتاب والسنة، أو الرجوع إلى الأصل الذي يكون هو المرجع عند فقد الدليل على الحكم، لكان للحديث وجه، بيد أنّ هذا خلاف الظاهر، فإن الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ليس واقعاً في طولهما، كما أنّ الأصل الذي يرجع إليه عند فقد الكتاب والسنة ليس رأياً في قبالهما، كيف ومعظم الأصول مستفادة منهما.
ثالثاً: إنّ هذا الحديث لا يصح سنداً بسبب الإرسال، فقد رواه أصحاب السنن بإسنادهم عن "الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة"، وهو بدوره رواه "عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل"[26]. والحارث بن عمرو مجهول، كما أنّه أغفل ذكر الذين روى عنهم من أهل حمص، ولذا قال العظيم آبادي: "وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقاً غير هذا. والحارث بن عمرو هذا مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة"[27].
رابعاً: إنّ الحديث المذكور معارض بما روي عن معاذ بن جبل نفسه في القضية عينها، أعني قضية إرساله قاضياً إلى اليمن، فقد روي عنه، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: "لا تقضيّن ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقفْ حتى تبيّنه أو تكتب إليّ فيه"[28]. فإنّه لو كان الأخذ بالرأي جائزاً فلا وجه لأمره بالتوقف حتى يتبيّن أو يكتب إلى النبي (ص).
الاتجاه الرابع: حاكميّة الكتاب على السنة
وثمّة اتجاه رابع في التفسير على صلة وثيقة ببحثنا، هو ما يسمى بحاكميّة القرآن، وقد أسلفنا أنّ رأي العلامة الطباطبائي هو أقرب إلى نظريّة حاكمية القرآن على السنة، وليس نظرية "حسبنا كتاب الله"، وقد وعدنا ببحث هذه النظريّة، وهذا ما نرومه حالياً، وذلك من خلال النقاط التالية:
-
مرجعيّة القرآن المعياريّة
إنّ حاكميّة القرآن الكريم على السنة وهيمنته عليها، يمكن أن تتبدى وتظهر في العديد من المجالات:
المجال الأوّل: ضرورة ردّ الأخبار المعارضة للكتاب وطرحها، وهذا أمر لا شك فيه عند غالبية الاتجاهات التفسيرية، وسيأتي بيانه وتوضيحه لاحقاً، في محور خاص من الباب الثالث.
المجال الثاني: ضرورة عرض كلّ التراث الخبري غير المقطوع بصدوره على الكتاب، حتى لو لم تكن الأخبار منافية للكتاب، ولا كانت متعارضة فيما بينها، وقد تبنى هذا الاتجاه بعضُ الفقهاء المعاصرين، حيث لم ير كفاية الاعتبار السندي في حجيّة الخبر، وشرط الحجيّة عنده ليس عدم منافاة الخبر للكتاب، بل لا بدّ من موافقته له، ما يفرض التحقق من انسجام المضمون مع الكتاب، فلا يمكن للفقيه أن يعتمد على الخبر قبل عرضه على القرآن الكريم والتثبت من توافقه معه، ولا يمكن حصول الوثوق بالخبر إلا بذلك. ويلتقي هذا المسلك مع الرأي القائل أنه لا دليل على حجية خبر الثقة، وإنما قام الدليل على حجية الخبر الموثوق، والوثوق إنما يمكن تحصيله من خلال عدة عناصر، وعلى رأسها موافقته مع الكتاب وثوابت السنة.
ومستند الرأي المذكور:
أولاً: هو مطلقات النصوص المتقدمة والتي أكدت على ضرورة عرض التراث الخبري برمته على القرآن الكريم، وليس خصوص الأخبار المتعارضة، فإنّ المستفاد من تلك الروايات أنّ الخبر ليس حجة ما لم يكن منسجماً ومتوافقاً مع الكتاب وثوابت السنة.
ثانياً: عقلائيّة هذا الأمر، فإن من دأب العقلاء أنّه إذا كانت لديهم مجموعتان من النصوص منسوبتان إلى مدرسة واحدة، وإحداهما ثابتة النسبة والأخرى مشكوكة، فإنّ العقلاء يتخذون من المجموعة الأولى مقياساً يتعرفون من خلالها على مزايا وخصائص شخصية صاحب النص، وعلى المبادئ العامة التي تحكم ذهنيته، ويتعرفون على بصمته البيانية وأسلوبه ولغته، الأمر الذي يشكل قاعدة معيارية يتم في ضوئها التثبت من المجموعة المشكوكة بإثبات انتسابها إليه أو نفي انتسابها عنه، وهذا المعنى يعتمده العقلاء في ميادين الشعر والأدب وفي السياسة أيضاً، يقول السيد السيستاني: "كلما كانت هناك مجموعتان منسوبتان إلى شخص أو جهة وكانت إحداهما مقطوعة الانتساب والأخرى مشكوكة، فإنه لا بد في الوثوق بالمجموعة الثانية من الرجوع إلى المجموعة الأولى باعتبارها السند الثابت في الموضوع. وملاحظة روحها وخصائصها العامة، ثم عرض تلك المجموعة على تلك المبادئ المستنبطة فما وافقها قبل وما خالفها رد"[29].
وعلى هذا المعيار اعتمد ابن ابن أبي الحديد لإثبات انتساب نهج البلاغة إلى الإمام علي (ع)، مؤكداً على عقلائية هذا المعيار وأنه مأخوذ به ومعمول عليه في المجال الأدبي[30].
وقد تحدثنا بشكل مفصل عن البصمة البيانية في كتاب، أصول الاجتهاد الكلامي، فليراجع.
المجال الثالث: ضرورة اتخاذ الكتاب مرجعاً معيارياً في بناء العقيدة وتأصيل المفاهيم والتشريعات. ومرجعيته المعيارية تعني - بالإضافة إلى ردّ ما عارض القرآن من الأخبار وبالإضافة إلى ضرورة اعتباره المصدر الأول الذي يرجع إليه الباحث والعالم في صوغ أفكاره ورؤاه - ضرورة إرجاع ما جاء في السنة إليه وتكييفها معه، ليكون المدار عليه دونها.
ولتوضيح الحال نقول: إنّه قد يرد في القرآن عنوان تشريعي مثلاً ويرد في السنة عنوان آخر، ولكنْ يتم الاستشهاد لإثبات العنوان الوارد في السنة بالعنوان القرآني، مع أنهما غير متساويين، بل قد يكون بين العنوانين عمومٌ من وجه، وهنا يرد السؤال: ما هو الأساس في الحكم الشرعي هل هو العنوان الوارد في الكتاب أو العنوان الوارد في السنة أو العنوانين معاً؟ إنّ هذا الاتجاه يقول بضرورة تحكيم العنوان القرآني وجعله الأساس الذي يدور الحكم الشرعي مداره سعة وضيقاً، وجوداً وعدماً، وسيأتي ذكر المثال لذلك.
باختصار: إنّ هذا الاتجاه يؤمن من حيث المبدأ بدور السنة في مجال التفسير وغيره ولا يتنكر لذلك، لكنّه يعتبر أنّ الأساس هو القرآن، فهو المرجع وهو الحاكم على مضمون السنة، كما أنه المقياس لمعرفة صحيحها من سقيمها، كما أنّ العناوين القرآنية هي التي عليها المدار.
-
الفرق بين هذه الاتجاه وسائر الاتجاهات
وهذا الاتجاه يختلف جوهرياً عن سائر الاتجاهات المتقدمة وغيرها:
-
فهو على الطرف المقابل للاتجاه الذي يعطي السنة دور الحاكمية في التفسير، بحيث تشكل الرواية المرجعية الأساس في فهم الكتاب، بذريعة أنه لا يمكن فهم القرآن دون الرجوع إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) بصفته المخاطب بالكتاب والذي يملك علمه وفهمه دون سواه، وإذا ثبت أنّ الخبر مخصص لعموم القرآن، أو مقيدٌ لإطلاقه، فهذا لا يعطي السنة دور الحاكمية على الكتاب وإنما دورها هو الشرح والبيان، لأن الخاص بيان للعام، وهذا ما سوف نعقد له محوراً خاصاً أيضاً، فيما يأتي.
-
وهو يختلف عن الاتجاه المكتفي في التفسير بالكتاب والرافض إعطاء السنة أي دور في التفسير، وهو اتجاه سلف وأوضحنا عدم موافقتنا عليه، وقلنا إنه لا يمكن إلغاء دور السنة في التفسير لكنّ دورها لا يمكن أن يجعلها حاكمة على الكتاب.
-
وهو يختلف عن الاتجاه المشهور بين المفسرين وهو الاتجاه الذي يرى مشروعية كلتا هاتين الطريقتين وهما: طريقة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة معاً، دون إعطاء أولوية لأحدهما أو مع إعطاء أولوية للتفسير الوارد في السنة بصفتها بياناً للقرآن.
إننا أمام اتجاه يجمع بين المرجعيتين، ولكنه يعتقد أن الحاكميّة هي لمرجعية الكتاب، وليس السنة.
-
مستند هذه الاتجاه؟
يمكن الاستشهاد لهذه الاتجاه ( حاكمية الكتاب على السنة ) ببعض الشواهد:
الأول: إنّ القرآن كما يرى السيد فضل الله رحمه الله ( وهو من أنصار هذا الاتجاه ) قد تكفل بتأصيل القواعد العامة على الصعيد التشريعي - كما العقدي - وأما السنة فدورها بيان التفاصيل والتطبيقات[31]. فدور القرآن إذن هو التأصيل ودور السنة هو البيان والشرح والتفصيل، { لتبيّن للناس ما نزل إليهم } []، والشارح لا يمكن أن يخالف المشروح أو يتقدّم عليه، ليتحول الشارح إلى أصل والمشروح إلى فرع، فضلاً عن أنّ دور الشارح ليس تفسير المشروح بما يخالف الظاهر، فضلاً عن أن يلغي المشروح أو ينسخه.
الثاني: إنّ النبي (ص) والأئمة من أهل بيته (ع) قد جعلوا أنفسهم تبعاً للكتاب ولم يجعلوا الكتاب تبعاً لهم ولا جعلوا لأنفسهم قيمومة على الكتاب أو سلطة على توسعة مفاهيمه أو تغييرها، كما يستفاد ذلك من الأخبار الواردة عنهم، والتي يؤكدون فيها على أنهم يستقون من الكتاب ويستهدونه، وكانوا يطلبون من الناس أن تسألهم عن المستند القرآني لما يفتون به أو يقولونه، ففي الحديث عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): "إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللَّه.."[32].
وتبعيتهم للكتاب قد صرّحوا بها على ما جاء في بعض رواياتهم[33]، وهي أيضاً ظاهر ما دلّت عليه الروايات الآمرة بعرض كل ما روي عنهم على الكتاب أيضاً، من قبيل ما رواه الكشي عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: "لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإنّ المغيرة بن سعيد (لعنه الله) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنّا إذا حدثنا، قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله"[34]. إنّ روايات العرض هذه هي خير دليل على هذه المرجعية المعيارية.
ويدل على ذلك أيضاً خبر أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام، قال وقد سئل عن الخبرين المتعارضين: "إنّ الله عز وجل حرم حراماً وأحل حلالاً وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بيّن قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرّم ما أحلّ الله ولا ليحلل ما حرّم الله ولا يغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله وذلك قول الله عز وجل: { إن أتبع إلا ما يوحى إلي} []، فكان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة"[35].
-
نموذج لحاكميّة القرآن على السنة
ومن أبرز الأمثلة على حاكمية القرآن على السنة، ما سيتم الحديث عنه في محور لاحق من وجود صنف من الأخبار يدرج عنواناً ن العناوين تحت عنوان قرآني معين، مع أن بين العنوانين عموماً من وجه، ومثاله ما دلّ من الأخبار على حرمة الغناء، مدرجاً له تحت بعض العناوين القرآنية، كعنوان الزور، كما في صحيحة أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : { والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قَالَ: الْغِنَاءُ"[36]. مع أن بين العنوانين عموماً من وجه، إذ ليس كل زور هو غناء، وليس كل غناء هو زور، وهنا قد يطرح السؤال: هل إنّ الإمام (ع) بصدد القول: إنّ الغناء - في الاعتبار الشرعي التعبدي - هو من الزو أو من "قول الزور"، كما يظهر من الفقهاء الذين رأوا أن هذه الأخبار بصدد إدخال فردٍ تعبدي في قول الزور، ولذا يحرم الغناء مطلقاً حتى لو كان في كلام حق؟ أم أنّ الإمام (ع) - كما يرى أصحاب الاتجاه الرابع - يريد ويهدف من إدراج الغناء تحت عنوان "قول الزور" أن يقول إنّ الغناء يحرم في حال كونه قول زورٍ دون ما إذا لم يكن كذلك؟ فالعنوان المحرم في شرع الله تعالى هو قول الزور دون الغناء.
إنّ الاتجاه الأول يمثّل إعطاء حاكميّة للرواية على الكتاب، بينما يمثّل الاتجاه الثاني إعطاء حاكمية للقرآن على الرواية، وسيأتي أنّ الاتجاه الثاني هو الأقرب.
-
مستند هذه الاتجاه؟
يمكن الاستشهاد لهذه الاتجاه ( حاكمية الكتاب على السنة ) ببعض الشواهد:
الأول: إنّ القرآن الكريم قد تكفل بتأصيل القواعد العامة على الصعيد التشريعي - كما العقدي - وأما السنة فدورها بيان التفاصيل والتطبيقات[37]. فدور القرآن إذن هو التأصيل ودور السنة هو البيان والشرح والتفصيل، { لتبيّن للناس ما نزل إليهم } [النحل: 44]، والشارح لا يمكن أن يخالف المشروح أو يتقدّم عليه، ليتحول الشارح إلى أصل والمشروح إلى فرع، فضلاً عن أنّ دور الشارح ليس تفسير المشروح بما يخالف الظاهر، فضلاً عن أن يلغي المشروح أو ينسخه.
الثاني: إنّ النبي (ص) والأئمة من أهل بيته (ع) قد جعلوا أنفسهم تبعاً للكتاب ولم يجعلوا الكتاب تبعاً لهم ولا جعلوا لأنفسهم قيمومة على الكتاب أو سلطة على توسعة مفاهيمه أو تغييرها، كما يستفاد ذلك من الأخبار الواردة عنهم، والتي يؤكدون فيها على أنهم يستقون من الكتاب ويستهدونه، وكانوا يطلبون من الناس أن تسألهم عن المستند القرآني لما يفتون به أو يقولونه، ففي الحديث عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): "إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ اللَّه.."[38].
وتبعيتهم للكتاب قد صرّحوا بها على ما جاء في بعض رواياتهم[39]، وهي أيضاً ظاهر ما دلّت عليه الروايات الآمرة بعرض كل ما روي عنهم على الكتاب أيضاً، من قبيل ما رواه الكشي عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: "لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإنّ المغيرة بن سعيد (لعنه الله) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنّا إذا حدثنا، قلنا: قال الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله"[40]. إنّ روايات العرض هذه هي خير دليل على هذه المرجعية المعيارية.
ويدل على ذلك أيضاً خبر أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام، قال وقد سئل عن الخبرين المتعارضين: "إنّ الله عز وجل حرم حراماً وأحل حلالاً وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بيّن قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليحرّم ما أحلّ الله ولا ليحلل ما حرّم الله ولا يغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله وذلك قول الله عز وجل: { إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [الأحقاف: 9]، فكان عليه السلام متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة"[41].
-
أبرز القائلين بحاكمية القرآن على السنة
من خلال تتبعنا لمناهج المفسرين نجد عدداً لا بأس منهم قائلين وآخذين بنظريّة حاكمية القرآن الكريم على الرواية، ويهمني في هذه الدراسة أن أشير إلى اسمين منهما:
-
العلامة الطباطبائي ورأيه في حاكمية القرآن على السنة
قد سبق وألمحنا إلى أن بعض العلماء المعاصرين عدّ السيد الطباطبائي من أصحاب نظرية "حسبنا كتاب الله"، إذ لوحظ أنّه يؤخر البحث الروائي في تفسيره مع أنّ حقه التقديم، فإنّ الرواية عن المعصوم هي الأساس في فهم الآيات القرآنية[42]. وربما ساعدت على هذا الفهم بعض كلمات العلامة في ثنايا تفسيره، فعلى سبيل المثال، نراه يقول: "فالحق أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود، وأنّ البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه، أي أنه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بأنه هدى وأنه نور وأنه تبيان لكل شيء مفتقراً إلى هاد غيره ومستنيراً بنور غيره ومبيناً بأمر غيره؟!"[43].
ويقول تعليقاً على الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي: "والمحصّل أنّ المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة إمّا هو الكتاب أو السنة، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن"[44].
وتوضيحاً لرأي الطباطبائي حول دور الرواية في التفسير نقول:
أولاً: لا ريب أنّ السيد الطباطبائي له موقف ملفت حول دور السنة في تفسير القرآن الكريم، فهو يصرّ على أنّ القرآن مستغنٍ بنفسه في بيان مقاصده ولا يحتاج إلى ضمائم أخرى كما لا يحتاج في إثبات حجيته إلى حجة أخرى تثبت حجيته، ولو كانت هي السنة، إلا أن رأيه - باعتقادنا - لا يصل إلى حدّ إسقاط وإلغاء أي دور للسنة في التفسير. إنّ التأمل في كافة كلمات السيد الطباطبائي تظهر تبنيه نظريّة محورية القرآن في التفسير وأنّه مستغن بنفسه في ذلك، لأنه يفسّر بعضه بعضاً، ما يعطيه حاكمية على السنة دون أن يسقط دور السنة بشكل كلي في تفسيره، (وسيأتي الحديث عن هذه النظرية في الاتجاه الرابع) فها نحن نراه يقول: " ليس فيه أي اختلاف، ولو وجد فيه اختلاف بالنظرة البدائية يرتفع بالتدبر في القرآن نفسه. ومثل هذا الكتاب لو احتاج في بيان مقاصده إلى شيء آخر لم تتم به الحجة، لأنه لو فرض أن أحد الكفار وجد اختلافاً في شيء من القرآن لا يرتفع من طريق الدلالة اللفظية للآيات لم يقنع برفعه من طرق أخرى، كأن يقول النبي مثلا يرتفع بكذا وكذا، ذلك لأن هذا الكافر لا يعتقد بصدق النبي ونبوته وعصمته، فلم يتنازل لقوله ودعاواه. وبعبارة أخرى: لا يكفي أن يكون النبي رافعاً للاختلافات القرآنية بدون شاهد لفظي من نفس القرآن لمن لا يعتقد بنبوته وعصمته، والآية الكريمة: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً} [النساء: 82] توجه الخطاب إلى الكفار الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنهم لم يسلموا لأقواله لو لم يكن هناك شاهد قرآني صريح". إلا أنه يعقب على هذا الكلام قائلاً: "ومن جهة أخرى نرى أنّ القرآن نفسه يثبت حجية أقوال النبي وتفسيره، كما أن النبي يثبت حجية أقوال أهل بيته وتفسيرهم. وهاتان المقدمتان توصلنا إلى أن في القرآن آيات تفسر الآيات الأخرى، ومكانة الرسول وأهل بيته من القرآن كمرشد معصوم لا يخطأ في تعاليمه وإرشاداته، فما يفسرونه يطابق التفسير الذي يستنتج من ضمّ الآيات بعضها إلى بعض ولا يخالفها في شيء"[45].
وفي مجال آخر ورداً على " ما ادعاه بعض من أننا في فهم مرادات القرآن يجب أن نرجع إلى ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ما أثر عنه وعن أهل بيته المعصومين عليهم السلام" يقول الطبطبائي: إنّ "هذا ادعاء لا يمكن قبوله، لأن حجية قول الرسول والأئمة عليهم السلام يجب أن تفهم من القرآن الكريم، فكيف يتصور توقف حجية ظواهره على أقوالهم عليهم السلام؟! بل نزيد على هذا ونقول: إن إثبات أصل النبوة يجب أن نتشبث فيه بذيل القرآن الذي هو سند النبوة كما ذكرنا سابقاً. وهذا الذي ذكرناه لا ينافي كون الرسول والأئمة عليهم السلام عليهم بيان جزئيات القوانين وتفاصيل أحكام الشريعة التي لم نجدها في ظواهر القرآن، وأن يكونوا مرشدين إلى معارف الكتاب الكريم كما يظهر من الآيات التالية: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [الحشر: 7]. [وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} [النساء: 64]. { هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة } [الجمعة: 2]. يفهم من هذه الآيات أنّ النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يبيّن جزئيات وتفاصيل الشريعة وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في حديث الثقلين الأئمة عليهم السلام هم خلفاء الرسول في ذلك. وهذا لا ينافي أن يدرك مراد القرآن من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين وكان له ذوق في فهمه"[46].
وأوضح من ذلك في الدلالة على عدم إلغائه للسنة في مجال التفسير ما يصرح به في تفسير قوله تعالى: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون}، يقول: "وفي الآية دلالة على حجيّة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الآيات القرآنية، وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير النص والظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فمما لا ينبغي أن يصغى إليه. هذا في نفس بيانه صلى الله عليه وآله وسلم ويلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر وغيره"[47]. على أنّ إسقاط حجية السنة عن التفسير لا يساعد عليه جريه العملي في تفسيره، فقد أكثر فيه من الاعتماد على الأخبار في توضيح بعض الآيات
ثانياً: وقد تسأل: ما هو الدور الذي تقوم به السنة في التفسير برأي الطبطبائي؟
والجواب: إنّ دور السنة في تفسير القرآن عنده يتلخص:
-
في الإرشاد إلى فهم مقاصد القرآن وأغراضه، يقول تعليقاً على حديث الثقلين: "والحديث غير مسوق لابطال حجية ظاهر القرآن وقصر الحجية على ظاهر بيان أهل البيت عليهم السلام كيف وهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لن يفترقا فيجعل الحجية لهما معا فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الإلهية ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده"[48]. والاستعانة الإرشادية بالقرآن هي ما يشير إليها السيد الخوئي أيضاً في البيان، فيقول: "وسيجد القارئ أيضا أني كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختها، وأسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن، ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة"[49].
-
بيان التفاصيل والمصاديق، قال أيضاً في ذيل كلامه المذكور قبل قليل: "... يفهم من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يبين جزئيات وتفاصيل الشريعة وهو المعلم الإلهي للقرآن المجيد وحسب ما جاء في حديث الثقلين الأئمة عليهم السلام هم خلفاء الرسول في ذلك . وهذا لا ينافي أن يدرك مراد القرآن من ظواهر آياته بعض من تتلمذ على المعلمين الحقيقيين وكان له ذوق في فهمه"[50]. وكثيراً ما يذكر السيد الطباطبائي أن هذه الرواية أو تلك واردة على سبيل الجري والتطبيق وبيان المصاديق.
-
تدريب المسلم على طريقة التفسير، يقول رحمه الله: "وقد تبين أن المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآية، وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود"[51].
-
نظرية السيد فضل الله في حاكمية الكتاب على السنة
وأما السيد فضل الله، فيعدّ - بحق - من أبرز القائلين بهذه النظرية، والآخذين بها، وهذا الأمر لا يكاد يخفى على المراجع لتراثه الفكري والفقهي والتفسيري. ونحن في ثنايا الكتاب أشرنا إلى بعض ملامح آرائه التفسيرية، وأفا فيما يتعلق برأيه في حاكمية القرآن[52] على السنة فيمكن الإشارة باختصار إلى أهم الأسس التي يرتكز عليها:
-
أنّ القرآن الكريم هو بيان في نفسه وليس مغلقاً ولا مجملاً ولا يعتمد لغة الطلاسم والأحاجي، و"الآيات القرآنية لا تنطلق في خط التعقيد اللفظي والمعنوي أو الإشارة الرمزية التي لا توحي للناس بالوضوح في الفهم"[53].
-
أن السنة مع كونها حجة في التفسير وغيره لكنّ العناوين القرآنية هي التي عليها المدار في بناء العقيدة والشريعة والمفاهيم، وذلك لأن القرآن الكريم انطلق ليؤصل القواعد في دائرتها الواسعة، أما السنة فهي في غالبها تطبيقات تحاكي مفاهيم الكتاب وتوضحها[54].
-
أنّ القرآن الكريم حاكم على مضمون السنة، وهو المقياس في معرفة صحيحها من سقيمها، ولا يؤخذ بالخبر ما لم يكن "موافقاً للمفهوم القرآني على مستوى القيمة أو الفكرة أو الخط"[55].
-
الرواية خاضعة للآيات، ولا تخضع الآية للرواية خارج نطاق الشرح والتفسير الذي يقوم به المعصوم في بيان القرآن، ومن هنا فهو لا يتوانى السيد فضل الله عن رفض كل تفسير يعمد فيه المفسر إلى ليّ عنق الآيات وتطويعها لتنسجم مع ما جاء في الخبر. فالحاكمية هي للكتاب على السنة، وتبرز الحاجة جلية إلى ضرورة تحكيم القرآن في هذا المجال أن القرآن مصون من العبث والتحريف بخلاف السنة فإنها " لم تدون في زمن النبي (ص) وعهد الصحابة" وهو الأمر الذي جعلها "عرضة للخطأ والنسيان، بالإضافة إلى التعقيدات الواقعية في المجتمع الإسلامي التي دفعت بالوضع والدس في الأحاديث إلى الواجهة"[56].
-
رفض ما جرى عليه بعض الفقهاء والمفسرين من حكومة الرواية على الآية وتصرفها في مدلولها تصرفاً تعبدياً، والمثال المتقدم في موضوع الغناء حيث أدرجته الرواية تحت مفهوم لهو الحديث أو قول الزور هو من الأمثلة التي كان يذكرها على الدوام في بيان منهجه الرافض لحكومة الرواية على الآية، ما دفعه للقول أنّه ليس ثمة حرمة للغناء خارج انطباق العنوان القرآني المذكور، كما سيأتي توضيح ذلك في فصل لاحق. وهناك نموذج آخر ذكره "وهو ما ورد في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90]، وقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]، إذ ورد الحديث عن الإمام الصادق (ع)، قال: "الشطرنج ميسر والنرد ميسر"[57]. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة النرد والشطرنج مطلقاً، حتى لو لم يكن اللعب مشتملاً على العوض الذي يوجب صدق القمار عليه، تمسكاً بالأحاديث الواردة في النهي عنهما مطلقاً[58]، وقد رأوا أن تطبيق الميسر عليهما يدل على توسعة مفهوم الميسر لما يشمل اللعب بهما من دون عوض، أو أن المراد به آلات الميسر حتى لو لم يلعب بها بالطريقة القمارية. ولكننا نرى أن للميسر ظهوراً في اللغة يتصل بلعب القمار الذي يختزن في مضمونه مفهوم العوض، وهذه هي القرينة التي يجب الاستناد إليها لإطلاق كلمة الميسر على الشطرنج والنرد، على أساس أن تطبيق العنوان على شيء يدل على أن المراد بالشيء ما يتناسب مع العنوان وليس العكس، ولذلك ذهب بعض الفقهاء، ومنهم الإمام الخميني، إلى حلية اللعب بالشطرنج والنرد إذا خرجا عن عنوان آلة القمار"[59].
من كتاب: حاكمبة القرآن (دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره)
[1] ويمكنك أن تضيف إليه ضرورة اعتماد تفسير القرآن بالقرآن.
[4] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 1، ص 55.
[5] سنن الترمذي، ج 4، ص 268، وجامع البيان، ج 1، ص 55،
[6] إكمال الدين وإتمام النعمة، 257.
[7] تفسير العياشي، ج 1، ص 17.
[8] البيان في تفسير القرآن، ص 269.
[9] قال السيوطي: " أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. الثاني: تفسير المتشابه لا يعلمه إلا الله. الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً، فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى"، الاتقان في علوم القرآن، ج 2، ص 482.
[10] الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 78.
[11] الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 77.
[13] رواه السنة والشيعة، أنظر: التوحيد للصدوق ص 91، وسنن الترمذي، ج 4، ص 268.
[14] دروس في علم الأصول للشهيد الصدر / الحلقة الثانية ص 271.
[15] وهذا الوجه قد يمكن إرجاعه إلى سابقه، وجمعهما في عنوان واحد.
[16] احتمله السيد الخوئي قال: " ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة عليهم السلام، مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك، ولزوم الانتهاء إليهم، فإذا عمل الانسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الكتاب، ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمة (ع) كان هذا من التفسير بالرأي"، انظر: البيان في تفسير القرآن، ص 269.
[17] وسائل الشيعة، ج 27، ص 201، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 62، وبحار الأنوار، ج 90، ص 12.
[18] شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 3، ص 168، وقال الشارح الخوئي: " واتّفق الشراح على أنّ هذا الفصل منها إشارة إلى ظهور القائم المنتظر عجّل اللَّه فرجه"، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج 8، ص 348.
[19] نهج البلاغة ، ج 2، ص 21
[20] الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 76.
[21] سنن الترمذي، ج 4، ص 269، ونحوه في سنن أبي داوود، ج 2، ص 177.
[22] سنن الترمذي، ج 4، ص 269.
[23] عيون الحكم والمواعظ ص 55.
[25] سنن الدارمي، ج 1 ، ص 60، وسنن أبي داوود، ج 2، ص 162، وسنن الترمذي ، ج 2، ص 394.
[26] أنظر: المصادر السابقة.
[27] عون المعبود، ج 9، ص 369.
[28] سنن ابن ماجة، ج 1، ص 21.
[29] قاعدة لا ضرر ولاضرار، ص 213.
[30] قال: "إنّ من قد أنس بالكلام والخطابة ، وشدا طرفا من علم البيان ، وصار له ذوق في هذا الباب ، لابد أن يفرق بين الكلام الركيك ، والفصيح ، وبين الفصيح والأفصح ، وبين الأصيل والمولد ، وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط ، فلا بد أن يفرق بين الكلامين ، ويميز بين الطريقين ، ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده ، لو تصفحنا ديوان أبى تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبى تمام نفسه وطريقته ومذهبه في القريض ، ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيره منحولة إليه لمباينتها لمذهبه في الشعر ! وكذلك حذفوا من شعر أبى نواس كثيرا لما ظهر أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره ، وكذلك غيرهما من الشعراء ، ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة. وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماءً واحداً، ونفساً واحداً، وأسلوباً واحداً، كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفا لباقي الألفاظ في الماهية ، وكالقرآن العزيز ، أوله كوسطه ، وأوسطه كآخره ، وكل سورة منه ، وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور . ولو كان بعض نهج البلاغة منحولاً، وبعضه صحيحا لم يكن ذلك كذلك ، فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السلام "، شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 8. وقال في مقام آخر: " حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة، قال : قرأت على الشيخ أبى محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة ، فلما انتهيت إلى هذا الموضع ، قال لي : لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له : وهل بقي في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين، ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول أنها منحولة ! فقال: لا والله، وإني لأعلم أنها كلامه، كما أعلم أنك مصدق. قال فقلت له : إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضى ، رحمه الله تعالى . فقال: أنّى للرضي ولغير الرضى هذا النفس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضى، وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر : ثم قال : والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضى بمائتي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى"، شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 205.
[31] راجع: الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل، ص 194، وقد كتب السيد جعفر فضل الله بحثاً حول رؤية السيد رحمه، تحت عنوان: نظرة في المنهج الاجتهادي للسيد فضل الله وأوضح فيه معالم منهج السيد في هذا المجال.
[33] في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (ع) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد فقال (ع): أنّ الله حرم حراماً، وأحل حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم الله، أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بيّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأنّ رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرّم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله، وذلك قول الله: {إن أتبع إلاّ ما يوحى إليّ} [الأحقاف: 9]، فكان (ع) متبعاً لله، مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب، وهو في السنة، ثم يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء، نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازما كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله (ص) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (ص) إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحل ما حرّم رسول الله (ص) أو نحرّم ما استحلّ رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبداً، لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له، كما كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ربه، مسلماً له، وقال الله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وإنّ الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعاقة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (ص) نهي إعاقة، أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم في خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص)، فما كان في السنة موجودا منهياً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (ص)، وما لم تجدوه في شيء من هذا الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا"، عيون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 24، وعنه وسائل الشيعة، ج 27، ص 115، الحديث 21، من الباب 9، من أبواب صفات القاضي، والخبر كما يصلح لإثبات تبعيتهم للكتاب والسنة فهو يصلح لإثبات أن المشرع هو الله دون رسوله، إلا في موارد أمضاها الله لنبيّه (ص).
[35] عيون أخبار الرضا (ع) ج 2، ص 23.
[36] الكافي، ج 6، ص 431.
[37] راجع: الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل، ص 194، وقد كتب السيد جعفر فضل الله بحثاً حول رؤية السيد رحمه، تحت عنوان: نظرة في المنهج الاجتهادي للسيد فضل الله وأوضح فيه معالم منهج السيد في هذا المجال.
[39] في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (ع) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد فقال (ع): أنّ الله حرم حراماً، وأحل حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم الله، أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بيّنٌ قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به، لأنّ رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرّم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله، وذلك قول الله: {إن أتبع إلاّ ما يوحى إليّ} [الأحقاف: 9]، فكان (ع) متبعاً لله، مؤدياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة، قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب، وهو في السنة، ثم يرد خلافه، فقال: كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء، نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازما كعدل فرائض الله، فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله (ص) نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله (ص) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله (ص) إلاّ لعلّة خوف ضرورة، فأمّا أن نستحل ما حرّم رسول الله (ص) أو نحرّم ما استحلّ رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبداً، لأنا تابعون لرسول الله (ص) مسلمون له، كما كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ربه، مسلماً له، وقال الله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وإنّ الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعاقة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله (ص) نهي إعاقة، أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنا الخبر فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص) والرد إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشركاً بالله العظيم، فما ورد عليكم في خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص)، فما كان في السنة موجودا منهياً عنه نهي حرام، ومأموراً به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله (ص)، وما لم تجدوه في شيء من هذا الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا"، عيون أخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 24، وعنه وسائل الشيعة، ج 27، ص 115، الحديث 21، من الباب 9، من أبواب صفات القاضي، والخبر كما يصلح لإثبات تبعيتهم للكتاب والسنة فهو يصلح لإثبات أن المشرع هو الله دون رسوله، إلا في موارد أمضاها الله لنبيّه (ص).
[41] عيون أخبار الرضا (ع) ج 2، ص 23.
[42] وقد علّق أحد أساتذتنا على هذا الكلام، بأنه يعبّر عن جهل قائله، لأنّ السيد الطباطبائي يؤخر الرواية إثباتاً ويقدمها ثبوتاً.
[43] الميزان في تفسير القرآن ج 3 ص 86.
[44] الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 77.
[45] القرآن في الإسلام ص 63 – 46.
[46] القرآن في الإسلام ص 25.
[50] القرآن في الإسلام ص 25.
[52] هذا الرأي يعد من أبرز معالم منهجه التفسيري، وقد نشرت أكثر من دراسة بهذا الخصوص منها: ما كتبه السيد محمد الحسيني في كتاب: مطارحات في قضايا قرآنية، والسيد جعفر فضل الله في كتاب: نظرة في المنهج الاجتهادي للسيد فضل الله، والشيخ علي غلوم في كتاب: إضاءات على فكر الفقيه المجدد.
[53] الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل، ص، 142..
[54] الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل، ص 194.
[55] الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل، ص 137.
[56] المصدر نفسه ، ص 132.
[58] راجع وسائل الشيعة، ج 17، ص 318، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به.
[59] الاجتهاد بين آسر الماضي وآفاق المستقبل، ص 136 - 137.