التأويل: منهجاً وضوابط
الشيخ حسين الخشن
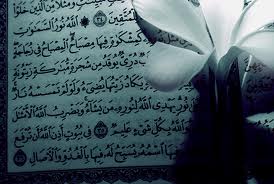
هل يمكن اعتماد منهج التأويل في تفسير النصوص الدينية أم لا بدّ من الجمود على الظاهر؟ وإذا كان التأويل مشروعاً فما هي ضوابطه وشروطه؟ وما هي مساحته وحدوده؟ هذه الأسئلة وسواها نحاول الإجابة عليها فيما يأتي.
المدلول اللغوي للتأويل:
التأويل لغة: هو التفسير بالمآل، وقد ورد في الكتاب والسنة بهذا المعنى، يقول الراغب الأصفهاني في المفردات: "التأويل من الأوْل: أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو ردّ الشيء إلى الغاية المرادة منه، علماً كان أو فعلاً، ففي العلم نحو {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} وفي الفعل.. {هل ينظرون إلاّ تأويله يوم يأتي تأويله..} أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه.." وثمة آيات أخرى استخدمت التأويل بمعناه اللغوي المشار إليه (راجع سورة يوسف، آية:100،36،6)، وبهذا المعنى ورد أيضاً في السنّة، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "إنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله" فتشوّف غير واحد من الصحابة ليكون هو المعني بذلك، لكنه(ص) أشار إلى علي(ع) (راجع مسند أحمد 3/33).
تطوير المعنى وتبدله:
والذي حصل مع لفظ التأويل أنه ـ كما هو الحال في كثير من الكلمات ـ لم يحافظ على معناه اللغوي، بل طرأ عليها التغيير والتبديل، ولعل أول تغيير جوهري عرض للكلمة هو استخدامها بما يرادف الاجتهاد، في محاولة لتبرير مخالفات بعض الصحابة أو غيرهم للكتاب والسنة، فقد كان العذر التخفيفي الذي يعطي لمن ارتكب مخالفةً ما لمنطوق القرآن أو فحواه":أنه تأوّل فأخطأ" وعلى سبيل المثال لمّا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وسبى زوجته جاء خالد إلى الخليفة أبي بكر معتذراً عن فعله هذا بالقول: إني تأوّلت، فاقتنع الخليفة بهذا العذر لكن عمر بن الخطاب لم يقنع وأصر على إقامة الحد على خالد، فدافع عنه أبا بكر قائلاً: "ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ"(راجع كنز العمال:5/619).
وفي تطور آخر لمعنى " التأويل" ـ وهو التطور الذي حوّل الكلمة إلى مصطلح معروف لدى علماء المسلمين ـ أصبحت تعني: "حمل اللفظ على خلاف ظاهره" وقد استقر هذا الاصطلاح في الأذهان، مع أنه ـ بالتأكيد ـ اصطلاح حادث (البيان للخوئي224 والميزان 1/7)، وقد نبهنا في حديث سابق إلى خطورة الاصطلاحات الموضوعة على خلاف المعنى العرفي واللغوي، لأنها قد تخلق تشويشاً وتتسبب في ضياع الحقيقة لدى الأشخاص الذين أنِسوا بالمصطلح الجديد، وأصبح هو المتبادر إلى أذهانهم ونسوا أو لم يتوجهوا إلى المعنى اللغوي.
وقد وقع علماء كبار ضحايا هذا الالتباس كما هو حال الجرجاني في كتابه "التعريفات" حيث قال: "التأويل في الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى.." فترى أنه أسبغ على التعريف المذكور لبوساً شرعياً، مع أن الشرع ليس لديه اصطلاح خاص بالنسبة للفظ التأويل، وإنما استخدمه بمعناه اللغوي كما ذكرنا. أجل، ما ذكره من التعريف هو اصطلاح علماء الشرع وليس الشرع نفسه.
الحاجة إلى التأويل:
باتضاح هذه المقدمة الضرورية نأتي إلى السؤال الملح في المقام وهو: ما وجه الحاجة إلى التأويل وصرف النص عن ظاهره؟ الحقيقة أن فكرة التأويل هذه ابتدعها العقل الإسلامي لحل مشكلة التنافي بين العقل والنقل، حيث يتم تأويل النص بما لا يتنافى ومعطيات العقل، وبذلك سجّل الاتجاه التأويلي الذي تبناه فرسان العقلانية في الإسلام ـ أعني الشيعة والمعتزلة ـ انتصاراً لمرجعية العقل في تفسير النص ومحاكمته، ومن المرجح أن يكون لحال الجمود والحرفية والشكلانية الذي تعاملت به بعض المدارس الإسلامية إزاء ظواهر النصوص أثر قوى في تعزيز الاتجاه العقلي التأويلي، والعكس قد يكون صحيحاً أيضاً، كما يرى الشهرستاني في تأكيده على أن توغل المعتزلة في علم الكلام وقولهم بالقدر ونفي الصفات وخلق القرآن أوجد ارتباكاً عند "السلف من أصحاب الحديث" فحاروا في "تقرير مذهب أهل السنة" إزاء متشابهات القرآن والحديث، فتوقف جماعة ـ منهم أحمد بن حنبل وداود بن علي الأصفهاني ـ عن الخوض في تفسير المتشابه وآمنوا به على ظاهره رافضين الدخول في تأويله (الملل والنحل 1/103-104).
الإفراط والتفريط:
إزاء الموقف السلبي الذي اتسمت به المدرسة الظاهرية في رفضها لكل أشكال التأويل وتخطي الظاهر، فإن ثمة مدرسة أخرى مقابلة فتحت باب التأويل على مصراعيه إلى حد الشطط كما هو الحال عند المتصوفة الذين اعتنوا ـ كما يقول الطبطبائي ـ بالآيات الأنفسية وأهملوا الظاهر وآياته الآفاقية، فاقتصروا على التأويل وأهملوا التنزيل، واستدلوا بكل شيء على كل شيء، مجرّئين ـ بذلك ـ الناس على التأويل حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمل وعلم الحروف (الميزان1/7).
ويمكن لنا تصنيف الموقفين المذكورين ضمن دائرتي الإفراط والتفريط ورفضهما معاً، أما الموقف السلبي الرافض لمبدأ التأويل فهو يفتقر إلى الدليل، لأن ما تمسكوا به لذلك هو مجرد شبهات (على حد تعبير السيوطي في الإتقان 2/36) لا تنهض لإثبات المُدَّعى، ولعل عمدة دليلهم على ذلك: قوله تعالى:{هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم أكتاب وأخر متشابهات ،فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب}(آل عمران:7).
بيد أن هذه الآية لا تمنع من تأويل المتشابه إلاّ لمن كان في قلبه زيغ ويقصد من تأويله إثارة الفتنة دون الرجوع في تأويله إلى المحكم الذي هو المرجع والأم للمتشابه كما نصت الآية. ونضيف إلى ما تقدم بأن رفض مبدأ التأويل ليس فقط يفتقر إلى الدليل، بل إن الدليل قائم على خلافه، أعني رفض الجمود على ظاهر الآيات المتشابهة. يقول الطبطبائي في ردّ هؤلاء: "والعقل يخطّئهم في ذلك والكتاب والسنة لا يصدقانهم، فآيات الكتاب تحرّض كل التحريض على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها، والاحتجاج بالحجج العقلية ومتفرقات السنة المتواترة معنى توافقها، ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة"(الميزان:8/153).
هذا الكلام لا يعني ـ بطبيعة الحال ـ تسويغ فكرة التأويل على إطلاقها واستباحة الخروج على الظاهر دون موازين أو ضوابط، لأن ذلك يساوق هدم الإسلام، ولطالما تسللت الباطنية إلى الإسلام تحت ستار التأويل الذي يقترب في بعض اتجاهاته من التحريف والتلاعب بآيات الله واتخاذها هزوا، ما شكّل غطاءً مخادعاً لكل محاولات التفلت من الشريعة وضوابطها، وقد واجه الأئمة من أهل البيت(ع) هذا الاتجاه وحاربوا رموزه دون هوادة، ففي الحديث عن الإمام الصادق(ع)، قيل له: روي عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون"(الوسائل 17/325).
ضوابط وموازين:
إن قوله (ع): " ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون"يؤشر إلى ضابط أساسي من ضوابط التأويل، وهو ضرورة انسجامه مع قواعد اللغة وضوابط قراءة النص، فكل تأويل لا تساعد عليه قواعد اللغة في الكتابة والمجاز والاستعارة ولا ينسجم مع بلاغة النص القرآني هو تأويل مرفوض، بل قد يعتبر طرحاً للقرآن ومصداقاً لهجرانه الذي شكى منه النبي(ص) فيما حكاه عنه القرآن الكريم {وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً}(الفرقان:30).
وثمة ضابط أو ميزان آخر يأتي ـ في الأهمية ـ بالدرجة الأولى، وهو أن لا يخرج التأويل عن حدود المنطق والعقل (على حد تعبير السيد هاشم معروف الحسني في كتابه دراسات في الحديث والمحدثين293). كما هو الحال في بعض تأويلات الباطنية وشطحاتهم التفسيرية. وخلاصة القول: إن التأويل خلاف القاعدة فلا يلجئ إليه اعتباطاً أو تعسفاً وإنما يصار إليه في حال الضرورة وهي عدم إمكان الالتزام بالظاهر لسبب من الأسباب، والضرورة وان حتّمت التأويل، لكنها لا تعني التفلّت من الضوابط وفتح المجال أمام المخيلة الخصبة لتسبح في متاهات التأويل وأغواره، بل لا بدّ أن يتحرك ـ أعني التأويل ـ وفق قواعد اللغة وضوابطها، وهذا ما لا نجد له مبرراً في الكثير من الموارد التي اعتمد فيها التأويل حيث نلاحظ أن بالإمكان التماس معانيها المعقولة ـ دون الجمود على حرفية النص ـ بالقراءة الواعية المتأنية التي لا تفصل الآيات لا عن سياقها الخاص وما يتضمنه من قرائن لفظية أو مقاميه، ولا عن سياقها القرآني العام على قاعدة أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً وأن المحكم هو المرجع للمتشابه والمبيّن هو المرجع للمجمل..
ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ للتأويل نطاقاً خاصاً لا يمتد بالتأكيد إلى المجال التشريعي أو ما يعرف بآيات الأحكام إلا نادراً ويبقى نطاقه ومجاله الرحب الآيات العقائدية ونظائرها.