الموقف الإسلامي من التشاؤم
الشيخ حسين الخشن
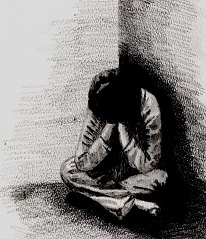
ومن المفاهيم المتشكلة خارج الفضاء الديني، والمعيقة لتطور الإنسان وتقدمه مفهوم التشاؤم أو ما يعرف بالطيرة، حيث لا يزال بعض الناس يتشاءمون من أماكن معيّنة أو أيام محدودة أو أشياء وكائنات مختلفة.:
والتشاؤم اعتقاد قديم، فقد كان عرب الجاهلية يتفاءلون بالحمام وبنباح الكلب على مجيء الضيوف، ويتشاءمون من الغراب عتى ضرب به المثل فقيل: "فلان أشأم من غراب البين". (أنظر: مجمع الأمثال، لأحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت- لبنان، ط2، 1987م ج2 ص194، وأفاد فيسبب إضافة البين إلى الغراب: "أن الغراب إذا بان أهل الدار للنُّجْعة – المكان الذي تقصده القبيلة طلباً للكلأ ومساقط الثمار- وقع في موضع بيوتهم يتلمَّس ويتقمّم فتشاءموا به، وتطيروا منه، إذ كان لا يعتري منازلهم إلاّ إذا بانوا فسموه غراب البين.."، وقد ذكر النيسابوري سبعة أمثال عربية تبدأ بكلمة "أشأم"، ممّا يدل على تجذر الاعتقاد بالطيرة عندهم)، ولا يزال التشاؤم بالغراب أو بغيره من الحيوانات أو غيرها شائعاً إلى أيامنا هذه، فالغراب أو صوت البوم أو غيرها هو نذير شؤم تدفع الكثيرين إلى التوقف عن بعض الأعمال والمهام ولا سيما السفر، وإذا ما أتم العمل فإنه يفعل ذلك على مضض أو حذر، وهاجس الشؤم يتملكه، وكأن الذي يختلج في نفوس الكثيرين أنّ النجاح في العمل مرتبط بهذه الأمور، بأن يكون السفر – مثلاً- في أزمنة محددة أو حالات خاصة، بحيث يكون صوت البوم نذير للشؤم ومؤشراً إلى الفشل في السفر في هذا اليوم أو الساعة.
الموقف الإسلامي من التشاؤم:
والإسلام في موقفه الصارم من الجهل وكل ما يعيق تقدم الإنسان ونموه وفي حرصه الشديد على أن تسير الحياة وفق منطق السنن والقوانين وقف موقف الرافض لهذا الاعتقاد، لأنّه اعتقاد غير مبني على علم ولا معتمد على حجة ودليل، بل إنّه اعتقاد معيق لتقدم الإنسانية لتجاوزه لقانون السنن التي ربط الله بها بين الأسباب والمسببات، ومن هنا أنكر القرآن الكريم فكرة التشاؤم في ردّه على تشاءم قوم موسى بموسى {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه}(الأعراف: 131)، وتشاؤم قوم صالح بصالح {قالوا اطيّرنا بك وبمن معك} (النمل: 47)، وتشاؤم أهل القرية برسلهم {قالوا إنا تطيّرنا بكم} (يس: 18)، حيث كان الجواب على كل هؤلاء بأن الشر لم يأتكم من قبل الرسل والأنبياء، وإنما جاء من قبل أنفسكم وما تحملونه من عناد وكفر وخبث، {قالوا طائركم معكم} (يس: 19)، {ألا إنما طائرهم عند الله} (الأعراف: 131)، إلى ذلك فإن التشاؤم ينافي مبدأ التوكل على الله سبحانه ومن هنا يتضح الوجه فيما يأتي من أن كفارة الطيرة التوكل، كما أنه ينافي الإيمان بأن الله هو الفاعل والمؤثر في هذا الكون، ونسبة التأثير إلى غيره مع عدم وجود ما يؤكد ذلك وفق قانون العلية لا يخلو من شرك خفي، وهذ ما أكدته بعض الأحاديث الواردة في هذا المجال، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "من ردّته الطيرة عن شيء فقد فارق الشرك" (مجمع الزوائد للهيثمي ج5 ص105)، وفي رواية أخرى: "من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك" (مسند أحمد ج2 ص220)، والوجه في نسبتهم إلى الشرك – كما أشرنا- أن هؤلاء يتخيلون أنهم إذا عملوا بما يقتضيه التشاؤم فإن ذلك يدفع عنهم الضر ويجلب لهم النفع، وهذا إن ترافق مع اعتقادهم بأنّ ذلك حاصل وواقع خارج إرادة الله وبصرف النظر عن تقديره فهو الشرك الجلي، وأمّا إذا كان اعتقادهم أنّ هذا إنما يحصل وفق تقدير الله سبحانه فهذا اعتقاد باطل ولا دليل عليه، وهذه الروايات التي تصف ذلك بالشرك إنما ترشد إلى بطلان هذا الاعتقاد ومنافاته لمبدأ خلوص التوحيد لله سبحانه.
وفي ضوء ذلك يتضح الحكم الشرعي للتطير والتشاؤم، فالتشاؤم إن كان ينطلق من اعتقادٍ بمؤثرية بعض الأشياء في الشر أو الخير بعيداً عن تقدير الله وتخطيطه لذلك فهذا ليس اعتقاداً مخرجاً عن الدين، ولكنه اعتقاد باطل ولا شاهد عليه لا من علم ولا من وحي، وسوف يُشكل الاصرار عليه عناداً وتمرداً على تعاليم الدين وذلك محرم بكل تأكيد، هذا ولكنّ الإسلام ورحمة منه بالعباد ولطفاً بهم فقد رفع المؤاخذة على الطيرة، ففي الحديث عن رسول الله(ص) المعروف بحديث الرفع: "وضع عن أمتي تسع خصال: الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق"، (الكافي ج2 ص462)، وربما كان سر عدم المؤاخذة على الطيرة أنها عندما من آمن بها تمثل حالة لا إرادية وينساق معها الإنسان بشكل لا شعوري.
ثم إنّه وفي الموقف الإسلامي المنشود من التشاؤم والتطير لا نجد مفراً من رفض بعض النصوص التي تنسب إلى الرسول(ص) والتي تؤكد على صحة التشاؤم في بعض الأشياء، من قبيل ما رواه البخاري عنه (ص): "إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار"، (صحيح البخاري ج3 ص217). وقد لاحظنا أنه وبسبب منافاة هذا الحديث لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبويّة، ومنها: قوله (ص): "لا طيرة"، مما رواه البخاري نفسه (صحيح البخاري ج7 ص31) فقد احتار العلماء في تفسيره، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأنّ الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم.. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلاّ أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، وقال آخرون: وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، وشءم الفرس أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوِّض إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة.." (شرح مسلم للنووي ج14 ص220- 222).
وهذه التوجيهات هي تأويلات لا يساعد عليها ظاهر الحديث، على أن بعضها مرفوض من قبيل ما وُجِّه به شؤم المرأة من عقمها وسلاطة لسانها، فإنّ هذا جارٍ في الرجل، فقد يكون عقيماً أو سليط اللسان، وهكذا ما ورد في تفسير وتوجيه شؤم الخادم أو الفرس أو الدار فإنها جارية في أشياء كثيرة فما الموجب لتخصيص هذه الثلاثة بالشؤم؟! ولذا فالأجدر رفض هذا الحديث وأمثاله تنزيهاً لساحة النبي(ص) عن مثل هذه الترهات.
لا واقعية للتشاؤم:
ثم إنه وبصرف النظر عن الموقف الإسلامي الرافض لفكرة التشاؤم، فلو أننا درسناها دراسة واقعية فلن نجد ما يؤكد صدقيتها وواقعيتها، فما أكثر ما يواجه الإنسان بعض الأشياء التي يتشاءم بها الناس ولا يبالي بذلك ويسير في عمله أو سفره ولا يصاب بمكروه، بل يوفق في عمله وسفره، ولا سيما إذا كان ممن لا يؤمن بالطيرة أو لا يلتفت إلى أن هذا الشيء هو من موجبات التطير والتشاؤم عند الناس، وهذا ما يؤشر إلى أنّ القضية لا تعدو أن تكون حالة نفسية بحتة يعيشها الشخص بحكم اعتقاده بوجود رابط بين ما يواجهه من أسباب التشاؤم وبين فشله في عمله وسفره، وهذا الاعتقاد المتجذر في النفس قد يؤثر على توازن الشخص ما قد يؤدي إلى فشله في عمله أو تجارته أو سفره، وهذا ما يوهم الكثيرين بواقعية التطير في غفلة عن أنه لا رابط بين الأمرين ولا وجود لأية علاقة سببية بينهما، وليس ثمة ما يؤكد صدقية هذا الربط أو واقعيته لا من العقل ولا من العلم ولا الواقع يؤكد ذلك كما قلنا، وإلاّ لو كان ثمة رابط بين الأمرين لعمّت القضية، مع أنّها لا تواجه إلاّ من يعتقد بها ويسيطر عليه هاجس الشؤم فيصاب بالتوتر والقلق ويفشل في نشاطه التجاري أو سفره أو زواجه.. وهذا ما يؤكده الحديث المروي عن الإمام الصادق(ع): "الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهونت، وإن شددتها شددت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً" (الكافي ج8 ص198)، وفي حديث أخر عنه(ع): ".. وكما لا تضرّ الطيرة من لا يتطير منها، كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيرون" (آمالي الشيخ الصدوق ص382).
وربما يتساءل البعض إذا كان التشاؤم فكرة موهومة ومتخيلة ولا واقعية لها، فكيف اعتقد بها الكثير من شعوب العالم، ولا يزال الاعتقاد بها إلى اليوم؟
والجواب: إنّه ربما يكون التشاؤم من بعض الأشياء قد انطلق في بداية الأمر من اقتران اتفاقي مؤثر ومتكرر لأكثر من مرة بين رؤية أحد الأشياء ووقوع حادث مؤلم فتخيل الناس من خلال الذهنية الساذجة غير المتبصرين بالأمور وجود علاقة سببية بين الأمرين.
علاج التشاؤم:
وحرصاً على التخلص من حالة التشاؤم يمكننا القول: إنّه لو كنا أمام اعتقاد يعبر عن حالة فكرية بحتة لأمكنت مواجهته بالموقف الفكري المضاد، وذلك من خلال التأكيد على رفض فكرة التشاؤم لعدم واقعيتها ومنافاتها لمبدأ التوكل على الله، إلاّ أننا في حقيقة الأمر أمام اعتقاد يعبر عن حالة فكرية ونفسيّة متجذرة في النفوس نتيجة التربية والعادة، ولذا كان الضروري لمواجهة هذه الحالة من اعتماد أسلوب تربوي يتخطى مجرد الموقف الفكري، وهذا ما نلحظه في الوصايا الواردة في الروايات فإنّها أكدت على اتباع جملة من الخطوات أهمها:
1- تأكيد مبدأ الارتباط بالله والتوكل عليه، باعتباره المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "كفارة الطيرة التوكل" (الكافي ج8 ص198).
2- مخالفة ما يقتضيه التشاءم وعدم الانسياق معه، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "إذا تطيرت فامض، وإذا ظننت فلا تقضِ وإذا حسدت فلا تبغِ" (بحار الأنوار ج14 ص153، تحف العقول ص50).
إنّ علينا كمؤمنين أن نعمل على رفض فكرة التشاؤم بالأزمنة أو الأمكنة أو الحيوانات، وأن نربي أمتنا على الاقلاع عن الانسياق مع هذه الفكرة بالتوكل على الله والاعتماد على تأييده وتسديده.