كيف نفهم نحوسة الأيام؟ (1/2)
الشيخ حسين الخشن
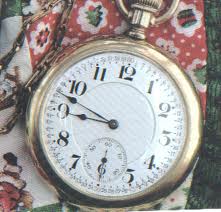
"قيمة الزمن في الإسلام"
في طقوس الشعوب وأدبياتها الشعائرية يلاحظ أن هناك ظواهر مشتركة يتلاقى عليها معظم الناس، من ذلك قضيتا النحوسة والسعادة، فتوصف بعض الأيام بأنها أيام نحس وهو ما يفرض تجاهها جملة من الطقوس الشعائرية ذات الطابع الوقائي الهادف إلى دفع غائلة النحوسة، وتوصف أيام أخرى بأنها أيام سعد، ويتم التعامل معها بطريقة احتفالية تحمل الكثير من مظاهر الفرح والمرح.
حقيقة النحوسة:
والنحوسة ـ كما السعادة ـ في العمق ليست منبعثة عن خصوصية في ذات الزمان تفرض هذا الصفة أو تلك، وإنما هي تعبير عن تفاعل بين عناصر ثلاثة، وهي: الإنسان، الزمان، الحدث، فإن كان التفاعل إيجابياً فاليوم يوم سعد، وإن كان سلبياً فاليوم يوم نحس، فعندما يضفي الناس على يوم ما صفة النحوسة مثلاً فبسبب كونه ظرفاً لوقوع حدث كارثي مأساوي، ومأساوية الحدث هذه تحفر في الذاكرة الجمعية جرحاً بليغاً وتخلق أو توجد اقتراناً أكيداً وارتباطاً عميقاً بين الحدث والزمن، بحيث يتداعى الحدث إلى الذهن فارضاً نفسه كلما دارت دورة الزمان وحلّ اليوم المعهود، وليس بالضرورة أن يحدّ مرور الزمان من التفاعل مع الحدث، بل ربما رسخه وأضفى عليه طابعاً أسطورياً لا سيما إذا كانت عناصر القضية المأساوية تمتلك قدسية لدى الرأي العام، وهكذا قد يبلغ التفاعل السلبي مع "الأيام المنحوسة" ذروته عندما تُنبذ هذه الأيام ويتم التعامل معها بطريقة تشاؤمية سوداوية، فيحاول الإنسان التهرب أو الاختباء منها، ويتحرز عن القيام فيها بأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو اجتماعي، فيتجنب ـ على سبيل المثال ـ الزواج والسفر والتجارة والسعي في حوائجه المختلفة ونحوه من الأنشطة، مخافة أن تصيبه لعنة تلك الأيام.
وفي تراثنا الديني ما يعزز فكرة النحوسة ويكرسها ويمنحها " الشرعية" فيكف نفهم ذلك؟ وهل يمكن القبول بالفكرة؟ هذا ما نحاول دراسته بطريقة نقدية تستهدي كتاب الله وسنة نبيه وتستلهم العقل الفطري الذي جعله الله دالاً عليه ومرجعاً في فهم نصوصه.
نعمة الزمن:
لكن في البدء لا بدّ أن نتعرف على نظرة الإسلام عن الزمن: ما هو مفهوم الزمن في الرؤية الإسلامية؟
والجواب: إن الزمن بكل فصوله ومقاطعه، سنينه وشهوره، لياليه وأيامه، دقائقه وثوانيه هو وعاء وظرف لحركة الإنسان وكل الكائنات، ومؤثر في نموها وتطورها، في حياتها وموتها، فالنهار ـ كمقطع من مقاطع الزمان ـ ميدان للنشاط والعمل، والليل موئل للراحة والاسترخاء {وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً}(الفرقان:47)، وهكذا فإن الزمن بكل مفاصله وفصوله وما يرافقها من تغيرات مناخية وبيئية هو من أهم العناصر المحركة للحياة، ولذا يعتبره القرآن آية من آيات الله عظيمة، وقد وقع مورداً للقسم الإلهي كما في قوله تعالى:{والعصر إن الإنسان لفي خسر}. والله تعالى عندما يقسم بشيء من مخلوقاته فلغرض التنبيه على عظيم فائدته، وهل أعظم من الزمان نعمة؟! ولكن السؤال كيف نشغل هذا الزمان وبِمَ نملأه؟ أبعمل الخير وطاعة الرحمن أم بالشر واللهو واتباع الشيطان؟
مسؤولية العمر:
وإذا كان الزمن مجرد وعاء وظرف يختزن كل ما يُلقى فيه من أعمال الخير أو الشر، وهو بطبية الحال ينقسم إلى آنات متشابهة ومتعاقبة، ولا فرق بين آنٍ وآن في طبيعته وماهيته سوى أن أحدها يسبق الآخر، عليه فلا تبقى ميزة لزمن على آخر ولا أفضلية لأحدها على الآخر، ولا معنى لزمن رديء وآخر هنيئ، بل الزمن كله خير ونعمة إذا أحسنا استغلاله والإفادة منه، ولذا سوف يُسأل الإنسان يوم القيامة عن الزمن وتحديداً عن عمره الممتد في عامود الزمن، فإنّ هذا العمر مسؤولية، كما أنه فرصة لا تعوّض، ففي الحديث عن رسول الله(ص): "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت"(الخصال للصدوق253)، وفي رواية أخرى أنه(ص) قال هذا الكلام تفسيراً وتعليقاً على قوله سبحانه وتعالى:{وقفوهم إنهم مسؤولون}(راجع علل الشرائع1/218).
لا يُعاب الزمان:
وفي ضوء ما تقدم من كلام عن حقيقة الزمان وطبيعته لا يغدو مفهوماً ولا مبرراً ما جرى عليه الإنسان من ذمّ الزمن ولعنه وسبّه، لأنه ان كان الزمن وعاءً أو لنقل لوحاً ينتقش فيه كل ما يكتبه أو يسجله الإنسان في صفحاته، فكيف يُعاب أو يلام؟ بل ولِمَ يُمدحُ؟! أو يعاب شيء على ما لا دور له في صنعه؟! إنّ الذي ينبغي أن يعاب ويلام هو الذي أساء الاستفادة من نعمة الزمن، والذي ينبغي أن يُمدح هو الذي أحسن الاستفادة منها، وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق(ع): "لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة، ولا تسبوا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليكم"(علل الشرائع2/577)، وعلى نفس المنوال وبنفس المعيار لا يبدو مبرراً ما شاع بين الناس من لعن الدنيا أو الحياة أو شتمهما، فالدنيا كما يصفها الحديث ليست سوى مطية للإنسان يصل بها إلى مبتغاه، ففي الخبر: "لا تسبوا الدنيا، فنعم المطية الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر، إنه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا، قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربه"(وسائل الشيعة7/509)، أجل ربما يكون التفسير الوحيد لما يفعله الإنسان من ذم الزمان والأيام والليالي هو محاولة التخفيف من مسؤوليته عما ارتكبه فيها من أخطاء وإلقاء اللوم على الغير، ما يشعره بشيء من الرضى الداخلي، مع أنه في الحقيقة شعور كاذب ومخادع.
باتضاح ما ذكرناه يكون طبيعياً وردد التساءل عن كيفية المواءمة بين المفهوم المشار إليه حول حقيقة الزمن ورؤية الإسلام بشأنه وبين ما ورد في النصوص من تأكيد على فكرة بركة الأيام أو نحوستها؟
بركة الأيام ومعناها:
وحاصل التساول: إن فكرة ظرفية الزمن وتساوي أجزاءه وأبعاضه، وعدم تفاضلها فيما بينها، لا تتلاءم وفكرة نحوسة الأيام، وكذلك لا تتلاءم وفكرة بركة الأيام أيضاً، مع أنّ كلتا الفكرتين ـ أعني النحوسة والبركة ـ وردتا في القرآن الكريم، أمّا البركة فقد وردت كوصفٍ لليلة القدر، قال تعالى:{إنا أنزلناه في ليلة مباركة}(الدخان:3)، وهي الليلة ذاتها التي وصفها تعالى في موضع آخر بأنها {خير من ألف شهر}(القدر:3) فكيف تكون هذه الليلة خيراً من ألف شهر وقد قلنا إنه لا تفاضل بين أجزاء الزمان؟!
والجواب: إن بركة هذه الليلة وسرّ تميزها ليس ناشئاً عن خصوصية في طبيعتها أو في آناتها، وإنما مردّه إلى اقترانها بنزول البركات الإلهية، واحتفافها بالألطاف الروحية، من نزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ما جعلها سلاماً حتى مطلع الفجر، ومآل ذلك كله إلى "فضل العبادة والنسك فيها وغزارة ثوابها وقرب العناية الإلهية فيها من المتوجهين إلى ساحة العزة والكبرياء"(الميزان19/72)، إن البركة في الحقيقة ليست مستمدة من الليلة، ولا هي بركة الزمن وإنما هي بركة الله التي أنزلها على عباده في هذه الليلة، فبركة الليلة أو شرافتها هي من بركة وشرافة ما حلّ فيها من ألطاف.
وفي المقال اللاحق نأتي إلى دراسة فكرة النحوسة من خلال المأثورات الدينية..