موقعية العقل في الميزان الإسلامي
الشيخ حسين الخشن
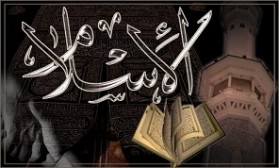
من المفترض أن تكون مرجعية العقل في مجال الاجتهاد الكلامي من المسلمات التي لا نقاش فيها حتى لدى أصحاب المنهج النصوصي، لأن النص لا يُثبت حجية نفسه إلاّ على نحو دوري كما هو واضح، وهذه النقطة تمثّل أحد وجوه الفرق بين علمي الفقه والكلام، ففي حين يُعتبر "الكلام" من العلوم البرهانية التي يُمثِّل العقل فيها مساحة كبيرة، فإن الفقه يعتمد على النص بشكل رئيسي، ويحتل العقل فيه دوراً هامشياً، لدرجة أنّ بعض الفقهاء لم ير في الأحكام الشرعية ما يتوقف على استدلال عقلي.(الفتاوى الواضحة للشهيد الصدر).
العقل بين النص الديني والتجربة الدينية:
لم يُعهد أن شريعة من الشرائع السماوية التي سبقت الإسلام اعتمدت العقل في إيمانها وتدينها وبنائها العقدي، كما هو الحال في الإسلام، ففي الوقت الذي شاع لدى علماء اللاهوت المسيحيين وضع الإيمان في خط مواز ومقابل للعقل، كما هو صريح كلام القديس Anselme(033 -1 -1109) رئيس أساقفة أنتربري "يجب أن تعتقد أولاً بما يعرض على قلبك بدون نظر، ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت، فليس الإيمان في حاجة إلى نظر عقل"(العرب والتحدي لمحمد عمارة 102)، نجد أن الإسلام قد انحاز للعقل وبنى منظومته الإيمانية والعقدية على أساس المنطق والبرهان ولسان حاله ومقاله دوماً {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فالعقل هو الحجة بين الله وعباده، وهو دليل معرفة الله ووحدانيته وعلمه وقدرته وحياته.. كما أنه دليل إثبات النبوة ويوم المعاد إلى غير ذلك من العقائد، ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليدرك انتصار القرآن للعقل والتعقل والعقلاء، فالآيات التي تمتدح عمل العقل كثيرة من قبيل قوله تعالى:{أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}(الحج:46) أو قوله حكايةً عن أهل النار {وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير}(الملك:67)... إلى مصطلح العقل ثمة مصطلحات أخرى مرادفة له كمصطلح "اللب" و"النهية" وردت في القرآن في سياق المدح، ونحو ذلك آيات التفكر والتأمل والتدبر والاعتبار... هذا في الكتاب، أمّا السنة فحديثها عن العقل وامتداحها له واعتباره الحجة بين الله وخلقه حديث مستفيض ومعروف..
أجل إن تجربة المسلمين مع العقل لم تكن ناصعة نصوع النصوص المذكورة، وإنما شهدت مداً وجزراً، فقد طلعت علينا بعض الفرق الإسلامية في خضم العراك الفكري الكلامي برفض مرجعية العقل ونفي قدرته على اكتشاف حسن الأشياء أو قبحها، وهذا في الحقيقة مثّل إحدى النكسات التي أصابت من العقل الإسلامي مقتلاً، لأن إنكار مرجعية العقل أو قدرته على اكتشاف حسن الأشياء أو قبحها أو إنكار حجيته على أقل تقدير أثّر سلباً على حيوية علم الكلام، وشُغل المسلمون في جدل لم تنتهِ فصوله إلى اليوم حول "شرعية أو عقلية الحسن والقبح" وهو جدل مستنزف للطاقات في بعض وجوهه، ومانع أو حائل ـ ولو جزئياً ـ دون البناء والتأسيس على مبدأ "الحسن والقبح العقليين" بغية الانطلاق إلى فضاءات جديدة تستهدي العقل وتسترشده.
وبالرغم من ذلك فإن هذا الموقف السلبي لم يعطل العقل الإسلامي تماماً، لأن هذا العقل عصي على التعطيل، ولذا ظل الفكر الإمامي والمعتزلي حارساً أميناً ومدافعاً مخلصاً عن مرجعية العقل، فضلاً عن قدرته على اكتشاف حسن الأشياء وقبحها، وكونه ميزاناً للتكليف، وللثواب والعقاب أيضاً.
مكبلات العقل:
ولعل أهم ما يمتدحه الإسلام في العقل هو فعل التأمل والتدبر المستمر والتفكير الحر والمجرد، إنه يقدس العقل النقدي الذي لا ينفك عن الحراك ولا يستسلم للأمر الواقع ولا يتهيب الإبداع والتجديد، ولا يتجمد في حدود ما "عقله" السلف أو استنبطوه، إن خاصية القلق المعرفي هي التي تمنح العقل فاعليته وحيويته وتجعل منه طاقة ابداع متدفقة لا ينضب معينها.
أمّا العقل المحاصر بالنزعة النصوصية والمثقل بسطوة آراء السلف والمسكون بهاجس الإجماع والشهرة، والمكبل بأصفاد التفكير الجمعي أو بأغلال المصالح والغرائز والهوى، والمثخن بسياط التفكير والتعنيف، أمّا هذا فهو عقل مسترخ مستقيل لا يتوقع منه إبداع ولا يرجى منه تغيير، فهو يعيش في سبات عميق وعلينا أن نستعيذ منه كما استعاذ علي(ع) في قوله:" نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل".
نعم لربما أخذ البعض على عقل المتكلم أنه عقل دفاعي تبريري يدافع عن العقيدة ويحرسها ولا يستطيع الخروج على مسلماتها، خلافاً لعقل الفيلسوف المتحرر من أية قيود. ولكن يمكن التعليق على ذلك بأن المتكلم إذا كان ينطلق في دفاعه عن العقيدة من موقع الإخلاص والإيمان الذي ساقه عقله إليه فهو ينسجم مع نفسه وقناعاته العقلية، ولا يضيره والحال هذه أن يوسم عقله بأنه تبريري أو دفاعي.
العقل الفطري والمكتسب:
الحديث عن عقل مكبل وآخر نقدي يقودنا إلى تقسيم آخر للعقل: وهو تقسيمه إلى:
1 ـ العقل الفطري: وهو الذي خلقه الله في الإنسان وميّزه به عن العجماوات، وهو عقل يتسم بالصفاء والنفاذ، ولديه قدرة عاليه على تمييز الحَسَن من القبيح سواءً في الأفكار أو المفاهيم أو الأفعال.
2 ـ العقل الثقافي وهو عقل يكتسبه صاحبه من تجاربه في الحياة، ويمكنه تنميته بالأنشطة الفكرية، ويتأثر هذا العقل ببيئة الإنسان وأفقه الذهني ومناخه الثقافي وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذا قد تتفاوت أحكامه من زمن لآخر أو من بيئة لأخرى، والعقل الفطري هو المرجع والأصل للعقل الثقافي المكتسب، فهو الذي يضبط إيقاعه و"يَعْقِلُه" عن الزيغ أو التمادي مع الهوى.
والتقسيم المذكور للعقل موروث عن الإمام أمير المؤمنين(ع) فقد روي عنه شعراً:
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع
(نهج السعادة 8/174).
ويجدر بنا التنبيه إلى أن مرجعية العقل الفطري أو المطبوع كما عبّر علي(ع) لا تمنح العقل عصمة عن الانحراف، فقد يعلوه الغبش وتلوثّه العادات السيئة، كما يلمح إلى ذلك الحديث النبوي "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه" لكن قدرته على التأمل والتدبر ـ إذا ما استثمرت ـ فإنها تمكنه من تصحيح المسار ونفض الغبار المتراكم بفعل المؤثرات الخارجية، قال تعالى:{ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِنَّة..} كما أن إحدى مهام الأنبياء هي المساعدة على استخراج كنوز العقول ومكنوناتها كما أشار إليه الإمام علي(ع) في أول خطبة من خطب النهج قال: "فبعث ـ أي الله ـ فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيّ نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول..".
وأمّا العقل الثقافي المكتسب أو المسموع فإن حجيته تبقى رهن أمرين: تحرره من المكبلات والمؤثرات المشار إليها. وأن تكون نتائجه يقينية.
وفي كل الأحوال: فالنشاط العقلي لا يتجمد في أطر محددة ولا تحكمه قوالب ثابتة في حدود ما اكتشفه الأقدمون وأنتجوه، بل هو قابل للتطوير والتعديل سواءً في آليات ومصادر إنتاجه، أو في وسائل استثماره وتفعيله، فالجمود على مصادر المعرفة وآليات التفكير الموروثة عن المنطق الأرسطي جمود غير مبرر، بل هو جمود معطّل ومكبِّل للعقل الإسلامي وقد كلّف الكثير من الخسائر الفادحة.
مجالات العقل:
بالرغم من أن مرجعية العقل في الأصول العقدية واضحة تمام الوضوح ولا شك فيها بيد أن لها استثناءً وحيداً لا بدّ من التنبيه عليه وهو ما يرتبط ببعض المغيبات من قبيل: حساب القبر وعقباته ومنازل الآخرة ومجرياتها، ومواصفات الجنة والنار، وما إلى ذلك من القضايا التي لا سبيل إلى معرفتها إلاّ من خلال الوحي وإن كان العقل لا ينفيها.
وفي هذا الصدد يمكن تقسيم القضايا العقدية باعتبار مصدر إثباتها إلى ثلاثة نطاقات:
1 ـ المختصات العقلية: وهي القضايا الثابتة بالبرهان العقلي ولا مجال لإثباتها بالنقل، كما هو الحال في مسألة وجود الله ووحدانيته وعدالته وسائر صفاته، أو مسألة النبوة العامة، أي ضرورة إرسال الرسل، ويذكر الإمام الخميني(رحمه الله) المعاد الجسماني في عداد القضايا العقلية الصرفة (أنوار الهداية 2/142). مع أن ثمة طريقاً آخر لإثبات المعاد غير البرهان العقلي وهو الوحي.
2 ـ المختصات الدينية: وهي القضايا التي لا مجال لإثباتها بالعقل من قبيل ما تقدم ذكره حول تفاصيل يوم القيامة.. ويذكر بعضهم الوحي والعلم اللّدني في عداد هذا القسم(أصول المعارف الإنسانية 138).
3 ـ المشتركات بين العقل والوحي: ويندرج في هذا القسم الكثير من القضايا العقدية، كما في قضية الإمامة أو المعاد أو العصمة أو ما إلى ذلك.
وهكذا يتضح أنّ النسبة بين ما يثبت بالعقل وما يثبت بالوحي هي نسبة العموم من وجه، أي أن لهما مادة اجتماع ومادتي افتراق(راجع أصول المعارف الإنسانية 135 وما بعدها).
"روحنة" العقل:
إننا على الرغم من تأكيدنا على مرجعية العقل في الاستدلال الكلامي، فإنّ لنا ملاحظة نسجلها في المقام وهي أنّ المنهج العقلي المذكور وعلى الرغم من مساهمته في بناء علم الكلام إذ بدونه ما اكتمل هذا العلم ولا استطاع النهوض بالأعباء الموكولة إليه، أعنى بذلك مهمة تأصيل العقائد الإسلامية وحراستها والدفاع عنها أمام موجات التحريف والتشويه الداخلي والخارجي، بيد أن إغراقه في الجهد الفلسفي البحت أفقده حيويته وتأثيره وأسس لنزعة تجريدية نأت بالعلم المذكور عن هموم الفرد المسلم وتطلعاته وابتعدت عن ملامسة مشاعره، فإن طموح كل فرد مسلم أن يشعر قلبه ببرد الإيمان كما أيقن عقله بساطع البرهان، وهذا الطموح لم يستطع علم الكلام التقليدي أن يقوم بتلبيته " إذ ما الذي يمكن أن يعنيه لدى هذا المسلم القول ـ مثلاً ـ إن الله وجود محض واجب الوجود وأنه عالم بعلم هو عين ذاته أو بعلمٍ ليس هو عين ذاته.."(أسس التقدم عند مفكري الإسلامي192).
المطلوب من علم الكلام أن يبنى لنا عقيدة حية، فاعلة ومؤثرة، لكنه مع الأسف تحوّل إلى فن الكلام أو "صنعة كلام" كما يحلو للغزالي تسميته في "المنقذ من الضلال" وإن نظرة سريعة على أهم المصادر الكلامية تشهد بهذا التحول المفجع لعلم الكلام من علم حي إلى مجرد "صنعة"، فلو نظرنا إلى شرح المقاصد للتفنازاني أو شرح المواقف للجرجاني أو شرح التجريد للعلامة الحلي لألفينا مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص ـ وهو المطلوب بالذات أو قل هو ذو المقدمة ـ لا يتجاوز ربع الكتاب قياساً على المباحث العقلية والفلسفية التي تضمنتها هذه الكتب كمباحث الوجود والماهية والجوهر والعرض وما إلى ذلك من المباحث التي قد يشكل بعضها مقدمات ضرورية لمبحث الإلهيات لكن الكثير منها لا تعدو أن تكون مجرد مشاغل ذهنية وهموم عقلية بحتة لا صلة لها بعقيدة المسلم وحياته فهي أشبه بميدان يتبارى فيه علماء الكلام لإبراز مواهبهم وقدراتهم العقلية.
نزعتان مضادتان:
إنّ المنحى الفلسفي المذكور والذي طغى على علم الكلام أسهم في إنتاج أو تعزيز نزعتين مضادتين له جاءتا كردة فعل على إيغال علم الكلام في النزوع نحو التجريد:
وأولى هاتين النزعتين هي النزعة الصوفية التي خاطبت في الإنسان المؤمن قلبه ومشاعره بعيداً عن أسر المصطلحات وثقلها.
النزعة الثانية: هي النزعة الإخبارية التي بالغت في الاعتماد على أخبار الآحاد وغالت في رفض المنهج العقلي وهجرت كل المصطلحات الفلسفية، وقد أمكن لهذه النزعة الإخبارية أن تتسلل لا شعورياً إلى عقول الكثير من العلماء بفعل الركود الكلامي وسيطرة الذهنية الفقهية، ولذا "أفتى" الكثير من الفقهاء في المفاهيم العقدية اعتماداً على أخبار لا تورث علماً ولا اطمئناناً.