وضع الاحايث-دوافع وغايات
الشيخ حسين الخشن
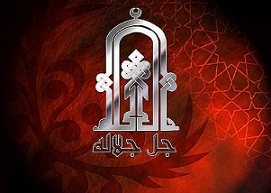
صحيح أن تراث المسلمين الديني هو الأنقى والأصفى قياساً على التراث الديني لسائر الأمم، بيد أن ذلك لا يعني خلوّه من الدس والتزوير وعبث العابثين، وهذا ما تنبه له علماء المسلمين منذ أمد بعيد، فعملوا على تنقية هذا التراث وابتكروا لهذه الغاية علمي الرجال والدراية اللذين تضمنا ضوابط وموازين دقيقة لتشخيص الخبر الموضوع عما عداه، وقد ألِّفت بعض الكتب بأسم"الموضوعات" رصد مؤلفوها المئات من الأحاديث الموضوعة.
الوضع في المجال العقدي:
ما أرغب في الحديث عنه في هذه المقالة هو وضع الأحاديث في الحقل الاعتقادي، لأنه لم يأخذ حقه من البحث النقدي، ولم يهتم به العلماء اهتمامهم بنقد الأحاديث الفقهية، لاعتبارات عديدة أهمها ما أشرنا إليه في مقالات سابقة، من انتشار النزعة التساهلية في التعامل مع الأحاديث العقدية، ويضاف إلى ذلك أن ابتناء علم الكلام بوضعيته التاريخية على منطق الفرقة الناجية وما استدعى ذلك من سجال مذهبي معقد لا تزال تداعياته مستمره إلى الآن، أفقد البحث العقدي الكثير من الموضوعية وحرّك الغرائز المذهبية التي عملت جاهدة على التمسك بالغث والسمين من الأحاديث في سبيل الإنتصار لأفكارها ومعتقداتها المسبقة.
بدايات الوضع:
تشير الشواهد التاريخية إلى أن بذور الوضع بدأت في عهد النبي(ص) حتى قام خطيباً مندداً بها ومحذراً منها قائلاً: "أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين(ع)(الكافي1/62)، لكن وتيرة الوضع والتزوير تسارعت بعد وفاته(ص) فشكلت ظاهرة خطيرة في عهد معاوية الذي أطلق العنان لبعض المرتزقة لوضع الأحاديث في ذم"الحزب العلوي" وكيل المديح "للحزب الأموي"، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في هذا الشأن أن معاوية كتب إلى عماله: " أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسم أبيه وعشيرته، ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه، لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا...".
وفي السياق نفسه، كتب معاوية إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاّ وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إليّ وأقرّ لعيني وأدحض لحجة أبي تراب(علي"ع") وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله، فقرأت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر وقال: "إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم"(شرح نهج البلاغة ج11/44).
دوافع وبواعث:
إن لوضع الأحاديث أغراضاً شتى وأهدافاً عدة، منها ما يتصل بالجانب العقدي، ومنها ما يتصل بجوانب أخرى سياسية وإجتماعية وشخصية ومادية، والوضع في المجال العقدي ـ وهو محور حديثنا ـ له عدة بواعث ودوافع إليك أهمها:
1 ـ الوضع حسبة:
أي قربه إلى الله! وهو من أخطر أنحاء الوضع، قام به بعض "الصالحين" بهدف ترغيب الناس في فعل الخيرات وترهيبهم وزجرهم عن فعل المنكرات، يقول يحيى بن سعيد القطان: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث"(صحيح مسلم1/13)، ومن أبرز مصاديق ذلك وضع الأحاديث في فضائل السور القرآنية، بحجة ترغيب الناس في قراءة القرآن، فقد قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن أبن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة"(مقدمة ابن الصلاح ص:81)، ولما عوتب بعضهم وذُكّر بقول رسول الله(ص):" من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" قال: إنما كذبت له لا عليه!
2 ـ الدافع المذهبي:
فإنّ العصبية المذهبية دفعت الكثيرين إلى وضع الأحاديث انتصاراً لمذهبهم ورموزه، أو انتقاصاً من المذهب الآخر ورموزه، ويندرج في هذا الإطار الكثير من روايات فضائل الصحابة ومثالبهم، يقول في "تذكرة الموضوعات": "ومنهم من يضع نصرة لمذهبه" ويضيف: أن رجلاً من الوضاعين لما رجع وتاب أخذ يقول: " أنظروا عمن تأخذون هذا الحديث، فإنا كنّا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً"(تذكرة الموضوعات؛ص:7).
3 ـ الوضع تخريباً للدين:
إن تشويه الدين في عقائده ومفاهيمه كان هدفاً لأكثر من جماعة، عملت على وضع الأحاديث ودسها في كتب المسلمين، ويمكن الاشارة إلى أربع فئات قامت بهذا العمل:
الفئة الأولى: الزنادقة أو ما يصطلح عليهم اليوم بالملاحدة، يقول في تذكرة الموضوعات: "ومنهم زنادقة، وضعوا قصداً إلى إفساد الشريعة وايقاع الشك والتلاعب بالدين، وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه"، ولما سيق عبد الكريم ابن أبي العوجاء إلى حبل المشنقة قال: " أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحل بها الحرام ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم"(بحار الأنوار 55/357، وراجع تذكرة الموضوعات؛ص:7).
الفئة الثانية: مسلمة اليهود وأهل الكتاب: أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وتميم الداري وغيرهم، وهؤلاء أسلموا بعد وفاة النبي(ص) وتقربوا إلى الخلفاء الذين فسحوا لهم في المجال ليحدثوا ويرووا من الترات غير الإسلامي، بحجة أن النبي(ص) قال:"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"(صحيح البخاري4/145)، وقد خُصِّص لكعب الأخبار ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل صلاة الجمعة في مسجد الرسول(ص) ثم أصبحت ساعتين في عهد عثمان، وهكذا امتلأت كتب المسلمين بما عرف بـ"الإسرائيليات" التي هي في معظمها أخبار مسيئة للأنبياء مشحونة بالخرافات التي لا يقبله البرهان ولا الوجدان ولا القرآن، وقد عرف عن تفسير الطبري اعتماده على الإسرائيليات بشكل كبير.
الفئة الثالثة: الغلاة، وقد أكثروا من وضع الأحاديث التي ترفع آل البيت عن منازلهم التي وضعهم الله فيها، ويأتي على رأس الغلاة المعروفين بالوضع: المغيرة بن سعيد، فإنه ـ وكما جاء في الرواية عن الإمام الصادق(ع) ـ كان يأمر أعوانه المتسترين بين أصحاب الإمام الباقر(ع) ليأخذوا كتبهم ويدفعوها إليه " فكان يدس فيها الكفر والزندقة" مسنداً ذلك إلى الإمام الباقر(ع)" ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة " ويضيف الإمام الصادق (ع) ـ على ما في الرواية ـ : "فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم"، ومنهم أيضاً محمد بن أبي زينب المعروف بأبي الخطاب فقد كان يؤول الآيات ويفسرها تفسيراً باطنياً ويزعم أن الزنا رجل والخمر رجل والصلاة رجل وكذلك الصيام، وقد لعنه الإمام الصادق وقال: "إنه خوفني قائماً وقاعداً وعلى فراشي، اللهم أذقه حر الحديد"(اختيار معرفة الرجال للطوسي2/576).
الفئة الرابعة: النواصب وهؤلاء وضعوا أحاديث تحط من مكانة أهل البيت(ع) وتشوّه صورتهم، وقد أشار الإمام الرضا(ع) إلى دورهم الخطير في وضع الأحاديث، فقد نقل الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله إنّ عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين(ع) وفضلكم أهل البيت(ع) وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود: إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا"(عيون أخبار الرضا(ع) ج2/727).
إن ما تقدم يلح علينا بضرورة نقد تراثنا الخبري ولا سيما في المجال العقدي، لأنه ومع الأسف لم يحظ بالجهد التحقيقي الكافي والدراسة الموضوعية اللازمة، باستثناء ما قام به العلامة السيد هاشم معروف الحسني في كتاب الموضوعات، وكذلك ما فعله الشيخ المحقق محمد تقي التستري في كتابه القيّم " الأخبار الدخلية" لكن جهود هذين العلميـن بحاجة إلى متابعة ومواكبة، ولنا عودة إلى الموضوع في مقال لاحق.